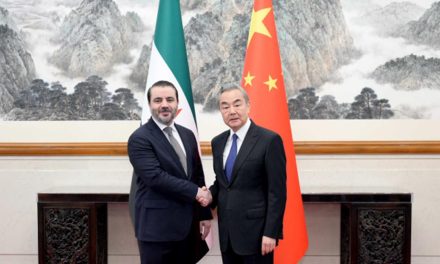لهذه الأسباب ترك جنبلاط وحيدا على حافة النهر…

يعود السياسيون إلى فطرتهم الأولى. صمتت بنادق المواجهات
السياسية، وانتهت معركة الخيارات الكبرى. فالمعركة القائمة اليوم، مجرد
مناوشات باهتة. إنها “الرقصة” التي اعتادها أركان السلطة في حقبة ما بعد
اتفاق الطائف، تحت رعاية الوصاية السورية. فأقصى المواجهات أصبحت على موظف
من هنا، وحاجب من هناك. وكأنهم يلوذون إلى “فينيقيتهم”، بنسخة معدلة من
هنيبعل. مقاتل مقدام شرس يجوب البحار، وينقلب تاجراً. تلك “ثقافة” مطبوعة
بأدوار “الترانزيت”، وبمعنى أوضح، شطارة الوساطة والسمسرة للبقاء هنا على
فالق جغرافي “استراتيجي”، كوصلة بين الشرق والغرب. فيستفيد من قوافل
التجارة العالمية ودروبها.
ضياع المعنى
تلك الذهنية أرست
هذا النوع من الثقافة في السياسة. فيجد الساسة أنفسهم يتلاطمون في لحظات
التحولات الكبرى بين خيارات متناقضة، ونشهد معهم حينها انقسامات سياسية
عمودية حادة، كما حدث بين العامين 2005 و2010، أو قد تتطور تلك الانقسامات
إلى حروب تنفجر بين فترة وأخرى، كما في أيار 2008، أو قبلها الحرب الأهلية،
أو أحداث 1958. هذا في حالات الصراعات الكبرى. أما في أزمان التسويات، حين
لا يكون لبنان “ساحة متفجرة”، كما هو حال اليوم، تتحول الصراعات إلى
السمسرة والمقايضة، كخلاف على التعيينات في مواقع الدولة وإداراتها، أو
تنافس اقتصادي في مشروعات صغيرة وكبيرة.
في حالات الانقسام السياسي حول مضامين كبرى ومصيرية، يكون
النزاع أوضح بكثير من حالات الصراع الشديد على المغانم، خصوصاً في دولة
“محاصصات” كما هو حال لبنان. ولذا، ليس غريباً اليوم أن يضيع “المعنى” عن
السياسة في هذه المرحلة التي تسود منذ العام 2016. وعلى الرغم من محاولات
كثيرة، حزبية ومدنية، لإيجاد عناوين كبرى أو لإحياء بعضها، رغبة بتأليف
معارضة فاعلة، إلا أن معظم من يسعى لذلك، أهدافه تكون في مكان آخر، ويستخدم
الشعارات الكبيرة لتحقيق مآرب صغيرة.
الأقوياء والضعفاء
في
هذه الحالة، يجد الكثيرون أنفسهم محاصرين أو مطوقين. طبعاً، باستثناء
الأطراف الثلاثة الأقوى في المعادلة، وهم حزب الله، التيار الوطني الحرّ،
وتيار المستقبل. إذ يبقى التنافس بينهم قائماً على من يعزز حصته ومكامن
سلطته. بينما الشعور بالمحاصرة يطغى على الأفرقاء الأقل تأثيراً، كالحزب
التقدمي الاشتراكي، القوات اللبنانية، تيار المردة. وفي هذا النوع من
الصراعات، تستحيل التحالفات السياسية إلى مجرد تحالفات متقطعة وآنية. فيسود
منطق التفرّق والإنفضاض، وفق ضرورات واحتياجات كل طرف. ويعمل الطرف الأقوى
على منطق فرّق تسد. إنه المنطق المتبع مع وليد جنبلاط مثلاً، بمحاولة
تعزيز موقع خصومه داخل بيئته. وهذه غاية تتقاطع فيها مصالح قوتين أساسيتين
من القوى الثلاث الآنفة الذكر، بينما القوة الثالثة أي تيار المستقبل، لا
تكون قادرة على فرض ما تريده لنصرة حليفه السابق. وكما يجد وليد جنبلاط
نفسه محاصراً ومطوقاً، كذلك تجد القوات اللبنانية نفسها في الخانة ذاتها.
هنا بالتحديد، يسود منطق فرّق تسد، من خلال محاولات لاستقطاب القوات اللبنانية إلى جانب هذا الثلاثي، بينما يترك وليد جنبلاط وحيداً. ففي غمرة الاشتباك بين الاشتراكي وتيار المستقبل، كان سمير جعجع يصرّح بأن علاقته ممتازة مع الحريري، والتنسيق دائم ومستمر، والتحالف قائم. بهذا المعنى، بقي جنبلاط وحيداً، خصوصاً في ظل المحاولات المستمرة، لاستقطاب القوات، ومنحها بعض ما تريده، مقابل عدم الذهاب إلى تشكيل قوة معارضة مع الاشتراكي. وربما تمرير أحد المحسوبين عليها في تعيينات المجلس الدستوري، سيكون لتلك الغاية.
إرساء هذا الوضع، يفرض على وليد جنبلاط أن يكون الطرف الأكثر
عرضة للتطويق أو الحصار، وسط إصرار من خصومه على نزع المزيد من أوراق القوة
التي يمتلكها. يعرف الرجل جيداً، ان أفق تغيير موازين القوى غير متاح
حالياً، ومحاولة نقل الخطاب السياسي من التنافس على مناصب ومكاسب، إلى
عناوين كبيرة، ليست في حسبان أي طرف من الأطراف. لكنه يحاول جاهداً تصويب
المسار عبر مواقفه التي يطلقها بأسلوبه المعتتاد. فالمعركة التي يفتحها
جنبلاط حالياً، “وجودية” بالنسبة له. هو أكثر من خبر لعبة تقاطع المصالح،
وذاق طعمها. لذلك يلجأ إلى الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع.
خيارات جنبلاط
صحيح
أن الرجل يلجأ حالياً إلى الإنحناء أمام الريح. وهذا ما يفسّر إعلان
الهجوم تارة، والالتزام بالتهدئة تارة أخرى. إنه يحاول تمرير المرحلة بأقل
خسائر ممكنة. لكن اشتداد الحملات عليه، لا بد أن يؤدي في النهاية إلى
إنفجار سياسي بشكل أو بآخر. ولحظة تفجّره قد تقع مع تغير إقليمي – محلي،
يؤدي إلى انقلاب المناخ السياسي في البلاد.
ليست المرّة الأولى التي يتعرّض لها وليد جنبلاط إلى ما يشبه الحصار. وتلك تجربة مرّ بها قبله كمال جنبلاط، على الرغم من أن الوضع حينها كان متفجراً وعلى وقع معارك عسكرية. وعندها، لم يكن الصراع في لبنان مماثلاً لما يحدث اليوم من تزاحم على المكاسب والمغانم. وجد كمال جنبلاط نفسه مطوق عربياً ودولياً. جولته الأخيرة في العام 1976 إلى الدول العربية كانت “فاشلة”، لما سمعه من نصائح إما لإثنائه عن العودة إلى لبنان، أو لوقف مشروعه وإعلان الاتفاق مع النظام السوري. وعندما رفض كان الاغتيال. اليوم ثمة تشابه ولو بعيد، بين هذه المرحلة وتلك المرحلة. فهناك من يقول لوليد جنبلاط إن خلاصك لن يكون إلاً في دمشق، أو أن الممر الإجباري والإنقاذي الوحيد لك هو سلوك طريق الشام، تماماً كما كان يفعل في كل مرحلة يجد نفسه مستهدفاً فيها، في حقبة الوصاية السورية.
لا يزال جنبلاط يقلّب خياراته بين يديه. يلجأ إلى الهجوم مستخدماً عناوين متعددة، تارة استراتيجية، وأطواراً تكتيكية، بانتظار شيء ما، ليس بالضرورة أن يقلب موازين القوى حالياً، في ظل التقاطعات الإقليمية والدولية التي تناقض رهاناته وأفكاره.. لكن على الأقل ما يعينه على نقل السياسة في لبنان من هذا السعار على “المغانم” إلى صراع سياسي مفعم بالمعنى. عندها سيستعيد دوره كالذي لعبه في العام 2005.
منير الربيع / المدن