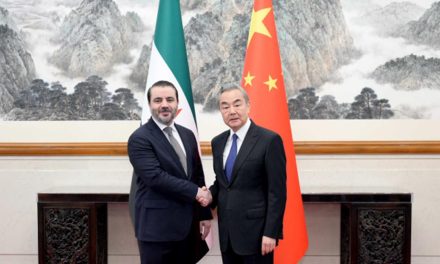محمد عبد الوهاب ظالماً ومظلوماً

ثمة ظلم لصوت محمد عبد الوهاب أكبر من تلك الاحتفاليات السنوية التي تقام كل ربيع في القاهرة بدعوى تكريمه واستعادة أغنياته بأصوات آخرين في ذكرى ميلاده ووفاته، هذا الظلم هو أن هذا الصوت الكبير الذي يستحيل تقليده لم يُغنّ في حياته إلا من ألحان محمد عبد الوهاب الموسيقار. هو ظلم أبديّ، لا يمكن رفعه، لأن الظالم والمظلوم كيان واحد لم يعد موجودًا، فما من إمكانية للمراجعة والتراجع عما فعله كل منهما بالآخر. هو “النهر الخالد” كما يُسمّى، لكن هذا الخلود مقترن بالاثنين معًا في حالة اتحادهما الشائكة، ولذلك لن يقدّم الخلود حلًّا، بل إنه يكرّس لهذا الظلم الاختياري، الذي ارتضاه صوت عبد الوهاب المطرب لنفسه، بانحصاره في موسيقى عبد الوهاب الملحّن.
مفهومٌ الأمر عند رؤيته بالمقلوب، فعبد الوهاب الموسيقار، اللاهث وراء النجاح وأيضًا الرواج والتكسّب بتمرير ألحانه من خلال أصوات موهوبة وقادرة ومدرّبة (ليلى مراد، أسمهان، نجاة، عبد الحليم، أم كلثوم، فيروز، فايزة أحمد، وردة، صباح، شادية، وديع الصافي، الخ)، كان من الصعب أن يُفلت صوتًا كصوت عبد الوهاب بدون الانتفاع به حدّ التملك والاحتكار، لكن خضوع هذا الصوت “المثقف الفاهم” بمحض إرادته لإغراءات الموسيقار وإغواءاته هو الفعل الظالم، وإن كان بلا إكراه بطبيعة الحال.
البرواز الفخم
في حديث تلفزيوني للمطربة نجاة أذيع مؤخرًا، حللتْ بشكل عفوي علاقة صوتها بالملحنين الذين تعاونت معهم على نحو موسّع في أوج توهجها، وخصّت بالذكر بليغ حمدي وعبد الوهاب، فوصفت ألحان الأول لها بأنها اقتنصت النبض الذائب في صوتها، في حين ذكرتْ أن موسيقى عبد الوهاب منحت صوتها الإطار الذهبي أو “البرواز الفخم” الذي يحميه من التشتت والتناثر، كما في “ارجعْ إليّ” مثلًا، من كلمات نزار قباني.
هل كان صوت عبد الوهاب الرائق (الأول مصريًّا وعربيًّا بامتياز من حيث الصفاء) بحاجة إلى التقيد في كل أعماله بمثل هذه القوالب المحكمة النفيسة التي يجيد صوغها عبد الوهاب الموسيقار؟ هل الدقة المتناهية في النحت الموسيقي والضبط والحذف والوزن بميزان الذهب أمور مفيدة ومثمرة دائمًا في الغناء التطريبي والتأثيري والتعبيري، حتى في حالات السيولة الصوتية وتفجرات الطاقة “الخام” والفيوضات الهادرة والتدفقات النادرة العميقة؟
إن جماليات الإناء الشفاف مهما تكن رائعة من حيث الاشتغال والصناعة الابتكارية الصعبة تبقى غير قادرة على إضافة شيء إلى مذاق السائل الكائن بالداخل، فللرهافة وامتلاك الحواس والعذوبة الفطرية الموجودة بذاتها قياسات أخرى. على أنه من البديهي أنْ لا يصير سائل في المتناول من غير إناء، لكنْ يكفي أن يكون وسيلة للحفظ السليم والتقديم السلس، فليست الزينة الشكلانية غاية في هذا الصدد، ولا التفاعل الكيميائي بين الإناء ومحتوياته بغية منشودة، وإن تمت المعادلة بمعرفة معمليّ قدير.
من المنطقي تقاطع طريق الأناقة والفخامة، وطريق النقاء والصفاء، في مواضع عدة ومساحات غير هيّنة، لكنهما ليسا طريقًا واحدًا أبدًا، كما أن كلًّا منهما يبدأ من نقطة مختلفة تمامًا. ببساطة، وقبل الاستغراق في بعض التفاصيل التخصصية، فإن ألحان عبد الوهاب (الموسيقى والإيقاعات المصاحبة للأغنيات) تتوخى في المقام الأول النموذجية والاكتمال بغض النظر عن قوة التأثير، فليس هناك مجال للخطأ أو السوء بالمعنى التقييمي المدرسي، وليس هناك مكان للأداء المجاني غير المتعوب فيه، الذي قد يعلو وقد يهبط، وبالتالي ليست هناك فرصة للانتقاد النظري، باستثناء تشابه بعض الأفكار والجُمل مع المؤلفين الغربيين، وهذا أمر وارد ومقبول في الإطار الطبيعي بدون تصيّد أو شطط.
هذه الآليات تعتمد بالضرورة على الثقافة المعرفية الواسعة والإبهار واستعراض العضلات والموسوعية الموسيقية التي تتجلى في القدرة على المزج بين الشرقي والغربي في النغمات والإيقاعات وتوزيع اللحن على الآلات وفق رؤية شاملة لحركة الموسيقى المصرية والعربية والعالمية.
هي منظومة نغمية أقرب إلى الأرستقراطية المحلية المدعومة بالوافد الغربي، خصوصًا ما هو سيمفوني وأوبرالي وأوركسترالي، الأمر الذي يضمن تحقيق الدهشة على المستوى الإجرائي والأدائي على الأقل، بما يمكن تشبيهه بسحر البيان في اللغة الرفيعة، وبلاغة الصورة والموسيقى الظاهرية في الشعر العربي الخليلي الموقّع، وهي وسائل تغطّي براءة الجُملة اللحنية، فترفعها إن كانت دون المستوى، وتظلمها بالترف والتكلف إن كانت جُملة استثنائية محلّقة، لا تحتاج إلى أجنحة إضافية ونكهات مكتسبة.
وفق هذه النظرية، ينجو اللحن الموسيقي بالضرورة من أن يكون في حالة ضعفه قرب سطح الأرض، لكن الأثقال المعلقة فيه تمنعه من التوغل في الاقتراب من السماء. هناك دائمًا احتياطات وعوامل أمان لا حد لها، تجعل الرحلة بدون مخاطرة، لكن رهان الجنون بما فيه من لحظات كشف استثنائية معطل من الحسبان، بما يجعل مساحة التأثير وخطف الأرواح والقلوب محكومة.
الفلاح
كان بإمكان صوت عبد الوهاب الصافي، الدافئ، الدافق، الشعبي، الناهل من قراءة القرآن وأذكار المتصوفة وأناشيد الموالد، أن يخلع “الروب دي شامبر” ويرتدي الجلباب، ليكون صديق الفلاح الحقيقي وهو يغني له “محلاها عيشة الفلاح”، من كلمات الشاعر بيرم التونسي، لو أن اللحن والتوزيع غير ما قدّمه عبد الوهاب الموسيقار المثقف، الراغب بذهنيته المتقدة في قيادة قاطرة التجديد الموسيقي الشرقي، وإحداث كذا وكذا في الحركة الموسيقية العربية إيمانًا بدوره الطليعي الريادي، فجاءت هندسة الأغنية المدنيّة فوق معطياتها الريفية بكثير.
إلى جانب صفائه العبقري، يتسم صوت عبد الوهاب برقة خاطفة وقدرة تعبيرية أخاذة ونبرات حنون شجية ذات طبيعة خاصة تملك النفاذ إلى القلوب من أقصر الطرق، ومثل هذه المواصفات تتطلب أن تكون الموسيقى المصاحبة خفيفة، في الخلفية، لا أن تُمنح دور البطولة بإيقاعاتها الطنانة وحليّها وبهرجتها.
من خصائص الصوت الوهابي كذلك، اتساع مداه على نحو مذهل، وتمتعه بالمرونة والتطويع والقدرة على التنقل والتحرك بين المقامات والنغمات، وثبات شدته مع اختلاف حدته ودرجاته، بالإضافة إلى الدقة والتحديد ووضوح مخارج الألفاظ والجماليات الفطرية من حيث الذبذبات السائغة المريحة والنقاء والرهافة والحس الدرامي التشخيصي.
هذه المنظومة الصوتية، على قوتها، أقرب في حقيقتها وجوهرها إلى طريق الأداء السهل، السلس، البسيط، النابع من التلقائية الموحية بالارتجال، بما يناسب أهم ميزات الصوت من حلاوة ونقاء وصفاء، ولو تخلت هذه المنظومة الصوتية (الخالية تقريبًا من الرواسب والشوائب) عن “الهيلمان” النغمي والإيقاعي، بضرورة ومن غير ضرورة، وتجردت من لوازم الثقافة والمعرفة، لتطل وحدها على الآذان عارية متجردة، لكان لها شأن أوسع نطاقًا من حيث القدرة على الاستلاب وسبي المشاعر واحتلال الضمائر، ولتماهت “حالة المتلقي” مع شجو الصوت وشجنه ومعاني الكلمات وماهيتها، بدلًا من هذا الطوفان الموسيقي الجارف الذي قد ينأى بالآذان بعيدًا، كما في “جفنه علّم الغزل” مثلًا للشاعر بشارة الخوري، و“عندما يأتي المساء” من كلمات محمود أبو الوفا.
إن ذروة عطاء عبد الوهاب الموسيقار يمكن ترصُّدها في ألحانه لأم كلثوم، فلقاءاتهما التي سُمّيتْ بلقاءات السحاب، تعكس مفاهيم مشتركة بينهما قائمة على الإمكانات الفيزيائية الخارقة وملء كل الفراغات المحتملة بأغنيات مُشبعة، بل دسمة “فوق الوصف”، فيها كل شيء مما تتطلبه المائدة من حساء ومقبّلات وأطعمة أساسية وحلوى، فضلًا عن قائمة المشروبات، البريئة والمُسكرة في آنٍ.
هنا، في هذه الأعمال، تجانس تام بين صوت أم كلثوم الضخم، وألحان عبد الوهاب الفخمة، وهكذا يمكن للأغنية أن ترتدي تاج التتويج فوق السجادة الحمراء، بمعيار “العَظَمَة” والقدرة على استدرار التصفيق الدائم والآهات، خصوصًا إذا زادتها العربية الفصحى وقارًا، كما في “أغدًا ألقاك” مثلًا، للشاعر الهادي آدم، و“هذه ليلتي” للشاعر جورج جرداق. لكن هل تقدر هذه الأغنيات “الممتعة” على تفجير الدموع أو الضحكات، وتغيير الحالة النفسية والطقسية للمستمع، ونقله من عالم إلى آخر؟ هذا أمر فيه قدر كبير من التشكك، لأنه ببساطة لم يكن يعني صُنّاع العمل أنفسهم.
هذه الألحان الوهابية “المكتملة الأركان”، التي تواءمت مع صوت أم كلثوم “الباذخ”، ربما لم تكن الاختيار الأنسب لصوت عبد الوهاب، المتوائم مع طمي النيل الخصب، وعذوبة مائه الصافي، وسريان “الجندول في عرض القنال”، بحد قصيدة الشاعر علي محمود طه، التي لحّنها وغنّاها عبد الوهاب.
في “الجندول”، وبعض هذه الأعمال الناجية من حسابات الاشتغال والاصطناع والفورة الموسيقية والإيقاعية، يكاد صوت عبد الوهاب الطموح الوثّاب يجد نفسه، بكل ما فيه من ثقة وهدوء وطمأنينة وصفاء وتصوّف ونشوة روحية، ولعل هذا هو سر تماهي المستمع مع الحالة، فهو يبحر إبحارًا في صوت عبد الوهاب، ليس فقط فوق سطح النيل، وإنما في تاريخ مصر الخالدة، وجغرافيتها المحفورة في خرائط القلوب.
محمد عبد الوهاب، صوت من كوكب آخر، لكنه لم تكتمل أسطورته سوى في القليل من أغنياته التي تحرر فيها هذا الصوت من زخارفه الكثيرة المحيطة.
شريف الشافعي / المدن