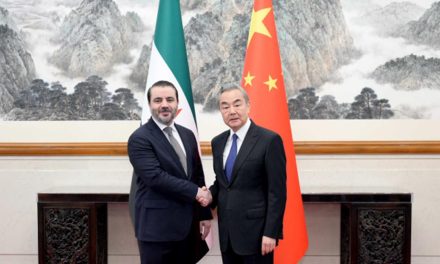قراءة النص الثاني في عمر شبلي من كتاب “الضوء الأسودُ يسرقني”

ينفتح حقلُ الانبثاق الرؤيوي في شعر عمر شبلي بوصفه فضاءً لاقتناصِ الكمون الذهني الأول في ذروةِ الاحتقانِ الوجودي، حيثُ يستحيلُ النداءُ الشعريُّ فيضًا أنطولوجيًا يرفضُ الامتثالَ لأسيجةِ المنطقِ وجدرانِ الدلالةِ الضيقة. إنَّ استدعاءَ “الخمرة” في النص لا يحيلُ إلى نشوةٍ عابرة، بل هو ارتدادٌ نحو “سديم المهد”، ذلك المرجِلِ البدئي الذي تنصهرُ فيه هويةُ الطينِ بوهجِ النار، لتنبثقَ الحقيقةُ كأثرٍ وهاجٍ يشفُّ عن “نواةِ الوعي” قبلَ أن يغتالَها سكونُ التعبير. إنها لحظةُ المكاشفةِ التي تتطلبُ الانعتاقَ نحو “معراجِ صمتٍ خلاق”، حيثُ يغدو الكأسُ سجنًا، وتصبحُ الكتابةُ احتراقًا كاملًا في أتونِ التخليقِ الأول، باحثةً عن “الوعدِ المنتظر” في تضادِ العناصرِ بينَ ماءِ حواء ونارِ الغواية. وفي هذا الفضاءِ السديمي، يتماهى الشاعرُ مع أساطيرِ التكوينِ ورموزِ الفناء، محولاً النصَّ إلى حالةٍ من الامتلاءِ الكوني الذي يرفضُ الغياب، ليقفَ القارئُ أمامَ تجربةٍ لا تؤسسُ لمعنىً جاهز، بل تُعيدُ صياغةَ الكينونةِ انطلاقًا من غليانِ الرؤيا في مكمنِها الغيبي، متجاوزةً حدودَ الزمنِ لتطرقَ أبوابَ الأزليةِ في كؤوسٍ من غيرِ جدران.
يا هذا القائمُ بين الكأسِ وبينَ الدّنِّ تعالَ
وناولْني خمراً لم يشربْها الصاحون.
ناوِلْني كأساً أعمقَ من حزني.
لكن من قالَ: لتلكَ الكأسِ قرارْ!
أسكبْها في كأسٍ من غير جدارْ.
فجدارُ الكأسْ
للخمرةِ سجنْ
حَرِّرْها، يا ساقي، في جوفي، واجعلْها
روحاً في شخصٍ مَيْتْ..
للخمرةِ سرٌّ يكشفُهُ من كان الحزْنُ يُعَرِّيهِ،
ويكشفُهُ من كانت خمرتُهُ
من نارْ.
ما تُجدي الخمرةُ حين يكونُ لها
ما بينَ السلوى والأحزانِ جدارْ.
أسكبْ ثانيةً من خمرةِ هذا الدَّنْ
ناوِلْني الكأسَ، وخذْ شفتي، فأنا
من طينٍ مفخورٍ بالنارْ،
إنسانٌ فاخرَهُ الشيطانُ، وقال لهُ:
من طينٍ أنتْ،
وأنا من نارْ.
دعني، فالماءُ من امرأةٍ تُدعى حوّاءَ،
ستنقذُني من ناركَ، إنّ بطينتِها
ما يجعلُ نارَكَ محضَ رمادٍ، كان له
يوماً في النفسِ شَرارْ.
فاسكبْ ما ظلَّ من الدنيا في كأسٍ
يا ساقي، فالعمرُ شراب
واحرصْ أنْ تعرفَ قدْرَ الخمر إذا حضرتْ
بحضور الخمرةِ ليس يجوزُ غياب
سأطيعُ أوامرَ “سيدوري”
وأسافرُ في جسدِ امرأةٍ، وعُقارُ
فيها ما يغري روحي بالإكثارْ
لم يخطئْ آدمُ حين غوى، ورأى
حوّاءَ تدلُّ الأفعى عند البئرِ،
وتدخلُ حانةَ “سيدوري”
نظرتْ للآتي في ماء الموتْ،
لتقولَ له:
لن يخلدَ فينا إلاّ الموتُ، فعاقرْني
حتى تنهار
يقتضي أفقُ الاستبصارِ في هذا المنظر الانعِتاقَ نحو “معراج الصمت الخلاق”، ذلك الفضاءِ السديميِّ الذي تتخلقُ فيه الصورةُ بوصفِها جوهرًا يشفُّ ولا يبين، حيث تتبدّى بداءةُ الفكرةِ في نداءِ الشاعرِ لخمرةٍ “لم يشربْها الصاحون”، وهي الرمزُ الأنطولوجي لتلك الطاقةِ المحضةِ التي ترفضُ التجسدَ اللسانيَّ وتحتمي بـ “براءتِها الغاشمة” في مكمنِ الروح. إنها اللحظةُ التي يتكثفُ فيها الوجودُ في ذروةِ احتقانِهِ، حيثُ تظهرُ الخمرةُ (الفكرةُ البكرُ) متأهبةً للانبثاقِ العسير، لكنَّها ترفضُ “جدارَ الكأسِ” بوصفِهِ سجنًا للدال، وتطلبُ الحلولَ في الجوفِ كروحٍ طليقةٍ تفيضُ بالمعاني قبل أن يُقيدَها مِدادُ البيان.
ويتجلى مهادُ سديمِ الرؤيا في هذا الامتلاءِ الذي يجمعُ بين طينةِ آدمَ ونارِ الشيطانِ وماءِ حواء، في وحدةٍ سديميةٍ تدركُ الحقيقةَ بكليتِها دون حاجةٍ لوساطةِ القوالبِ المنطقية، لتستكينَ الرؤيا في طوايا الكينونة كـ “ذخيرةٍ غيبية” كما في النص الأول “ترى ولا تُرى”. إنَّ ارتحالَ الشاعرِ إلى حانةِ “سيدوري” وغوصَهُ في “ماءِ الموتِ” يمثلانِ بلوغَ المادةِ الخامِ للوجودِ ذروةَ غليانِها وتوترِها في رحمِ الخيال، حيثُ لا تشيرُ هذه الحالةُ إلى صمتِ العدم، بل إلى “نورٍ باطن” يرفضُ التنازلَ عن بكارتِهِ لأسيجةِ النظم، مفضلًا البقاءَ في حالةِ “الامتلاءِ الكونيِّ” التي تسبقُ تشظيَ الذاتِ في الحرف، ليغدوَ النصُّ في “مهادِهِ” احتراقًا أنطولوجيًا وكينونةً واجفةً، محمَّلة بالقلق، يتماهى فيها الطينُ بالنارِ داخلَ مرجِلِ التخليقِ الأوّل، كدفقٍ إبداعيٍّ يرفضُ السكونَ في أطرِ المعاني الجاهزة.
ويؤدي هذا الاحتراق الوجودي في “مهاد الرؤيا” إلى ترحيل القصيدة من كَوْنها مَصنوعةً لغويةً إلى كَوْنها “كِيانًا قلقًا”، حيث ينعكسُ اضطرامُ الذات على بنية ” الكتاب، أمْسِ، المَكانُ، الآن”؛ لأدونيس، بوصفها بنيةً مفتوحةً على السديم، ترفضُ الاستقرار في شكلٍ نهائي. إنَّ قلق سؤال الذات عند أدونيس، كما هو عند عمر شبلي، ليس حيرةً فكريةً عابرة، بل هو “توتّرٌ أنطولوجي” ينبع من إدراك المبدع أنَّ كُلَّ تجسدٍ للحقيقة في الدال هو نوعٌ من “الموت” لتلك الحقيقة؛ لذا تأتي بنية نص أدونيس ونص عمر شبلي كبنيةٍ متأهبةٍ للانبثاق الدائم، لا تطمئنُّ إلى يقينٍ، بل تحرثُ في الذاكرة الجمعية والتاريخ لتصيدَ أثرَ الذات الهاربة من سجن “الجدران” اللسانية.
يُحول هذا الاحتراق الذات من مركزٍ ثابت إلى “ذاتٍ سديمية” تتشظى في أصوات التاريخ وقناعاته، باحثةً عن “بداءة فكرها” في مرايا الآخرين. وبذلك، لا يعود “النصان” تدوينًا للزمن، بل يصبحُ مسرحًا لـ “الامتلاء والاحتقان”، حيث تتصارعُ براءةُ الرؤيا الغاشمة مع ضرورة النظم الشعري، فينشأُ نصٌّ يشفُّ عن وجه المبدع المحترق بنور بصيرته. إنَّ انعكاس هذا الاحتراق على البنية يتجلى في التحرر من “أسيجة النظم” التقليدية لصالح إيقاعٍ سديميٍّ يُحاكي غليان المادة الخام في رحم الخيال، مُرسخًا حقيقة أنَّ الذات الأدونيسية لا تجدُ قرارًا لها إلا في مراقي التجلي المستمر، حيث تظل الكتابةُ مغامرةً لاقتناص “الشرار” قبل أن يستحيل رمادًا في قوالب المعاني الجاهزة.
يستحيل “القلق” في ممارسة عمر شبلي من مجرد اضطراب نفسي إلى “دينامية لغوية” تتسلل من مناطق اللاوعي لتصيد أثرًا هوويًا في نص ” ناوِلْني كأسًا أعمقَ من حزني”، حيث تتماهى تجربة الـ”خمرة ” و”كأس سيدوري” لتشكل في مجملها “سديمًا زمنيًا” واحداً. إنَّ هذا الاستجلاء يكشف أن عمر شبلي لا يكتب تاريخًا، بل يستنطق “اللاوعي التاريخي” عبر لغةٍ ترفض الخمرة سجنَ الكأس؛ فالهوية في نص عمر شبلي ليست معطىً جاهزًا، بل هي حالة من “التخلق السديمي” المستمر بين الذات المبدعة ورموز الماضي.
ينعكس هذا القلق على هوية النص من خلال تحويل اللغة إلى “معراجٍ من الصور المتلاحقة” التي لا تستقر في دلالة واحدة، بل تظل في حالة احتقان وغليان تحاكي “بداءة الفكر” قبل تشكله اللساني. في صورة: القائمُ بين الكأسِ عند عمر شبلي كما هو الحال في “الكتاب”، عند أدونيس عندما تنصهر هوية الذات بهوية الآخر التاريخي (المتنبي أو غيره) في رحم “سديم المهد”، لتصبح لغة اللاوعي هي الوسيط الذي يحرر المكبوتات الحضارية من “أسيجة النظم” والرقابة العقلية. هذا الاحتراق الذي يطالب به الشاعر في نصه (“أكتبُ – يأخُذُني رُعْبٌ”) هو نفسه المحرك الذي صاغ أجزاء “الخمرة” عند عمر شبلي؛ حيث تتشظى الذات في “المكان” وتغترب في “الأمس” لتنبعث في “الآن” ككائن سديمي يرفض النهائي والمحدود. إلا بالتشفي في صورة الخمرة، الاحتماء بلذّةٍ موهومة أو بنشوةٍ عابرة لتسكين وجعٍ داخلي، أو محاولة مداواة جرحٍ نفسي عبر الانغماس فيما يُنسي، لا فيما يُنقذ، كما عند عمر شبلي.
إنَّ هوية “النصين” في جوهرهما هي “هوية الانبثاق العسير”، حيث تغدو انكسارات الذات، قلق الوجود “صيدًا للأثر” الوهاج الذي يتركه قلق السؤال في جسد اللغة. وبذلك، فإن “خمرة هذا الدن” التي يطلبها الشاعر هي الاستعارة الكبرى لهذا المنجز الشعري؛ فهي تفيض بالمعاني البكر وتنسكب في “كأس من غير جدار”، لتشكل بنية نصية ترفض الانحباس في الزمن الخطي، وتؤسس لـ “امتلاء أنطولوجي” يربط بين طين التجربة الإنسانية ونار الرؤية الكاشفة، ما يجعل من “الكتاب” أثراً وهاجاً لا يكف عن التجلي في خاطر المبدع والقارئ على حد سواء.
وانطلاقًا من هذا المنظر، يتقاطعُ أدونيس مع عمر شبلي في منطقة “مهاد الرؤيا” بوصفها فضاءً للاحتراقِ لا للاستلاب؛ فصورةُ “القائمِ بين الكأسِ والدنِّ” عند شبلي ليست هروبًا نحو “لذةٍ موهومة” لتسكينِ وجعٍ عابر، بل هي اتخاذُ “الخمرةِ” كقناعٍ سديميٍّ لعمليةِ تطهيرٍ أنطولوجي تتماهى مع القلقِ الذي صاغ أجزاء “الكتاب” الثلاثة – الكتاب، أمس، المكان، الآن – إنَّ “الخمرة” هنا هي المادةُ الخامُ التي تحررُ الذاتَ من “أسيجةِ النظمِ” والرقابةِ العقلية، محولةً اللغةَ إلى “معراجٍ من الصورِ المتلاحقةِ” التي لا تستقرُّ على حال، بل تظلّ في مخاضٍ دلاليّ، تسبح في سديم الرؤيا، قبل أن تستقرّ في هيئة معنى متعيّن.
في هذا الاندماجِ الفلسفي، تبرزُ هوية الرؤيا ككائنٍ سديميٍّ يرفضُ النهائي؛ فبينما يصهَرُ أدونيس ذاتَهُ بهويةِ “الآخر التاريخي” (كالمتنبي) في رحم “سديم المهد”، يغوصُ عمر شبلي في “نشوةِ الخمرةِ؛ ليعيدَ تشكيلَ “خمرة الأحزان” عبرَ لغةِ اللاوعي التي لا تداوي الجرحَ بالنسيان، بل تُعرّيهِ بالاحتراق. فـ”الرعبُ” الذي يسكنُ أدونيس لحظةَ الكتابة هو ذاتُهُ المحركُ الذي يجعلُ خمرةَ شبلي “نارًا” لا “سلوى”؛ إذ لا جدوى من خمرةٍ يفصلُها عن الحزنِ “جدار”، لأنَّ المطلوبَ هو “الامتلاءُ الأنطولوجي” الذي يمحو الحدودَ بين الذاتِ والكون.
إنَّ الاحتماءَ بالخمرةِ عند شبلي، كالانغماسِ في بياضِ الورقِ عند أدونيس، هو محاولةٌ لاقتناصِ “الأثرِ الوهاجِ” للروح في لحظةِ تشظّيها؛ فالذاتُ لا تنبعثُ في “الآن” إلا بعدَ أن تغتربَ في أتونِ “سديمها” الخاص
وبذلك، يتسامى النصُّ عن كونهِ ترياقًا لترميمِ الانكسار، ليستحيلَ انبجاسًا لـ “نواةِ الوعي” و”بداءةِ التشكّلِ الذهني”؛ وهي تقتنصُ الجوهرَ الوجوديَّ من صلبِ الفناء (ماءِ الموت) واشتعالِ الروح (خمرةِ النار)، مُحيلةً الاحتقانَ الحضاريَّ والنفسيَّ إلى طفرةٍ إبداعيةٍ تخرقُ التخومَ الفيزيائية، لتبقى الرؤيا في مَهدِها السديمي إشراقًا يشفُّ عن وجهِ المبدعِ وهو يلاحقُ أزليتَهُ في أُفقٍ لا تحدُّه الجدران
الدكتور عبد القادر فيدوح الجزائر/18/1/2026/