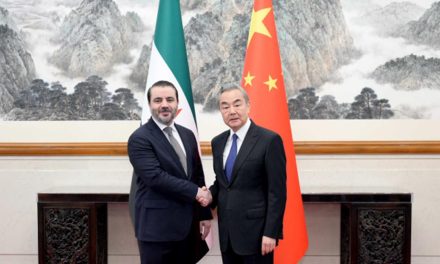أسئلة سياسية مطروحة على الحراك اللبناني

يكاد ينعقد إجماع، إن لم ينعقد الإجماع كله، على أن المخرج الآمن والممكن والصحيح من “أزمة” خروج شطر راجح من المواطنين اللبنانيين، بصفتهم المفاجئة هذه، إلى ساحات الاحتجاج والمحاسبة، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، هو تأليف حكومة خبراء ومختصين وتقنيين. وتقوم حكومة هذا صنفها، مقام الجواب الشافي عن عموم الفساد (العمولات الضخمة، والتلزيمات الاعتباطية، والوكالات الاستنسابية، والاحتكار، والاقتطاع من المخصصات والمناقصات، وفتح التوظيف وتوزيعه، والسكوت عن صفقات الظل، وبيع الوساطة والإعفاءات، والإبقاء على “جرايات” من غير نفع…) طبقة سياسية مركّبة يتناسل بعضها من بعض، إن لم يكن من طريق النسب فمن طريق الولاء المكين والموثوق. ودام السكوت “الشعبي” عن الفساد ما بقي في جعب الدهاقنة ورؤساء العشائر فتات يوزّع على أهل الولاء والوفاء، وعلى فروعهم الكثيرة في القطاع الخاص والقطاع العام.
وبقي ما يوزّع على الزبائن والموالي، وما يخلي بين المقتدرين وبين اقتطاع الفوائض، إلى حين “بلوغ السيل الزبى”: اهتزاز المؤشرات الاقتصادية العامة وميلها إلى “الأحمر” (علامة على حظر متابعة السير في الطريق نفسها). فأدى تعاظم مديونية الدولة وشطر منها يبلغ الثلث بالدولار الأميركي، وتضخم الإنفاق على الإدارات والمصالح من غير ضبط، وتقلص العوائد غير المنظورة والمعروفة من تحويلات غير المقيمين ومداخيل السياحة وبعض الخدمات، وتردّي الصادرات فيما الواردات على حالها من الزيادة والتعاظم، وتوسّع دولرة المبادلات الداخلية تلبية لحاجات داخلية وأخرى إقليمية تفاقمت مع الحروب السورية والتوسع الإيراني، وتسديد فوائد عالية على سندات الخزينة تفادياً لهربها وتبخّرها- أدى هذا كله إلى نضوب عوائد معظمها ريعي.
طبقة التقنيين والخبراء فهل يوصف السبب في “احمرار” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة، وفي تفاقم عوامل الانكماش والانقباض، بهذه الحال، بأنه ناجم عن ضعف الخبرة التقنية أو عن نزاهة شخصية أو جماعية غير موثوقة؟ وإجماع الأطراف و”الأحزاب” والكتل كافة على دفع “التهمة”، وحملها التنديد بالفساد على مطعن أخلاقي، قرينة على اشتباه الدعوى والمحاسبة. ويكاد حال تهمة الفساد يشبه حال اغتيالات الأجهزة السورية الخالصة أو المشتركة: تقع البيِّنة كلها على عاتق من ادّعى، وليس على عاتق المدعى عليه (الفاسد أو القاتل) إلا الإنكار (وهو من صيغ القسم). وترجمة هذا في أحوالنا هي خرس هيئات القضاء والمحاسبة وصممها، وحبس الوثائق عن الجمهور، وتبادل أهل النفوذ والقوة التواطؤ والاقتصار على التهديد بالملفات عقاباً على انتهاك إجماع أو إخلال بالموازنة بين عناصر المقايضة.
فـ”معالجة” الفساد بتحكيم أهل التقنية والخبرة المحايدين، والمجرّدين على سبيل الافتراض من الميل مع المصالح والعصبيات والأهواء، تعزو ضمناً الفساد إلى علم ناقص أو إلى أخلاق متهافتة. ومن وجه ثانٍ، تعلّل هذه “المعالجة” التردي المالي والاقتصادي والاجتماعي بعلة واحدة هي الفساد، والهدر والتبديد من نتائجه. ولا تقول (المعالجة)، من وجه ثالث، لماذا ترضى الطبقة السياسية، الفاسدة كلها، توكيل “طبقة” التقنيين والخبراء، المنزّهين عن المصلحة، باجتثاث فسادها، والتضييق عليها، وتحصيل ما سرقه الفاسدون وخبأوه في حسابات سرية أو أجنبية.
الوجوه الثلاثة تخطئ الغرض..
1)
فالفساد، حين يستشري، هو وليد علاقات قوةٍ سياسية واجتماعية، وركن أبنية
سياسية واجتماعية تتولى (أو تقصّر عن تولي) هيئات التمثيل والإدارة
والتحكيم والمعلومات والمراقبة والمحاسبة، وتتعهد عملها وشروطه.
2) وليس الفساد وحده، في الحال اللبنانية، سبب الانكماش الوحيد، وقد لا يكون السبب الأول، أو الراجح، فتوجّه عشرات آلاف اللبنانيين من أصحاب الودائع والمدّخرات إلى الاكتتاب بسندات الدين العالية الفوائد، بالعملتين الوطنية والأميركية وتقديم هذه على تلك، مردّه الغالب إلى اضطلاع الدولة اللبنانية (تحت الوصاية السورية أولاً، ثم تحت وصاية “حزب الله” الخميني- الخامنئي والحرسي) بطمأنة جمهور المكتتبين، صغارهم وكبارهم، إلى حماية أموالهم. فالدولة، وهي ديوان الإصدار، لا تفلس، على خلاف زعم وكيل الوصاية ودرايته المالية. وسياسة الفوائد العالية على الودائع والمدّخرات عامل (ماجن) من عوامل تقليص النفقات على الاستهلاك، والاستيراد بالنقد الأجنبي باب أول من أبوابه في الاقتصاد اللبناني الهزيل.
3) والوكالة التي قد تنزل عنها الطبقة السياسية إلى طبقة الخبراء والتقنيين النزيهين، المفترضين، مقيدة وسياسية في الأحوال كلها، ومتربصة. وتعليل الرضا بحكومة أهل الاختصاص بالحركة المدنية والوطنية (الحراك)، وبعرضها وعمقها وعنادها، صحيح وفعلي. فلولا قوة الحركة لما قيَّد قيد “المشاهد” والصولات والجولات البائسة التي تختصر النزاعات السياسية المحلية في رعاية المايسترو الفيلقي والباسدراني. ولكن أثر الحركة رهن محافظتها على مواردها، واستثمارها هذه الموارد في إلهام مواقف، وإنشاء هيئات، وتغيير معايير راي وفعل.
حيثية الحراك السياسية
ولعل
الميل الظاهر- في بعض أوساط الحركة المؤتلفة من أوساط متفرّقة وكثيرة- إلى
قبول حكومة التقنيين والخبراء، بل استعجالها، عَرَض من أعراض انقطاع
الحركة من التاريخ السياسي والاجتماعي الذي أدى إليها، وتسعى في تتويجه. فـ
“الحل” التقني يستجيب طرحاً أو وصفاً للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية
والمالية يجرّدها من حيثياتها السياسية والبنيوية الفعلية، ويتعمّد الطرح
هذا التجريد، إما عن تصور وتصميم (وهي حال الكتلة الشيعية والكتلة
العونية)، وإما عن غفلة وتبرئة ذمّة من الولوغ في “التّركة” السورية و
“العقد” الأعرج وغير المتكافئ بين الأجهزة الأسدية وبين رفيق الحريري
“الخليجي”.
فمعظم عوامل الأزمة المستشرية اليوم هي من مخلّفات “التركة” و “العقد” هذين- أو ما يسمّيه الخطباء الحرسيون المحليون، بخجل مفتعل ومراوغة، “الحقبة السورية”-، ومن مفاعيلهما وارتداداتهما المتمادية. فالحريري الأب، أو الأول، رضخ للقسمة الأسدية و”القومية”، الإقليمية، القاضية بفصل شؤون “المعاملات”، الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية، عن شؤون الولاية أو السيادة، الحرب والسلم والمهادنة والديبلوماسية والأحلاف، وإليها وقبلها علاقات الجماعات (الأهلية والحزبية والمهنية والانتخابية والسلطات) بعضها ببعض، ويعود نظمها إلى الدستور. وأرست السيطرة أو الغلبة الأسدية إدارتها “الملف” اللبناني على هذه القسمة المدمّرة.
فوسعها، مثلاً، تمديد ولاية الياس الهراوي في 1995 نصف ولاية، تجنّباً للتحكيم في المزاحمة المارونية على المنصب، لقاء هرب 3 مليارات دولار من الودائع في شهر واحد. وأباحت، في 1993، حرباً بين “المقاومة الإسلامية” الخمينية وإسرائيل لقاء بلوغ الفائدة على المبادلات المالية واليومية بين المصارف 28- 32 في المئة. وأعفت الحزب الشيعي الحرسي من حل جيشه، على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى. وأسهمت إسهاماً راجحاً في اقتطاعه سيادة على حدة على الأرض والأهل والموارد والهيئات والأفكار. فاجتمع من هذا كيان، أهلي وسياسي وعسكري وديبلوماسي وإيديولوجي واجتماعي، يتصل بالمرافق اللبنانية الأخرى من طرق المعاش، وهي بالغة التأثير على المدى الطويل، والسيطرة، وأثرها مضاد لأثر طرق المعاش.
وترتيب قتال الدولة العبرية المحتلة في المرتبة الأولى إسقاط أسدي، وخميني حرسي من بعد، على اللبنانيين وسياستهم. وانتهج هذا الترتيب نهجاً منحرفاً فاقم الانقسامات الداخلية الحادة والقائمة عمداً. فهو لم يعبئ اللبنانيين، ولم يدعهم إلى تعبئة عامة مشتركة ووطنية في سبيل تحرير أرضهم المحتلة. ولم ينتظر اندمال الجروح العميقة التي خلفتها الحروب الفلسطينية- الإسرائيلية في اللبنانيين، أفراداً وجماعات، فندب إلى “التحرير”، والانفراد به عنوة وأحياناً قسراً، جماعة أهلية مذهبية اصطفاها وعزلها ودرّبها وموّلها وقادها جهاز “عبر الحدود” (الخامنئي) ينسّق سياسته مع الجهاز الأسدي.
وعلى هذا، ناء اللبنانيون بأكلاف “تحرير” لا يتولّونه هم، ولا يضطلعون بحوادثه وأوقاته وإيقاعاته، وعليهم تحمل مفاعيله، ولا يحق لهم معارضته أو مراقبته. ومن هذه المفاعيل، وفي صدارتها، تسديد ثمن “انتصار” شيعة لبنان على “الحكم المسيحي”. وأول أبواب هذا الثمن شراء ولاء عشرات الآلاف من الموظّفين لقادة “كومبرادور”، على قول الصينيين في وسطاء محليين يتولّون بسط سيطرة رأس المال الأجنبي على السوق الداخلية. وثاني الأبواب، استعجال عودة مفتعلة وصورية إلى وضع مالي واقتصادي واجتماعي “طبيعي”، إنمائي وإعماري”، في غياب عام لمجلس نيابي، ذي صفة تمثيلية قوية، ولهيئات نقابية ومهنية فاعلة، ولأحزاب سياسية قادرة على الصياغة والاقتراح. وتشتري العودة المستعجلة القبول بأحزاب حرب أهلية “مربوطة”.
وعلى المثالين السوري والإيراني، ومثال أسوأ مشتركاتهما، تسلّط على اللبنانيين، حلف “أسود” (مزيج غريب من الأصفر البرتقالي!) ينزع إلى جمع مقاليد الأمور والأحكام في يده الواحدة. وفي رأس ما يرفضه الحلف أمران متصلان: فصل السلطات بعضها من بعض، والإقرار بالحق في المعارضة. وهو رفض للسياسة، أي لتدبير المنازعات والخلافات من غير طريق العنف والقوة، ونفي لها. ويجاري “الحل” التقني، أو التكنوقراطي، الرفض والنفي هذين. فالسلطة المستبدّة والواحدة، في غياب المعارضة والمراقبة والمحاسبة “الشرعية”، تؤدي إلى الفساد والركود والفروق الشاسعة بين مراتب “المواطنين”. فعلاج السلطة الفاسدة، والغالبة، سلطة أخرى في مقابلتها، وليس الخبرة “المحايدة” التي يصح فيها قول أحدهم في المثالية الأخلاقية: هذه المثالية نظيفة اليدين إلا أنها تفتقر إلى يدين.
المدن