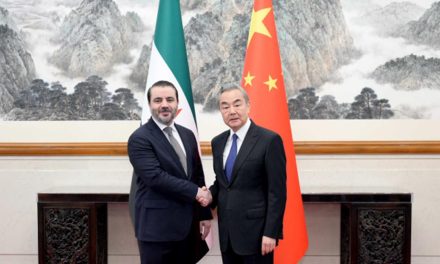عبد الرحمن مقلد:كشعراء..حظنا سيء في هذا الزمن

كم يبدو لافتاً أن نقرأ شعراً حديثاً، في هذه المرحلة بالذات، على الأقل في لبنان، عن مساوئ الصراف الآلي، وجحيم العالم النقدي… ذلك أن المصارف اللبنانية جعلت المودعين يعيشون ما يشبع العواء والعويل بسبب تحويل الودائع إلى أسرى، و”عواء مصحح اللغة” هو عنوان كتاب الشاعر المصري عبد الرحمن مقلد، الزاخر بلغة الاحتجاج والتمرد، على واقع الحياة المادية… عن الديوان هذا الحوار..
–تختار عنوانًا لكتابك الجديد “عواء مصحح اللغة” وتقتبس في مفتتحه عبارة من قصيدة “عواء” لآلن غينسبرغ، وتسرّ لي أن الديوان يجمع بين نقيضين: صراخ جيل “البيت” الأميركي وهدوء مصحح اللغة، وفي إحدى العبارات تقول “عوائي الليلة لم يسمعه أحد” و”عوائي لم يسمعه المارة؟”
نشأ هذه الموقف الصعب من عملي في مهنة الصحافة، من أن تكون في
تعاملك مع اللغة شاعرًا وصحافيًا في آن واحد، وحين يناط بك مراجعة مواد
صحافية، فتجد نفسك في تناقض صارخ؛ أنت الشاعر صاحب الموقف، سواء من اللغة
والجمال، أو من حيث الانحياز الأخلاقي والإنساني، وفي الوقت نفسه تقتضي
مهنتك (مصحح اللغة) أن تراجع هذه المواد فقط، سواء من حيث الصياغة أو
المراجعة اللغوية. فكانت أمامي معضلة وداخلي غضب… عبرت عنه باستخدام كلمة
“عواء” بكل ما تحمل من صخب وخروج وعنف وألم وقدرة على التعبير (هذا صوت
الشاعر داخلي) وفي نفس الوقت ما عليَّ إلا ان أراجع هذه المواد الصحافية،
وأخلصها من الأخطاء وأجملها، وأتركها كما هي دون تدخل، فما عليك سوى أن ترى
القاتل يمضي أمامك والمقتول يئن، ترى المظالم والمذابح والمحارق البشرية
والقتل على الهوية… في كثير من المرات أتمزق وأنا أراجع مواداً تمر عليك
في دقائق عن مذبحة ارتكب في أى مكان في العالم أو تفجير أو قتل على الهوية
أو حريق أو غرق بشر في البحر، يكونون بالنسبة لك مجرد خبر أو تقرير. ولكن
ما عليك أيها المراجع إلا أن تنظف الثياب المتسخة، وتدع الأمور تمر ما أنت
إلا شاهد على ما يحدث، هذا محور أساس عبرت في الديوان في عدد من القصائد،
منها قصيدة “حديث مصحح اللغة إلى ابنته”، وقصيدة أخرى “عواء مصحح اللغة”
التي تحمل اسم الكتاب.
– تطلق ما يشبه
الصرخة، و”أقارنُ بين دَوِيِّ الهَاونِ ورنينِ الحَرفِ الحُرِّ”، و”تَمُرُّ
زلازلُ وبراكينُ وأنا أعْوِي”، هل أنت مهجوس بمقاربة العنف واللغة الى هذا
الحد؟
بالمصادفة، كنت أتحدث مع صديقة عن المشهد الشعري العربي، عن كل هذه الدموية والعنف وانتشار كلمات مثل “الجثث” و”الأشلاء” في النصوص الشعرية، بالأخص لدى جيل الشباب في العراق، وأجبتها لأن هذا واقعهم، تتخيل أن جيلًا كاملًا نشأ تحت القصف والحرب الأهلية وعانى الويلات ورأى بأم عينيه التفجيرات والمفخخات، وكأننا كشعراء عرب حكم علينا أن يكون شعرنا عنيفًا وخشنًا ودمويًا كواقعنا العربي المنهار جراء الحروب والعنف والدماء والديكتاتورية والسجون. كان بودي لو أن يدخل عاشقان تحت المطر في باريس إلى قصيدتي. لو اتسعت لبكاء السنونوات وزهور النرجس وتوالي الأمواج، ولكنها كما ترى قصيدة أسيرة لقاموس الدماء ومفردات القهر والفقر، قصيدة مزجوجة في السجون، ومقتولة تحت الدبابات، ومنتهكة العرض، وخائفة، ووليمة لأسماك المتوسط… هي قصيدة إنهار عليها منزل، ومنذورة للموت وابنة للكوارث والمذابح.. للأسف هذا من حظنا السيئ أن نشأنا كشعراء عرب في هذا الزمن، كما أقول في قصيدة: “العربيٌ قصيدته للنزف/ العربي له أربعة بلاد محروقةْ/ وقطاع محتل/ وسجون/ ومليشيا/ وقتال أهلي/ ماذا يبقى للعربي بباريس/ أتى كي ينسى الثورة/ أو يرتاح قليلًا من تذكار الجثث المتفاحمةِ/ ولكن العربي أسيرٌ مهما طار/ أسيرٌ إن أطلقه الله وكان الأفق كبيرًا”. ومع ذلك نحاول أن نتحدث عن الأمل عن التصالح، عن الجمال، وعن مقاومة القبح، أن نتحدث عن موقف جمالي وشعري عربي موحد، نبشر فيه بانتهاء هذا الرعب والفزع الذي نعيشه، ونتحدث عن حيوات رائقة ننعم فيها ببلادنا وخيراتها.
– قد تكون هادئاً في مسار تصحيح اللغة وريفياً، كما تقول في حديث صحافي، ولكن تحضر الثورة في نصك، سواء الثورة المصرية أو ثورة الحياة، تثور بطريقة لا تخلو من التهكم، بل تتهكم بطريقة بديعة، سواء على عالم المستشفى العام أو ماكينة الصرف، أي أن معركة الحياة العامة؟ هل هذا الجانب يأتي كامتداد لثورة جيل البيت الأميركي؟
قرأت ما تيسر من المنتجات الأدبية لجيل الغضب الأميركي، بالأخص آلن غينسبرغ، وحضرت معرضًا في باريس لآثارهم، وقرأت كثيراً من نصوص قصيدة النثر الأميركية، وهي بالطبع ثورة شعرية ضد الصياغات المألوفة والمواقف الشعرية المعتادة من مقاربة الموضوعات، هي بمثابة صرخة عالية الصوت تنذر البشر بمصيرهم، وتسخر من الحداثة، تسخر من أميركا، وما أتت به من معلوماتية واتصالاتية نفعت البشر في جانب، إلا أنها سحقتها في جوانب كثيرة، يكفي أنها تخفي خلفها هذا الإخطبوط الاقتصادي الذي يمسك بأعناقنا… هذه الإدانة والدعوة للتمرد والخروج، بل والبصاق على حضارة أميركا، كان متجسدًا في أعمال «جيل الغضب»، ومن قبل في أعمال أستاذهم هنري ميلر… وأنا بالطبع كشاعر عربي مطالب بأن يكون لي موقف من كل هذا.. كما أني أنحاز ولا أزال للثورة المصرية وثورات الربيع العربي التى أتت في جانب منها كاعتراض وكصرخة بشرية من أجيال جديدة ضد اتباع النمط الرأسمالي المغطى بالقناع الديكاتوري العربي، لذا نشأت مثلا حركة «احتلوا وول ستريت»، كانعكاس على ثورة يناير المصرية وموقفها الاجتماعي الاحتجاجي. أيضًا بالطبع كما تقول السخرية والتهكم مادة أساسية وأساليب مقاومة مهمة؛ فطالما نحن نستطيع أن نسخر ونتهكم فلا تزال لدينا القدرة على المقاومة والابتكار داخلها، لذا تجد الزعماء والقادة أعداء طبيعين للسخرية.
ما الذي فعله بك العالم المادي والاستهلاكي والنقدي، خصوصا أننا بتنا نعيش على ايقاع ماكينات الصرف؟
أخذ منا أرواحنا.. انتهك عوالمنا… أخذ أوقاتنا.. أفسد بلادنا… حتى بتنا كأننا نعمل لدى البنك الدولي وصندوق النقد… من سنوات قبل أن تنتشر مثل هذه الماكينات في الشوارع، كنا نحصل على أموالنا بشكل مباشر الآن، الآن لم نعد نملك شيئًا، كل شيء يدور غصبا عنا… ونحن أصبحنا مجرد «عملاء» وأرقام… من هنا تأتي أهمية الشعر كفن الإنسان الأول كصرخته البرية الخارجة والمنادية بالعودة للفطرة والاتساع العودة للطبيعة، انظر مثلًا الآن لاحتجاجات المناخ، ألا ترى أنها الشعر كان قائدا ومحذرا من انتفاض الطبيعة علينا، وكم دعانا للتصالح مع الأرض.. أن نعود كما كنا فلاحين وصيادين بسطاء… أما عن ماكينات الصرف فما كان من الشاعر إلا أن عاملهن كفتيات المدينة الليليات يفوت عليهن ويغريهن بالخروج عن الخدمة المصرفية، بعد أن يدخل معهن من هذه التجربة الجسدية، حيث يدخل الشاعر كارت تعريفه، وتبدأ الماكينة في الاستجابة، إلى أن تصل للحظة تشبه حالة الأورجازم، والاندماج، ويصدر هذه الأزيز الرائع المشمول برائحة الأوراق المادية. هذه لحظة مميزة جدًا.
– تقول عن نفسك «أنا بستانيّ اللغة المولع بالتنقيط»، لماذا أنت مهجوس بالتصحيح وليس بابتكار مفرداتك الشعرية، واشتقاقاك اللغوية؟
إن نتحدث عن اللغة، فأنا كما قلت رجل يتعامل طوال الوقت معها، سواء كصحافي مختص بالصياغة والمراجعة اللغوية، أو كشاعر، والموقفان يختلفان بالطبع، وإن كانت هناك تأثرات، إلا أنني أعتبر نفسي من فصيل الشعراء اللغويين، مع هواجس عديدة حول درجات الضبط والالتزام بالمعجم مع قدر من التجريب اللغوي. اللغة هي في نظري بيت الشاعر الذي يسكنه، فبعضنا يحب أن يسكن كوخًا، وبعضنا يحب أن يسكن قصرًا مزخرفًا، ولكني أحب أن أسكن بيتى الذي أعيش فيه… أن تشبهني لغتي وتشبه حياتي وتشبه زمني بكل ما فيه… أحسب أيضًا أن كل قصيدة تخلق حيزها اللغوي، وتختار مفرداتها وكلماتها وطرائق صياغتها، فمثلا في قصائد مثل «مغازلة لموظفات البنك» و«صلاة إلى ماكنة صرف الأموال»، تكون هناك تلبس اللغة حلة تقنية كأن ترد: «يا ساقياتِ المَدِينينَ خمرًا من الكَهْرُباءِ ورائحةِ المالِ/ يا مانحاتِ القروضِ مؤجلةِ الدفعِ/ أمطرنني بسلالٍ من القُبلاتِ الأثيريةِ اللاهبةْ/ تَخَطَّفَنَ من وَرَقِ البنكنوتِ/ لتكشفن عُريي.. / وتغرينني /لأعودَ إليكنَّ يا عاهراتِ المدينةِ يا سيداتِ الأزيزِ»، وحين أتحدث مثلًا عن موقف الأم التى يغيب عنها أبناؤها ويتركونها تعاني وحيدة، تحضر لغة لها طابع شعبي بعض الشيء، مثلا: استزيدي من صفائك هذا الليلَ/ يا أمُّ/ كي تجدي دواءَ ارتفاعِ الضغطِ وحدَك / لا أحدٌ سيأتيك من سَفرٍ / ليدفعَ عنك الشرَ / أو يوقفَ العَطَّارَ / إن خالفتْ يسراه في كيلةِ الكَمُّونِ.. الناسُ منشغلون يا أُمُّ في خَطبٍ جَليلٍ يدقون الخيامَ لتنجِيَهم مِن القَيظِ / يخفون البَهائمَ خَوفَ الذئبِ.. / يَمشونَ للمَرعى حُفاةً /ومَوتورينَ خَوفَ جَفافِ الماءِ.. / آَلاتُهم لم تَعْفِها الرَيحُ من صَدأٍ سريعٍ/ ومن عَطبٍ يُخرِّبُ مَعدِنَها»، هذا هو موقفي من اللغة بأن كل نص له لغته الخاصة.
– دون كيخوته يأتي كرمزية كمحاربة طواحين الهواء، ما الذي يحاربه دون كيخوتة النائم في نصك؟
أدعو دون كيخوته، هذا البطل التراجيدي القادم من الفن إلى الواقع، وليس الداخل من الواقع إلى الفن، وقليلة هي هذه الشخصيات التى تخرج من الكتب إلى الحياة، أدعوه للاستيقاظ من النوم لمحاربة الأوهام وليمنحنا القدوة فى المقاومة، ولو كانت هذه المقاومة وهمية؛ أن نحارب طواحين الهواء والغيلان والسحرة… لكننا نحتاج كلنا في هذه الأيام لهذا الحس من المقاومة، حتى تخرج من بيتك وتقترف الحياة… تلبس عدتك «الدون كيشوتية»، وتحاول التجديف والاشتباك مع الطواحين، نحن وسط المحن والمآسي التى نشهدها، مطالبين بأن نتلبس هذه الروح الدون كيخوتيه، ونتعلم من مآثرها، مثلًا في قصيدة بعنوان «في الزنزانة» أنت مطالب أيها الدون كيخوتى أن تركض لتتسع الزنزانة وأن تتجاوز كل هذا، «ليس الوقتَ الأنسبَ هذا للتحديقِ لسقفِ «المَحْبَسِ»/ أو إحصاءِ عناكبَ/ هذا وقتٌ للهَرْوَلةِ / وعلى الزنزانةِ/ أن تنفتحَ مسافةَ مجرى/ من منقارِ الطائرِ للحَوْصَلةِ/ وأن تتسعَ لمدِّ القدمِ/ وشَدِّ الأخرى/ أن تتسعَ قليلًا».
– وهل صحح اللغة أصبح مثل محارب طواحين الهواء؟
دائما ما أتصوره هذا الرجل القادم من الأرياف المصرية الهادئة، والمحملة بالقيم والرحابة والفطرة، فإذا به في وسط المعمعة الصحافية السياسية، فبالتالي يلوذ لمهنته المقدسة الممثلة في تهذيب اللغة من الأخطاء، وكأنه يهذب النخل ويحرث الحقل… دائمًا ما أقدس هذا النمط من البشر الذين يقضون أوقاتهم في عمل جميل، يجلسون في ركن هادئ بعيداً عن صخب العالم، وأرى أنهم قادرون على المقاومة والحفاظ على القيم النبيلة وحراستها.. هؤلاء معادل ضروري في الحياة يظهر في ديواني وتمسكي بالعمل في هذه المهنة البعيدة عن الصخب؛ ولي تجربة شخصية، فبعد سنوات من العمل في غرفة صناعة الأخبار المركزية في إحدى الصحف المصرية، تعرضت لتجربة الفصل منها، بسبب موقف، وكان وقتها وقتًا صاخبًا، وخضت معركة كبيرة مع رفاق ضد الفصل التعسفي، إلى أن وصلت للعمل في إحدى الصحف مراجعًا لغويًا، وبالفعل عثرت على أجواء مريحة وهادئة رفقة زملاء مكللين بالجلال والاحترام فتمسكت بها… في قصيدة «عواء مصحح اللغة» يجد المصحح الغوي نفسه مضطرًا للمواجهة: أنا رجلُ التصحيحِ المثقلُ بالأخْطَاءِ / كم هذبتُ حالَ النَخْلِ/ وأسقطتُ الثمارَ الفاسدةَ / جديرٌ بي الآن أن أصعدَ الدَرجَ حتى نهايته / وأتركَ هناك أشيائي الحَمِيمَةَ / وذاكرَتي المُثْقَلةَ بالمحبةِ / ثم أسقطُ عليكم فجَّاً أصبُّ اللعناتِ / وأفتحُ فمي كماسُورة صَرفٍ مُمتلئةٍ بالسباب / ولا أغْلقُه أبدًا/ أخلع ثيابي / وأصفعُ رئيسَ الحَرس / وأقاتلُ وحدي جيشَ «البُودي جردات» / حتى أنزفَ وأتداعَى…. غادرتُ البراحَ إلى الحَلْبَةِ الضَيقةِ / وقابلتُ الأوغادَ وجهًا لوجهٍ / فلم يعدْ لي غيرُ أن أعاقبَهم / وأنا مصححُ اللغةِ العتيقُ/ بأن أرفعُ أجسادَهم على أنشُوطَةِ الضَحِكِ/ أضَعَهُم في مُتْحَفِ المُومِياوات / وأجردُهم من الفَضائِل.. وأخبرُ الجميعَ أنهم المقصودون بكلّ ما سبقَ من السبابِ .. وأعودُ لأحملَ عراجيني ومقشاتي الأليفة وأعملُ في حُقولِهم الفضائية».(للعلم أنا كتبت هذه القصيدة قبل أن يحصل لى ظرف فصلي من العمل، ودائمًا ما أمزح بأن أقول إن هذه هي القصيدة التى “فصلت” صاحبها، كقصيدة المتنبي التى قتلت صاحبها).
– ما الذي تعنيه لك الأسماء الأدبية التي وردت في النص، سواء ابن زريق أو البسطامي أو بيسوا أو دون كيخوته؟
ابن زريق البغدادي يحضر في قصيدة بعنوان «ذئبان مجروحة»، وبها شبه معارضة حديثة لقصيدته اليتيمة شديدة الحزينة التى عثروا عليها بعد أن مات وفيها يعتذر لزوجته العراقية الجميلة، ويلوم الزمن لأنه اضطره للمغادرة بحثًا عن العمل والرزق. وأنا كذلك في فترة من عمرى أضطر لمغاردة بلدتى في شمال مصر، لأحضر للعمل في القاهرة ، كواحد من آلاف من المصريين الذين يسافرون بحثًا عن الرزق، وعليهم أن يغادروا زوجاتهم وأبناءهم، ولكن ما العمل، علينا أن نشقى لنحصل على قليل من الرزق وإن كنا في الآخر نكتشف أننا نهدر أعمارنا وأوقات سعادتنا لنملأ ماكينات الصرف الخاصة برجال الأعمال: من يدفعُ أثمانَ الأوقاتِ المهدرةِ المُثْلَى لمبادلةِ الحبِّ/ حين تنادينا الرَغبةُ لننالَ ثمارَ الشجرِ اللدنِ/ ونختالَ بأبهاءِ الفِردوسِ العَاري/ من ذَكَّرَنَا أن سِياطًا ومَواثيقَ تَشدُّ يدينا/ وتباعدُ بين الخَمرِ وأفواهِ الظمآنينَ/ وتدفعُنا لنبددَ أحلامَ الخِلسةِ/ ندركُ «أنَّ الوقتَ تأخرَ» ورجالُ الأعمالِ هنالك ينتظرون لنملأ ماكيناتِ الصرفِ/ ولو أطفأنا الرَغْبةَ وسكبنا ماءَ اللذةِ في أقرب بَالُوعَة ..».
أما الشاعر البرتغالي فرناندوا بيسوا فظهر في نص، إذ كنت أقرأ له قصيدته “نشيد بحري”، وفيها يمجد البحارة وأعمالهم ومغامراتهم في البحر، فإذا بي أجد نفسي قابعًا في الحافلة ذاهبًا لعملي لاعنًا الحياة: “لا تنسَ أنك فكرتَ في البحر/ أمسَ/ وأنت تريقُ قصيدةَ بيسوا على صهدِ روحِك/ كنتَ تريدُ التصرفَ غير مبالٍ/ كبحارةٍ في محيط/ وفكرتَ في القَفْزِ من قاربِ «الميكروباص»! وأكدتَ أن البقاءَ بلا عملٍ والتمشي قليلًا على نور شمسٍ هو الفوزُ وليس البقاءَ أسيرَ الدوام”.
وأبو يزيد البسطامى الصوفى يحضر في قصيدة بعنوان “مجاز مرسل”، ترصد حالة الهيام الشعري في الزمن والعدو وراء “النرجس الغض”، الوارد في شطحة أبي يزيد: “قالوا إن سبعة آلاف من السنين مضت ولكن لا يزال النرجس غضًا طريًا”.
– وضعت دار النشر كتابك في خانة “إبداعات متمردة”، ما الذي يعنيه هذا التصنيف؟
سعدت جدًا بالتعاون مع “منشورات الربيع”، لصاحبها الناشر أحمد سعيد، الذي تحمس للديوان، وعمل على إخراجه في صورة تليق بالشعر، وأسعدنى وضعه الديوان ضمن هذه الخانة، فالتمرد فريضة، على كل شاعر أن يحاول الخروج على ما كتب سابقًا، وأن يبتكر طريقته في الكتابة، كما من الواجب أن يكون له موقف جمالي وأخلاقي واجتماعي من القضايا المطروحة، وأرى أن الديوان غير غافل عن الجماليات، ينحاز للقضايا، ويتمنى أن يجد فيه قارؤه فرصة ومساعدة ويكسبه قدرة على المقاومة.
–هل ما زالت قصيدة النثر محرمة نوعاً ما في مصر؟
لا أظن ذلك، قصيدة النثر ترسخ وجودها، بتوالي الأجيال التى تكتبها، وإن سيطر على بعض المؤسسات في مصر شعراء أو نقاد لهم انحيازاتهم القديمة، إلا أننى أؤكد أن هذه المؤسسات هي التى باتت خارج الزمن وخارج المشهد، بينما أصبح لقصيدة النثر وجود قوي ومسيطر.. وعلمًا بأنى أكتب القصيدة الموزنة في أغلب ما أكتب، إلا أني أعتبر نفسي إبنا لقصيدة النثر، وأعتبر أن ما أكتبه قصيدة ولدت “متمردة” على قصيدة النثر، وتحاول الخروج منها، وتكتشف أرضًا جديدة وتعيد فهم الموسيقى فهمًا آخر. الآن استوت في رأيي الأشكال الكتابية العربية، ووصلت إلى ذراها من حيث الشكل، والرهان الآن على الصدق والتجريب واقتراف موضوعات جديدة، وتطوير اللغة، ليجد الشاعر لنفسه موطئ قدم.
حاوره: محمد حجيري- المدن