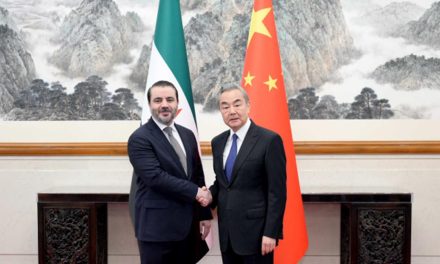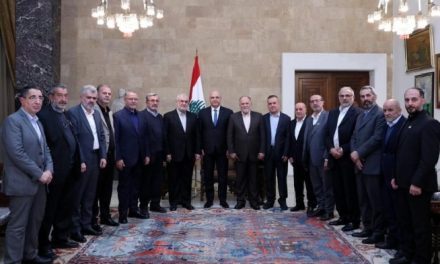لا تستغربوا.. جبران باسيل رئيساً للجمهورية

قبل العام 2016، كان كل مستهولي وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة، مقتنعين أنه سيسبب كوارث مشابهة للتي أحدثها بين 1988-1991. كانوا يتنبؤون بما ستجلبه رئاسة عون من “معارك”. خصوصاً، أنه منذ عودته عام 2005، لم يهدأ يوماً عن الصدامات السياسية الباهظة الثمن، ولم يخفت إصراره على تحطيم أركان جمهورية الطائف وأعمدتها. كانوا متيقنين أنه يحمل مشروعاً ثأرياً، يمتزج فيه حافزه الشخصي مع “حساب” مسيحي مرير من الحقبة السورية. بمعنى آخر، كان ميشال عون يحمل مشروعاً رئاسياً مشتبكاً مع الماضي، خالياً من أي تصور للمستقبل. بل إنه كان يستأنف ماضياً ويمنع انصرامه.
كل القوى السياسية، حتى الحزب الذي “تفاهم” معه، تعتقد أن ميشال عون شخصية صعبة المراس والتعامل معه يتطلب استعداداً لمفاجآت غير سارة وغير متوقعة. وتتمنى لو أنه تقاعد هناك في منفاه الباريسي. أما ترشّحه للرئاسة فكان بنظر معظم التيارات السياسية يعني الدخول في مغامرة خطرة، وسيشكل دوماً استفزازاً غير صحي للحياة السياسية.
مع ذلك، نجح ميشال عون في فرض مقولة جديدة: الرئيس هو الذي يكون “قوياً” في بيئته المسيحية. ولأسباب كثيرة تبنى حزب الله خطاب عون وترشيحه. وعنى ذلك تلقائياً أن مرشح الحزب هو رئيس الجمهورية ولا أحد غيره. ورغم أن الأكثرية لم تكن متوفرة في مجلس النواب للتصويت له، إلا أن طريق بعبدا لن تفتح لغيره. كانت خطة الجنرال محكمة هذه المرة: إما هو أو الفراغ.
انهارت كل مقاومة ضده بعد سنتين، وتطوع المهزومون متسابقين لترشيحه وانتخابه.
وحدث كل ما هو متوقع من رئاسة عون. وأسوأ من أكثر السيناريوات تشاؤماً.
اليوم، ثمة إجماع شعبي، واصطفاف لمعظم التيارات السياسية، ضد حتى تخيل جبران باسيل رئيساً للجمهورية. هو الأبرز على لائحة المكروهين. وهو الشخصية الأكثر استفزازاً بين الطقم السياسي الحاكم، في الداخل والخارج.
وبقراءة “عقلانية” تبدو حظوظه معدومة لأن يرث عمه. خصوصاً وأن الجميع -مبدئياً- يبحثون عن طريق للخروج من هوة الكارثة، ولا يريدون تكرار تجربة عون. وضمن “البيئة المسيحية”، ما عاد يملك رصيداً كرصيد عون، لا شعبياً ولا حتى كنسياً. والنخبة المسيحية ما عادت تجد مصالحها (خصوصاً الاقتصادية) متماشية مع سياسة باسيل. فحتى الصور التذكارية معه، يتم تمزيقها أو حرقها.
رغم كل ذلك، باسيل مرشح لرئاسة الجمهورية. ومن الواضح أن الانتخابات النيابية كما مصير الحكومة ومصير الملفات القضائية وكذلك الاستحقاقات الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى قضايا الحدود والسياسة الخارجية والتعيينات الإدارية الحساسة، وكل المسارات الدستورية والتشريعية والتنفيذية.. “موقوفة” أو مرهونة من أجل صفقة شريرة تضمن عبور باسيل نحو قصر بعبدا.
إنها مجدداً خطة محكمة ولها حظوظ كبيرة في النجاح. إما هو أو الفراغ. هذا ما أفهمنا إياه فخامة الرئيس في الأيام الماضية: باسيل أو لا أحد.
قد يبدو هذا في بلد طبيعي ضرباً من الهذيان. وقد يجده آخرون أمراً مستحيلاً، وفق قراءتهم لسياسة حزب الله وحساباته. أو يظنون أن “الانفراج” الذي سيسفر عن اتفاق أميركي إيراني، لا بد أن ينعكس إيجاباً على لبنان وربما ليونة كبيرة من حزب الله، تُترجم بانتخابات رئاسية تأتي بشخصية مقبولة محلياً وخارجياً.
طبعاً يغيب عن ذهن هؤلاء أن ميشال عون أتى رئيساً كترجمة أمينة لتداعيات الاتفاق الأميركي الإيراني عام 2015. فحينها، سقط لبنان حرفياً في الحضن الإيراني كمكسب استراتيجي للاعتراف الأميركي الضمني والعلني بالنفوذ الإيراني في المنطقة.
ولذا، الانفراج الإقليمي ليس بالضرورة “نعمة” على لبنان. بل ربما يتيح لحزب الله أن يتشدد أكثر ويرتاح جداً.. وينصّب علينا هذه المرة الرئيس الأكثر ضعفاً في الجمهورية: جبران باسيل.
من قال أن نهاية كارثة ليست ابتداءً لكارثة أعظم وأفدح؟
المدن