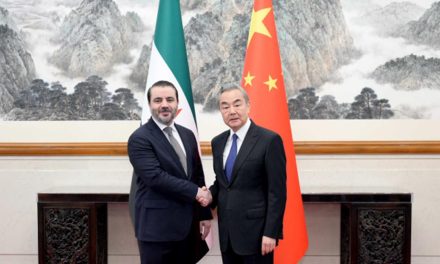ننُّوس اليوناني في قصيدته الرؤيوية ” ملحمة بيروت الميمونة ” :جمال بيروت الفريد هو مصدر ثرائها وشقائها الأبديين

ننُّوس اليوناني في قصيدته الرؤيوية ” ملحمة بيروت الميمونة ” :
جمال بيروت الفريد هو مصدر ثرائها وشقائها الأبديين
شوقي بزيع
قليلة هي المدن التي كانت مسرحاً للنزاعات وصراعات القوى المتناحرة , كما هو حال بيروت ذات الجمال الآسر والتاريخ الحافل بالمفارقات . فقد قُدَّر لهذه المدينة العريقة , والتي اشتقت أسماؤها المختلفة ,بيريتوس وبئروت وبيرويه , من لفظة البئر , وفق بعض المؤرخين , أن تدفع غالياً ثمن موقعها ودورها المميزين , وأن تهبط الى بئر عذاباتها السحيقة كلما وصل مجدها الى ذراه .والأرجح أن الجغرافيا الملتبسة التي وهبت بيروت نعمة الجمال , هي نفسها التي جعلتها ضحية فالقين زلزاليين , أحدهما جيولوجي يكافئ قياماتها المتجددة بالدمار الكلي أو الجزئي , والآخر حضاري ثقافي , يحول تاريخها الطويل الى محل للتنازع الدائم بين الداخل والخارج , أو بين جماعاتها الأهلية المتنابذة .
كأن بيروت بهذا المعنى أشبه بالوعد الذي يصعب تحققه , أو بمدينة مؤجلة تظل أبداً قيد الانجاز , أو هي قصيدة مموهة بهيئة مدينة . ولأنها كذلك , فقد حظيت عبر العصور المتعاقبة باهتمام الكثير من الشعراء الذين رأوا فيها صورة عن الشعر نفسه , سواء في بحثه اللانهائي عن يقين ما , لا يكف عن الهروب , أو في احتفاء اللغة بحريتها المجترحة خارج سجون المعاجم .
وإذا كانت بيروت قد شكلت محوراً أساسياً للمئات من قصائد الشعراء ومقطوعاتهم ونصوصهم , فإن القصيدة الطويلة التي كتبها ننّوس اليوناني في القرن الرابع الميلادي , تحت عنوان ” ملحمة بيروت الميمونة ” , هي واحدة من أهم النصوص التي كُتبت في حب بيروت وحولها , عبر العصورالمختلفة . لكن ما يبعث على الحيرة والاستغراب , هو كون الشاعر الذي قدم هذا الانجاز المتميز , قد ظل مغموراً وغامض الهوية الى حد بعيد , إضافة الى أن عمله المدهش لم يلفت انتباه أحد من النقاد والدارسين العرب , قبل أن يتولى المؤرخ والكاتب اللبناني يوسف الحوراني نقله الى العربية , في العام الأخير من القرن العشرين .
والملاحظ أن كل ما ذكره المؤرخون ودارسو الأدب عن ننوس , هو أنه ولد في الاسكندرية في أواخر القرن الرابع الميلادي , ثم جاء بعد ذلك الى بيروت ليستقر فيها , وهي التي كانت في الآونة التي سبقت زلزالها الشهير , مدينة الشرائع وعاصمة الثقافة التعددية , التي يقصدها الآلاف من كل صوب , لجنْي المعرفة والمتعة على حد سواء . وقد قُيض للشاعر اليوناني المأخوذ بدور بيروت الحضاري , أن تتفتح موهبته في كنف التوترات المقلقة التي شهدتها الأمبراطورية الرومانية في تلك الحقبة , حيث لم يجد الرومان ما يردون به على دعوة المسيحية الى قيام ” مملكة السلام ” والمحبة بين البشر , سوى خوض الحروب المتكررة والمدمرة , قبل أن يأخذهم ملكهم قسطنطين الى مصير آخر .
وحيث كانت عبادة ديونيزيوس , إله الكرمة والزرع والخمرة , شائعة في ذلك العصر , فقد جهد ننوس الذي لُقّب بالديونيسي لشدة تعلقه بالحياة , في أن يُبعد إلهه الأثير عن صورته العنيفة , ليحوله الى مرشد ثقافي وجمالي , وداعيةٍ للوحدة الانسانية , حيث لا خيار أمام قطبي العالم المتصارعين , سوى التكاتف والتآزر لهزيمة البربرية . وإذ اعتنق الشاعر في الوقت ذاته , العقيدة الأورفية المنسوبة الى أورفيوس , والتي ترى في الفن والحب هديتي الحياة المثلى , فقد أبدى إعجاباً منقطع النظير بلبنان وأهله , فامتدح قدموس الذي خرج من صور بحثا عن أخته أوروبا التي اختطفها زيوس , والتي أهدت اسمها الى القارة الأوروبية , فيما أهداها من جهته حروف الأبجدية . كما أبدى في الوقت ذاته إعجاباً بأدونيس , الذي قتله الخنزير البري على ضفة النهر الذي ما لبث أن حمل اسمه , وأظهر اعتزازه بالشاب الإلهي الفاتن الذي فطر مصرعه قلب أفروديت .
أما الملحمة نفسها فتروي بلغة مترعة بالاستعارات وطافحة بالحماس العاطفي , قصة المدينة – الأنثى ذات الجاذبية القصوى , التي باتت مع الزمن مدينة العالم وحاضنة الحياة الهانئة , والمحصنة بسور منيع من الشرائع والقوانين . وإذ أرادت أمها أفروديت أن تبحث لها عن زوج مناسب , فقد طلبت من ابنها إيروس أن يوتّر قوسه الذهبي ويضرب بسهم واحد قلب بوسايدون إله البحر , وديونيسيوس إله الزرع والخمر . وبوثبة رشيقة وجناحين يخفقان في الخواء , أنجز إله الحب الصغير فعلته الماكرة , مخترقاً بسهمه المسنون قلب الإلهين معاً , فأقبل الأول من جهات صور ليقدم لمدينته المشتهاة ولاءه وحبه وعناقيد عنبه السوداء , بينما راح مزلزل الأرض بوسايدون يدور حول المكان , مسلحاً بأمواجه الهوج ودوامات قلبه الفائرة .
وبعد أن جعله الخجل فريسة للحذر والتردد , وعقد لسانه جمال المدينة , قرر ديونيزيوس وقد استشعر خطورة خصمه المتربص , الانتصار على هواجسه السوداء , فتقدم نحو معشوقته الفاتنة داعياً إياها الى القبول به زوجاً بقوله :
إنني فلاح من لبنان الذي يخصُّك
وإذا كان ذلك يرضيك
فسأسقي لك أرضك وأعتني بقمحك
خذيني كبستاني كي أغرس شجرة الحياة
فأنا أعرف كيف ينضج التفاح
وأجعل الزعفران اللطيف ينمو الى جانب اللبلاب
إلا أن قصائد الإله البري ومناشداته اللهفى , لم تنجح في استمالة المدينة الفتية التي أعطت لتوسلاته أذناً صماء . وإذ كان بوسايدون يتابع حرقة غريمه وصدود معشوقته بفرح بالغ , خرج من بين الأمواج ليقدم هو الآخر أوراق اعتماده للمدينة التي خلبت لبه , فخاطبها بالقول :
اتركي الأرض أيتها الصبية
فأمكِ أفروديت لم تكن من الأرض
بل هي ابنة المياه المالحة
إنني أقدّم لك بحري المترامي كهدية عرس
لن أقدّم لكِ البصّارات بعيونهنّ الزائغة
بل سأقدم لك الأنهار كهدية زواج
وستكون جميعها وصيفاتٍ لك
وعندما ظهر لأفروديت أن الطرفين متساويان في حبهما لابنتها الفاتنة , أعلنت أن عليهما أن يتقاتلا من أجل العروس , التي ستكون مكافأة المنتصر على شجاعته . وإذ وافق الإلهان العاشقان على الاقتراح , لم يترك كل منهما سلاحاً يملكه إلا واستخدمه في المعركة , فاقتلع ديونيسيوس كروم لبنان من جذورها وبدأ يجلد بها عرين خصمه اللدود . وانتضى بوسايدون شوكة البحر المثلثة , وأجهز بها على الكثير من كائنات البر , قبل أن تشتبك الأسماك مع السحالي , وزهور اللوز مع رغوة الزبد , والأمواج مع جذوع الزيتون . ورغم شعور المدينة الخفي بأن قلبها بدأ يميل الى فتى الكروم الوسيم , إلا أن زيوس كان له رأي آخر فزلزل بصواعقه العاتية كيان ديونيسيوس المذهول , تاركا لغريمه البحري أن يكسب الحرب , ويصبح عريس المدينة بلا منازع .
ومع ذلك فإن بوسايدون أدرك بحدسه الثاقب أن ألق بيروت الفعلي , لن تحققه سوى التسويات العادلة بين المتنازعين حولها , فقرر بعد الانتهاء من مراسم الزفاف , أن يتصالح مع اللبنانيين , وأن تكون مساعدتهم في خوض غمار البحر , بمثابة الهدية الثمينة لمصاهرته لهم . أما ديونيسيوس المثقل بألم الحب ووطأة الهزيمة , فقد أقنعه أخوه إيروس أن يترك جبال لبنان ومياه أدونيس ليلتحق ببلاد اليونان , حيث تنتظره نساء فاتنات ليعوضنه عن خسارته .
والحقيقة أن قراءةً متأنيةً لملحمة ننوس , لا بد أن تُشعرنا بالذهول إزاء ذلك الثراء التخييلي والأسلوبي المدهش الذي يمتلكه المؤلف , كما إزاء وقوفه العميق على معنى بيروت ودورها التنويري , فضلاً عن رؤيته الاستشرافية لمآلات المدينة التي ظلت عبرالتاريخ , محلاً لتنازع البشر والآلهة , وصراع الداخل والخارج , وحصّالة للمآسي التي لم يكن انفجار مرفئها المروع قبل سنوات أربع , سوى حلقة من حلقات مكابداتها المتواصلة . ولعل أفضل ما أختم به هذه المقالة , هو استعادة ما كتبه سباستيان كراموازيه في القرن السابع عشر , الذي وصف ننوس بالقول ” إنه يساوي جلال هوميروس وسمو بندار وتماسك سوفوكليس وبساطة هزيود وملوحة أريستوفان . إنه الشاعر الذي كان يبحث عنه أفلاطون دون أن يعثر عليه ” .