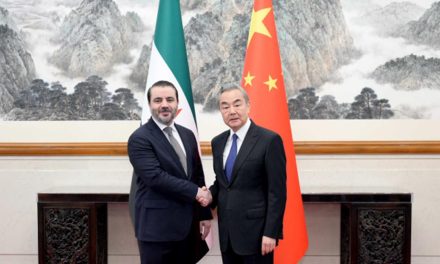الوجه الآخر للسنوار… والحب الوحيد


كتب نادر حجاز في موقع mtv:

“يبدو أن قدرنا هو أن نعيش حبًا واحدًا فقط، حب هذه الأرض ومقدساتها وترابها وهوائها وبرتقالها. قصتنا قصة فلسطينية مريرة، لا مكان فيها لأكثر من حبٍّ واحد وعشقٍ واحد”… كلمات كتبها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في كتابه “الشوك والقرنفل” في العام 2004، في زنزانة أمضى فيها 23 سنة من حياته.
يعتبر البعض أن السنوار غامر كثيراً صباح السابع من أكتوبر 2023. ربما لم يقدّر جيداً حجم ردّ الفعل الإسرائيلي، أو قد يكون راهن على دعم لم يحصل عليه من حلفائه. فكانت النتيجة، بعد مرور عام على “طوفان الأقصى”، خراب غزة وموت أهلها وأطفالها وتهجير الملايين.
ربما أخطاً السنوار في حساباته، وأفسح بالمجال أمام إسرائيل لإغلاق حسابها الطويل مع حركة أزعجتها طوال عقود، وسط صمت عالمي، لا بل موافقة من دول كبرى وصفت اغتيال الرجل بأن العالم سيكون أكثر سلاماً من دونه.
هكذا يرى العالم السنوار، لكن ما لا يتوقّف عنده كثيراً، هو الوجه الآخر كإنسان، من أين جاء وأين وُلد، وأي طفل يحمل في ذاكرته؟

قد يمثّل السنوار حالة متطرفة لجهة نضاله على أساس ديني وعقائدي، لكنه ذلك الفلسطيني الذي عاش في خيمة على شاطئ غزة مهجّراً، وفي دفتره القديم قصص المعاناة الفلسطينية، كما صورة أمه وأخوته يبحثون عن مأوى وسط الشتات والجوع والقهر.
هو جزء طبعاً من تاريخ علاقة الحديد والنار بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكنه جاء في الزمن الخطأ للعمل المسلّح، وقد سبقته إليه قافلة طويلة من الفدائيين. وكان أقل دبلوماسية من ياسر عرفات الذي اختار في لحظة من تاريخه أن يذهب إلى الأمم المتحدة وفي يده قصفة زيتون، وأن يعطي فرصة للسلام. فعاد إلى الأرض التي حلم ببناء دولة فلسطين عليها، وإن كان على قطعة أرض تشبه نصف الوطن ونصف القضية.
كان السنوار أكثر جنوناً من جميع الذين سبقوه، وقد يعتبر البعض أنه قرّر الانتحار، ولم يفكّر بشعبه يوم السابع من أكتوبر، فذهب بعيداً ربما بحلمه الفلسطيني العميق، فسقط ضحية الواقعية السياسية والغد الذي لن يراه لهذا الشرق، وما سيحمله لذاك الشاطئ الغزي المتكئ على مدينة مدمّرة بلا معالم ولا شوارع ولا عناوين.
ربما كانت لديه فرصة ليغادر مع عائلته مقابل إطلاق الأسرى، لكنه اختار أن يبقى، وعاش قضيته التي آمن بها حتى النهاية، ومات حيث قاتل ومات شعبه. وإذ بيوم اغتياله يغدو “تراجيديا” جديدة لشخصية تاريخية أخرى في هذا العالم ماتت من أجل مبادئها، بغض النظر إن كان على حق أم لا.
بدا متعباً أمام عدسة المسيّرة في لحظاته الأخيرة، ولم تسعفه عصاه، بعد 62 عاماً من العمر الذي أمضى نصفه تقريباً سجيناً، والنصف الآخر عالقاً بين الشوك والقرنفل، يبحث عن الحب الوحيد إلى حد المقامرة والجنون.
لكنه في نهاية الطريق سقط على أرض أحبّها… ونترك للتاريخ أن يقول كلمته يوماً ما، إن كان أخطأ في عقله البوليسي الخطير أم في قلبه الذي علق في حبٍّ وحيد.