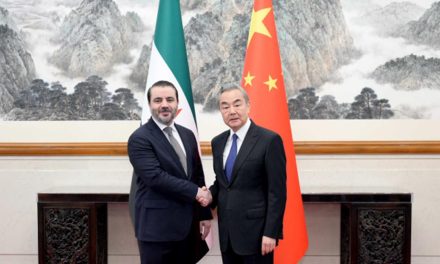مسقط رأس حنظلة.. عين الحلوة جمهورية على شكل سجن

نادر حجاز كاتب وصحافي لبناني
من عين مياهٍ عذبةٍ حُلوةٍ، رَوَت عطشَ الهاربينَ من بطش وإجرام عصابات “الهاغاناه”، إلى كيلومترٍ مربّعٍ واحدٍ من القهر والعمر المرّ، إذ تحوّل إلى عاصمة لا دولة لها، عاصمة للمشرّدين في الشتات. كيلومتر مربع واحد احتوى وجع سبعة عقود ونيّف من جرح أرض خلعوا عنها كل أسمائها، لكنّها بقيت تُدعى فلسطين وحارسها “حنظلة”، أظهر وجهه لها فقط..أهلاً بكم في مخيّم عين الحلوة.
حكاية أبناء عين الحلوةِ بدأت على أرض الجليل في شمال فلسطين. هناك كان الفلسطينيون القرويون يعيشون حياتهم البسيطة الآمنة، فلاحون ومزارعون في ضياعهم، التي رُسم لها أبشع الأقدار، بتوقيع رئيس وزراء بريطانيا آرثر جيمس بلفور، الذي أهدى الحركة الصهيونية، من حساب غيره، وطنًا قوميًا لليهود بلا رصيد، وشرّع أكبر سرقة وأبشع مذبحة.

غادر أبناء الأرض قراهم في عمقا وصفورية وشعب وطيطبا ولوبيا والمنشية، والسميرية، والنهر والصفصاف وحطين، والرأس الأحمر، والطيرة وترشيحا، والزيب، وعكبرة وغوير أبو شوشة ونمرين وسعسع والسموعي في شمال فلسطين، ولجأوا إلى خيمة في الجنوب الشرقي لمدينة صيدا اللبنانية. ظنّوا أن إقامتهم ستكون مؤقّتة على بعد 67 كيلومترًا فقط من حدود بلدهم، لكن خيامهم اهترأت بعد ثلاث سنوات من وصولهم إلى تلك الأرض التي استأجرتها الدولة اللبنانیة من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام 1948، وأصبحت وطنًا مع وقف التنفيذ، وبدأت رحلة الإسمنت المصبوب فوق حلم عودة لم يعرف فجره بعد.
خبّأ المهجّرون مفاتيح بيوتهم، التي أُزيلت من الوجود بشكل كامل، واستُبدلت بمستوطنات على أنقاض أحلامهم ومنازلهم وبساتينهم وأشجار اللوز والليمون والرمّان والزيتون. فصفورية أصبحت “تسيبوري”، والرأس الأحمر أصبحت “كيرم بن زمرا”، وترشيحا أصبحت “معالوت ترشيحا”، وغوير أبو شوشة أصبحت “ليفنيم”، ونمرين أصبحت “أحوزت نفتالي”، والزيب أصبحت “غيشر هزيف”. وعلى هذا المنوال سُرقت كامل فلسطين والعرض مستمر.
“عملية ديكل”
لم يبع أبناء عين الحلوة أرضهم، كما أشاعت الدعاية الصهيونية، إنما هُجّروا غصبًا وإكراهًا، وعُرفت عملية احتلال الجليل الأسفل بـ”عملية ديكل”، في صيف 1948، وهدفت إلى الاستيلاء على كل القرى التي تقع جنوبي وشمالي تلال الجليل الغربي، والتي هُجِّر سكانها بالكامل ودُمِّرت تدميرًا تامًا، ولم يبق منها اليوم سوى شواهد بسيطة من بقايا مساجد وبعض الأطلال التي لا تزال تؤكد أنه في يوم من الأيام كان لهذه الأرض أصحابها الملّاكين قبل أن يصيروا لاجئين.
“عملية ديكل”، وتعني بالعربية عملية شجرة النخيل، كانت أكبر هجوم شنّته القوات الإسرائيلية، والتي كانت حينها متنقلة تنشر الذعر والخوف، على شمال فلسطين بعد الهدنة الأولى للحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948، وفي 15 تموز/ يوليو، قصفت الطائرات الإسرائيلية قرية صفورية وأثارت الذعر بين السكان وفرّ كثير من القرويين إلى الشمال نحو لبنان، ووجد آخرون مأوى في الناصرة، تاركين وراءهم نحو 100 من المسنين.
وفي مساء يوم 16 تموز/يوليو، استسلمت الناصرة إلى الإسرائيليين على إثر قتال خفيف أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد وجرح آخر. وانسحبت قوات جيش الإنقاذ العربي من البلدة بقيادة فوزي القاوقجي باتجاه الجبال في الشمال، الذي قاتل بشجاعة في أكثر من موقع في محاولة لاسترداد فلسطين، فقد كان المقاتلون العرب يجاهدون بكل إخلاص فيما القرار الأكبر في غير مكان.

بقيت أسماؤهم
لا يزال ينتمي سكّان مخيم عين الحلوة إلى قراهم الـ36 في شمال فلسطين، فأعطوا أسماء هذه القرى والمدن الفلسطينية إلى الأحياء التي سكنوها في المخيم، ولا زالت حتى اليوم، حتى أن ترتيبها بقي تباعًا كما كانت في فلسطين وكأنها رافقت هجرتهم وانتقلت معهم على شكل مصغّر إلى المخيم.
وحتى الروابط العائلية الموجودة في المخيم تحمل أسماء القرى التي هُجّرت منها العائلات، كرابطة أهالي عمقا أو رابطة أهالي بلدة عرب زبيد ورابطة أهالي بلدة الرأس الأحمر وسواها.
ويتوزّع المخيم اليوم على عدد من الأقسام الأساسية هي: منطقة التعمير، حي الطوارئ، حي السكة، البركسات، بستان اليهودي، جبل الحليب، حي الصحون، أوزو، فضو واكيم وبستان أبو جميل.
قبلة اللاجئين
دفع اللاجئون، وما زالوا، الفاتورة الأغلى منذ تركوا أرضهم، وتحوّلوا إلى مصدر قلق لم يكونوا سببًا فيه. مطارَدون في كل زمانٍ ومكانٍ، في أرضهم كما في أرض اللجوء. ودائماً هناك تهمة جاهزة “غبّ الطلب”. فلاحَقَهم هاجس التوطين منذ وطأت أقدامهم لبنان، ليُحرَموا من حق العمل في أكثر من 70 مهنة ويعامَلوا وكأنهم درجة ثانية… وربما عاشرة.
كبر وجع الشتات على وقع المأساة الفلسطينية المستمرّة. وتحوّل مخيم عين الحلوة إلى وجهة أساسية للاجئين الفلسطينيين على مدى العقود الماضية. فبعد النكبة، شهد موجة لجوء ثانية في العام 1967 على اثر حرب النكسة، وبعدها إبان الحرب الأهلية اللبنانية وما شهدته من اجتياح إسرائيلي وتدمير لمخيم تل الزعتر والنبطية ولاحقًا أحداث نهر البارد في العام 2007، ليُصبح المخيم الأكبر في لبنان من حيث عدد السكان والمساحة، ويستحق لقب “عاصمة الشتات”، أو حتى “ميني فلسطين”.
وجاءت الحرب السورية والنزوح الكبير بعد العام 2011، والتدمير شبه الكامل لمخيم اليرموك وسواه في سوريا، لتجعل عين الحلوة القبلة الأولى مجدداً لآلاف النازحين السوريين. وقد بلغ عدد سكان المخيم وفق آخر إحصاءات في العام 2017 حوالى 130 ألف نسمة.
ليس بالخبز وحده
لا يتمتع سكان عين الحلوة، كما باقي المخيمات في لبنان، بأيّ حقوق مدنية واجتماعية. يعيشون في ظروف معيشية صعبة جدًا، وفي بيوت فقيرة تتكدّس في أزقة مزدحمة، ترقى إلى مستوى البؤس الإجتماعي. فهو أشبه بحزام بؤس وحرمان وعوز وفقر وبطالة.
رغم ذلك، وبعد سبع عقود على النكبة، مخيم عين الحلوة هو صورة مصغّرة عن الواقع الفلسطيني العام. احتضن منظمة التحرير الفلسطينية والفدائيين منذ انطلاقة العمل الفدائي، فصورة ياسر عرفات “أبو عمّار” تلاقيك بكوفيته عند المدخل، وفي كل زاروب وحي حتى اليوم. ورغم الظروف الاقتصادية القاسية، يبقى للقضية مكانها بكل رموزها كما للسياسة. ففي المخيم مقرّ لكل الفصائل الفلسطينية من دون استثناء، “فتح” و”حماس” و”كتائب القسام” و”الجهاد الإسلامي” وغيرها.. في رسالة واضحة بأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.
فاعتبارًا من العام 1969، أي بعد اتفاق القاهرة الشهير، أصبح عين الحلوة واحدًا من المواقع الرئيسية للنضال الفلسطيني في لبنان. وهو الدور الذي سيؤدي إلى تدمير المخيم ومحيطه خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 انتقاماً لاحتضانه المقاومة الفلسطينية وقادتها ورموزها. فعادت كل صور التهجير والتدمير التي ارتكبت بحق الأهل في الأربعينات، لتلاحق الأبناء بكل بشاعتها.
صمود لأسبوعين
قصة صمود لا بدّ من التوقّف عندها. فدُخول الجيش الإسرائيلي إلى المخيم لم يكن نزهة سهلة، بعدما أثبت مقاومةً كبيرة استمرت لمدة أسبوعين. وتنقل مؤسّسة الدراسات الفلسطينية مقابلة أجرتها صحيفة “هآرتس” العبرية مع أحد ضباط العدو الإسرائيلي الذين شاركوا في معركة عين الحلوة ويدعى النقيب إيلي ليفي، تحدث فيها عن صمود المقاتلين في المخيم.
وفيها يقول: “إن عدد المقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا داخل عين الحلوة يقل كثيرًا عن عدد الذين كانوا داخل صيدا نفسها، وعلى الرغم من ذلك فالمقاتلون الفلسطينيون في عين الحلوة قاوموا بعنف وشراسة حقيقية.. أريد أن أقول بأن رجال عين الحلوة أثبتوا شجاعة نادرة ثًا، فكل فلسطيني في هذا المخيم قاتل حتى الموت فعلاً. أتعرف ماذا يعني ذلك، إنه يعني بأن معارك انتحارية حقيقية قد دارت هناك. بحيث إن الكثيرين منهم لم يبقوا على قيد الحياة وأعتقد بأن الذين وقعوا في أسر قُواتنا لا يتجاوزون العشرين مقاتلًا وجميعهم كانوا من الجرحى إذ لم نأسر مقاتلاً فلسطينيًا واحدً في عين الحلوة لم يكن جريُذً
فوضى و”خلطة عجيبة”
الانخراط بالجو الفلسطيني العام، جعل المخيم ساحة للعديد من الأحداث وكان بعضها داميًا، لا سيما بين عامي 1982 و1991، والتي خلّفت دمارًا هائلاً، إذك كانت تتحكّم الفوضى بيوميات المخيم، سلاح بأيدي الجميع، وجولات اشتباكات متكررة بعناوين فضفاضة، وأكبر بكثير من هموم أبناء المخيم.
وفي “خلطة عجيبة”، تختلط في عين الحلوة الأيديولوجيا بالأفكار القومية والوطنية بالتوجهات الدينية وبعضها المتطرف. وأما الكباش فمستمر على حكم الأرض، والحكم للأقوى ولو على شارع أو حي.
هو أشبه بجمهورية غير مستقلة، تحكمها الأعراف والفتاوى والرشاشات وحروب الآخرين على أرضها. ووسط كل ذلك تنمو أسوأ آفات المجتمعات، وهنا حدّث ولا حرج، والواقع أصعب من أن تتمكن بعض مدارس للأونروا على معالجته ونقله من حال كارثي إلى حال أفضل.
فالقلق الأمني هو هاجس الناس هناك، شاؤوا أم أبوا، وبدلاً من بعض رفاهية مفقودة، تأتي الأحداث الأمنية التي تتكرّر في المخيم، لتستدعي إجراءات مشددة من الجيش اللبناني في محيطه وعلى مداخله، وترخي بظلالها بشكل سلبي جداً على سكانه، ما ينعكس كثيراً على الحركة الاقتصادية، ما يفاقم تداعيات الوضع المعيشي عليهم.

تمدّد عمودي
منذ تأسيسه في العام 1949، لم تتغيّر مساحة مخيم عين الحلوة، في حين تضاعف عدد سكانه عشرات المرات، بعدما كانوا 15 ألفاً فقط. وأمام هذه المعادلة الخانقة، يضيق المخيم بالقاطنين فيه، وليس في الكلام مبالغة أن بعض أحيائه تبدو مظلمة في عزّ النهار. فالأبنية تتمدّد عموديًا وبشكل متلاصق ومزدحم، وتكاد لا تتسّع بعض الأزقة لأكثر من شخص.
كثافةٌ سكانيةٌ متزامنةٌ، مع بؤسٍ وفقر وغيابٍ أبسط الخدمات ومقومات الحياة وانتشار البطالة، تتحوّل الى بيئة ولّادة للعنف والتأثر بالتطرف والجريمة والرذيلة وأعمال السوء. وهذه نتيجة حتمية، وأكثر من طبيعية، وتهدّد بالأسوأ طالما المخيم يختنق بأهله ولا حلول تنظر ببعد رؤيوي لمستقبله والمطلوب لإنقاذ سكانه على كافة المستويات في الصحة والتعليم والمسكن والبنى التحتية والمشاريع الاقتصادية وفرص العمل.
فالقهر أكبر من طاقة شعب على تحمّله في تلك البقعة المنسيّة. والصور الخارجة من هناك لا تشبه القرن الواحد والعشرين وزمن التنمية الذي تشهده البشرية. لكن العالم ينتهي عند أسوار عين الحلوة، ويصبح للشروق والغروب طقوسه الخاصة.
هناك خسر الناس ماضيهم وحاضرهم، وربما مستقبلهم، فلا المكان يتسّع لهم ولا مكان آخر مستعد لاستقبالهم. هم أبناء القدر المحتوم ليس إلا، يشترون منذ 7 عقود عروض الأمل المفقود، وبدلاً من الوطن المنشود، ها هم اليوم بكل وقاحة يبحثون عن أوطان بديلة لهم ولمَن جاء وسيأتي من بعدهم.
بحث عن أمل
يدفع المواطن المقيم في مخيم عين الحلوة الثمن الأكبر، فهو محكوم بالواقع الصعب الذي يعيشه. شريحة شبابية كبيرة أصبحت من حملة الشهادات، لكنها لم تستفد منها، فقوانين العمل اللبنانية لا تسمح لهؤلاء بالعمل أسوة باللبنانيين، وسوق العمل مقفلة في وجههم. يبحث هؤلاء عن أمل، إما بإيجاد متنفس داخل المخيم وجوار، من خلال خلق بيئة جديدة مبدعة عبر الفن والفولكلور والموسيقى أو المشاريع الصغيرة كالمقاهي وغيرها من الأفكار، أو للأسف بحثُا عن هجرة إلى أي مكان آخر، حتى ولو عبر البحر. وإلى ذلك الحين، اعتاد أبناء المخيم على نمط حياتهم ولو قسرًًا انتظار غد أفضل يوماً ما.
صقيع الشتات
لا دفء خارج البيت والوطن، وحده الصقيع في الشتات، يُلاحق أهل الأرض المهجّرين من جيل إلى جيل، يصبح الإرث الوحيد على وصية الأجداد والأبناء وربما الأحفاد. الحرارة الوحيدة في جَيب مسنّ، بقي حتى آخر لحظة من حياته يتلمّس مفتاحاً بلا باب وقفل، هو مفتاح لحلم ليس إلا.
ففي يوميات مخيم الشتات، تصبح الهموم كبيرةًا جدًا رغم بساطتها. فالخبز مشروط كما الدواء والماء والعمل والراتب الشهري، كما القصيدة والغناء والفرح. تصبح المحرّمات قوتاً يومياً، والإنسان فعل ناقص خارج المكان والزمان.
ففي المخيّم تعلو الأسوار بلا جدران، ويغدو كسجن كبير بلا قضبان وزنازين بلا أبواب، والسجّان شبحٌ غير مئٍ، برتبة دول وجمعيات وسفارات ومنظمات وهيئات أممية، وما على السجين سوى شكر سجّانه على وجبته الصباحية وساعات المشي تحت الشمس ومواعيد الزيارات الخاطفة.
“مجلة ميغازين”