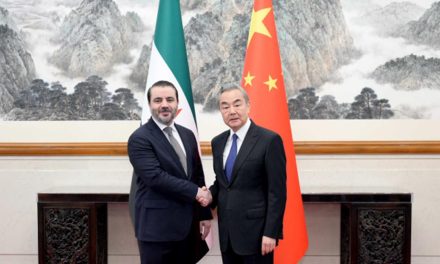وائل ياسين يستعيد جراح العائلة في ليلة سقوط الأسد

كتب وائل خليل ياسين رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والتنمية
لم تكن ليلة سقوط نظام الأسد مجرّد خبر انتظرناه، بل كانت بوّابة واسعة انفتحت على ذاكرة مثقلة بثلاثة عقود من الألم. جلست أمام الشاشة اراقب المشهد بدمعةٍ سالت وحدها، تجرّ خلفها سلسلة صورٍ لم تغادرني يوماً، وكأنّ الزمن يعود بي إلى العام 1986؛ إلى تلك الليلة التي داهمت فيها قوات الأسد منزل جدّي ومنازل العشرات من بلدتي، يوم اختُطف الشباب لمجرّد أنهم آمنوا بالقضية الفلسطينية ووقفوا مع المقاومة… في زمن كان فيه الخلاف بين حافظ الأسد وأبو عمار يفتح أبواب الجحيم على الأبرياء.
كنت يومها طفلاً لم يتجاوز السابعة، لكن ذاكرتي ما زالت تحتفظ بكل التفاصيل: الأبواب المخلّعة، الصراخ، العيون المذعورة، والجنود الذين اقتحموا طفولتي قبل أن يقتحموا البيوت.
لم يتوقف شريط الذكريات عند ذلك العام. أخذتني ذاكرتي إلى 1987، إلى يومٍ جرّني وانا طفل ضابط أسدي إلى مواجهة غير متكافئة، فقط لأنني رفعت العلم اللبناني على سطح منزلي. أجبته بفطرتي الطفولية: “هذا علم بلادي”. أمّا الضابط فقرأها موقفاً سياسياً، وأحالها إلى أجهزة المخابرات… وكانت تلك من أوائل اللحظات التي شعرت فيها بأن الهوية قد تصبح تهمة، وأن الوطنية قد تتحوّل إلى طريق نحو الاعتقال.
ثم جاء مشهد لا يمحوه الزمن: زيارة سجن المزة. ذلك المكان الذي دخلته العائلة من أجل لقاء الخال المعتقل… الشهيد لاحقاً تحت التعذيب. خمسة كيلومترات سيراً على الأقدام لثوانٍ من اللقاء، ثوانٍ شاهَدت فيها خالي يُضرَب أمام العيون، في مشهد ترسّخ فيه معنى الظلم إلى الأبد.
وفي تلك الليلة الطويلة من عام 2024، استعدت، أيضاً كيف بقي والدي مطارداً بين الأقبية والمكاتب الأمنية، تُوجَّه إليه تهم من نوع “عدم التنسيق” و”عدم كتابة التقارير”… تهم تكشف وحشية المرحلة أكثر مما تكشف ذنباً. وكيف حورب والدي في عمله العام لأنه لم “يصعد البوسطة الأسدية”، ولأنه رفض منصباً وزارياً عُرض عليه في شتورا، ودفع ثمن رفضه مضاعفاً.
وتوالت الصور:
ضباط المخابرات الذين كانوا يدخلون إلى محلات العائلة لابتزازها، يأخذون ما يريدون دون أن يدفعوا شيئاً، والطفل الذي في داخلي لازال يصرّ على مواجهة أحدهم دون أن يعرف من يكون. وصادف أن الزمن كان أسرع من انتقامهم… فرحلوا مع خروج الجيش السوري بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ثم جاءت الزيارة الشهيرة للعميد علي دياب في عزاء جدتي، حين قال أمام الجميع إن الحريري “متآمر”، وإن من يتعامل معه “متآمر مثله”. كلمات بدت يومها تهديداً… ثم أكدتها الأيام حين تلتها عملية الاغتيال التي هزّت لبنان.
وما زال الشريط يمتد… إلى يوم حاول أحد رجال رستم غزالة تهديد والدي ومنعه من المشاركة في جنازة الحريري، وإلى لحظة إطلاق النار عليّ عند مفرق المرج بسبب انخراطي في الدعوات الشعبية لطرد النظام من لبنان، وهو ما دفع الأمن اللبناني إلى مطالبتحياتهي بلزوم المنزل لحماية حياتي.
كل تلك الأحداث، ليست إلا “القليل القليل”، أمام ما عاشه آخرون فقدوا أبناءهم، أو شهدوا انتهاكاً لكرامة عائلاتهم تحت سطوة أجهزةٍ لا تعرف حدوداً.
بعد هذا السرد التاريخي لحادثة شخصية نعود إلى الحاضر، إلى ليلة السقوط، إلى اللحظة التي شعرت فيها بأن دائرة الألم التي عاشتها عائلتي طويلاً بدأت تُقفل أخيراً.
أهنّئ والدي بنهاية الحكم الذي طارده عمره كلّه، وأطلب الرحمة لخالي الشهيد محمود عبد الرؤوف المجذوب، الذي قضى في سجون التعذيب لأنه كان مقاوماً صادقاً، لم يخطئ بوصلته يوماً، وبقي على طريق فلسطين حتى النهاية، وفي الختام نقول لن ندع المكوعين يجثمون فوق صدورنا ليكتبوا التاريخ، لان التاريخ هذه المرة سيكتبه الانقياء لا الملوثون بدماء الابرياء.