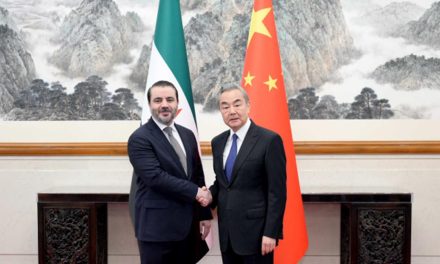لبنان للمسيحيين فقط!

مسيحيو لبنان تنتابهم مشاعر صادقة وعميقة بالانتماء إلى لبنان متخيل، يحاولونه واقعاً وحقيقة. هو وطنهم الوحيد والأخير. هو الهوية الصافية التي لا تخالطها هويات أخرى. هو “الملجأ” الأخير. هو الكيان الذي سعوا إلى ولادته مستقلاً، منفصلاً عن ذاك الجسم “الامبراطوري” الهلامي، ومتمنعاً عن الذوبان في ذاك الامتداد غير المحدد ما بين بلاد “العروبة” المتشرذمة وعوالم الإسلام المتلاطمة.
ذاك التوق للشعور بالطمأنينة والاستقرار واستقلال الذات وثباتها “شعباً” وأرضاً وحدوداً منيعة وراسخة، هو قرين التمايز والحرية وحق تقرير المصير، كجماعة متوحدة بنفسها وبكيانها وبثقافتها. وكان السعي إلى ذلك يتطور من فكرة الخصوصية الدينية وصون وجود الكنيسة ورعاياها وضمان حرية ممارسة الطقوس.. إلى فكرة القومية المتمايزة تاريخاً وأرضاً ومصيراً.
ومن زمن الإمارة المعنية إلى الإمارة الشهابية فالقائمقامتين وصولاً إلى حقبة “المتصرفية”، أي على امتداد أكثر من ثلاثة قرون، اختبر مسيحيو جبل لبنان، بأكثريتهم المارونية، ويلات ومصاعب ونكبات فيما هم يحاولون الاستحواذ على جغرافيا مكتملة كأرض قومية خاصة بهم. لكن تداخل سكنهم وإقامتهم مع الجماعات الأخرى، دروزاً وسنّة وأرثوذكساً وشيعة، حال دون اكتمال فوزهم وانفرادهم بأرض مستقلة. وهذا ما دفعهم إلى الاقتراب من استيعاب هذا الواقع، والتحول نحو صيغة “وطن” متعدد “الأقليات” لهم فيه نسبة وازنة وغالبة إلى حد ما.
وكانت تجربة المجاعة التي أصابت “جبل لبنان” في أثناء الحرب العالمية الأولى، حافزاً لإعادة النظر في تلك الجغرافيا المشتهاة، التي تفرض مرة أخرى استيعاباً أكبر لسكان متعددي الطوائف والأديان، شمالاً وجنوباً وشرقاً إضافة إلى ولاية بيروت ساحلاً.
وفي وقت مبكر، عند استحقاق “مؤتمر فرساي”، الذي كان يتداول في مصير شعوب الامبراطوريات الآفلة والمهزومة، حسمت الجماعة المارونية خيارها ما بين أن يكون لبنان “وطناً قومياً لمسيحيي الشرق” أو “وطناً لجميع أبنائه”. وكان الخيار الثاني، وفيه من الضمانات ما يجعله أيضاً ملجأ للأقليات وللمضطهدين، واللاجئين إليه من إثنيات ومذاهب متفرقة (سريان، وأرمن، وأشوريين، وكلدان، وبروتستانت، وشهود يهوه، وبهائيين وعلويين واسماعيليين وشيعة ويهود ..إلخ)، بوصفه بلد الحريات الذي يعترف بخصوصيات الطوائف وهوياتها، ويعتنق المساواة والعدالة وسيادة القوانين، ويتبنى مفهوم “الدولة الوطنية” الحديث، وفق النموذج الذي يسود الغرب.
وإذا كان هذا كله هو إنجاز تاريخي للمسيحيين، إلا أنه كان مستحيلاً في الطور الأول لولا “الشراكة” التامة مع الدروز، ومستعصياً في الطور الثاني لولا الموافقة والشراكة الكاملة مع الطائفتين الكبيرتين الأرثوذكسية والسنّية، وناقصاً لولا انضمام “بلاد المتوالة” (البقاع الشمالي وجنوب لبنان). وبهذا، ارتضى مسيحيو الجبل والشمال ثمن الديموغرافيا مقابل مكسب الجغرافيا. وهذا التوسع الذي سيكون “لبنان الكبير” لم يكن اعتباطاً أو اختراعاً واصطناعاً، فله إلى هذا الحد أو ذاك مبررات تاريخية وثقافية، وأسباب في إسباغ الهوية اللبنانية على أرجائه الجديدة، خصوصاً أن تلك المناطق المضمومة إلى “لبنان” لم تخلُ من توزع مسيحي ماروني – كاثوليكي في البقاع وفي الجنوب وصولاً إلى عكار وطرابلس.
لبنان هذا، مسيحي بامتياز كمشروع سياسي. لكن مضمون هذا المشروع وشرط بقائه واستمراره أنه “وطن لجميع أبنائه”.
المعضلة أن لبنان المتخيل الذي يعتنقه شطر كبير من ورثة
“المارونية السياسية” ثابت وسرمدي وأزلي، بمواصفات لا يدنوها تغير ولا
يصيبها تحول. فإذا زادت أعداد الشيعة مثلاً يصبح هذا الـ”لبنان” غريباً
ومرفوضاً ولا يُطاق. وإذا نقصت صلاحيات الرئيس الماروني وجب اليأس والهجرة
والشعور بالاضطهاد، وإذا تم تجنيس أولاد أمهات لبنانيات متزوجات من عرب
مسلمين، حلت كارثة وجودية. وإذا دخل موظفون مسلمون من الدرجة العاشرة إلى
دوائر الدولة، ولم نجد ما يماثلهم عدداً من المسيحيين، فمن الأفضل إلغاء
هذه الوظائف من الأساس حتى ولو تعطل عمل الدوائر والخدمة العامة. هناك
أمثلة لا تُعد ولا تحصى على هذا المنوال. بالطبع، لا ننحو إلى التبسيط أو
الاستخفاف في مسائل “التوازن” و”المناصفة” والشعور بالعدالة (الشعور
بالعدالة أهم من حرفيتها) والطمأنينة. وبالطبع لا نميل إلى تكرار ما لم يعد
مفيداً من أن تنفيذ “الطائف” على الوجه الصحيح هو الحل..
لكن، في كل
الأحوال، حان الوقت للاقتناع أن هذا الـ”لبنان” السرمدي، هو كأي وطن على
وجه الأرض، ومثل كل معطى طبيعي، متحول ومتغير. الثبات هو الموت.
هذا أصل الأزمة التي تتعمق يوماً بعد يوم. أزمة ليس لأحد أن يتولاها سوى المسيحيين أنفسهم. مناط بهم أن يخرجوا من انفعالات تأخذ شكل الخوف والهجرة في أحسن الحالات، وتتحول إلى نعرة طائفية في أكثر الحالات، وتصير عنصرية سافرة في حالات مستشرية راهناً. هذه انفعالات، وحتى لو افترضنا جدلاً أنها مشروعة ومفهومة، فلن تكون أبداً حلاً. لا يمكن العيش بانفعال أبدي.
لبنان ما قبل 1975، مات منذ زمن بعيد ببالغ الحسرة. ولبنان 1990- 2005، تجاوزناه بكثير من المرارات والخيبات والمهانات. ولبنان 2005 – 2019، شارف على الانتهاء بفشل “السيادة والحرية والاستقلال”.
وإذا كان لبنان للمسيحيين أولاً، فماذا هم فاعلون الآن؟
يوسف بزي/ المدن