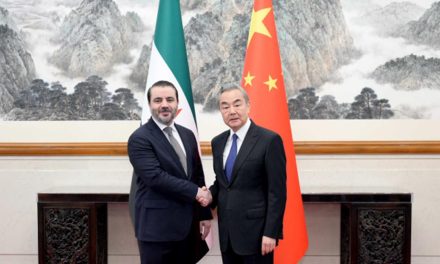الرد على النظام اللبناني- السوري: الحق في معارضتَين

لم تتلعثم الأنظمة الاستبدادية والإيديولوجية في إنذارها معارضيها
والمتمردين أو الخارجين عليها بالويل والبلاء إذا اضطرت إلى ترك الحكم
عنوة. فغوبلز- وزير الدعاية النازي والهتلري المفوّه، وخطيب تظاهرات الحزب
القومي والاشتراكي (“الاجتماعي” في ترجمة معاصرة يومها) الألماني، ولسان
فوهرر رايخ الألف عام أو القائد المرشد- نبّه إلى أن سقوط الحزب وفوهرره
يعني دمار ألمانيا: “إذا اضطررنا للمغادرة فسنصفّق الباب وراءنا”، كناية عن
الخراب الموعود. وكان هذا جوابه عن محاولات المعارضات الألمانية التكتل
والتآمر على حياة الزعيم.
ولما ظهر أن نقابة التضامن البولندية، في 1980، تلم حولها صفوف
العمال والمواطنين، وتبعث في صفوفهم الإحساس بالكرامة والتماسك، والاستقلال
عن الاستتباع الروسي السوفياتي، لوّح قادة الحزب الشيوعي المتسلّط بطيف
الحرب الأهلية، وحذّروا البولنديين من القيام على الشرطة الحزبية (شَبَه
الباسيج في “الجمهورية الإسلامية”)، ومضايقتها وإيذاء أهالي الشرطيين. وهذا
ما لم تظهر بوادره يومذاك، ولم ينوِ أحد فعله، وحين هوى النظام الشيوعي،
وخسر استقواءه بـ “أجهزة القوة”، على قول سوفياتي ثم روسي عتيد، لم يعتد
أحد على أشرس الشيوعيين حين وسعتهم الشراسة وهم في سدة السلطة.
وأخيراً وليس آخراً، لم تكد دعوة غورباتشيف، آخر أمناء الحزب الشيوعي السوفياتي الحاكم، إلى حسر اللثام عن نكبات الشيوعية الستالينية وخالفها الخروتشوفي والبريجنيفي، تعمّ بعض الشيء، وتدعو الرعايا إلى الإعراب عن أحوالهم، حتى حُملت الدعوة على الحض على الاقتتال، والنفخ في الفتنة، وإشاعة الفوضى، والعمل على تدمير “الإنسان الأحمر” ودولته وخدمة الإمبريالية الأميركية والغرب النيوليبرالي…
فالفوضى، الناجمة عن الحرب الأهلية وانقسام القوات المسلحة، هي الاسم الذي يطلقه أهل النظام (الأنظمة الديكتاتورية كلها… يعني كلها!) على ما ينبغي أن يكون مرحلة انتقالية تعقب التاريخ الطويل من الإخفاقات والجرائم والسقطات التي لم يفلح أهل الأنظمة الاستبدادية في تجنبها، وأمعنوا في ارتكابها، وهددوا بالفوضى جزاء تنحيتهم أو حتى تقييد سلطانهم الاسمنتي وموازنته بمراقبته ومعارضته وتقسيمه وإنشاء أجسام وسيطة. ومِحَنُ “المرحلة الانتقالية” السورية التي نص عليها القرار الأممي 2254، 2012، قرينة حديثة وعربية وقريبة على استعصاء خلافة أنظمة الطغيان، بالغاً ما بلغ تواضع الإجراءات التي يقترحها المتضررون من هذه الأنظمة. فهذا “الأمر”، السلطة، يحسب المستولون عليها على الدوام أنه “فيهم (في ملكهم) إلى ألف عام”، على قول أبو العباس السفاح، الخليفة العباسي الأول، في خطبته الأولى أهلَ الكوفة. وبين رايخ الألف عام الألماني الهتلري وبين ألف عام العباسي الأول حبل غليظ يجدله الجمع بين شهوة السلطان وبين فكرة الخلاص الأخير والوشيك عن يد السلطان المستولي.
الدولة الواحدة
ولعل أشد ما يستفز أولي الأمر (اللبناني)، أصحاب الدولة والرئاسة والحضرة والسعادة والسماحة…، في الحركة المدنية العريضة المولودة ببيروت أولاً في 17 تشرين الأول (أوكتوبر) هو قيامها خارج دائرة السلطة، وقسمتها الدولة والمجتمع اللبنانيين شطرين: شطر “الطبقة” الحاكمة، وهي “كلهم” المكررة، وشطر المحكومين، المنقادين إلى طبقة الحكام والمنصاعين صاغرين إليها. والدولة “الواحدة”، على معنى الأنظمة الديكتاتورية والبوليسية و… الأهلية (في إضافة “عربية”)، تنفي المعارضة وجوازها أصلاً. فطبقة الدولة الواحدة قسراً (دولة الحزب الواحد، ودولة “الجبهة الوطنية” الواحدة، ودولة قيادة التحرير ومقاومة الاستكبار المجسّدة وحدة الشعب…) تفترض أنها واحد والشعب (العامل أو الشريف أو الحر). وهي واحد والمجتمع وقواه. فلا محل للخلاف ولا “للتناقض” بين قوى الشعب، أو فئات المجتمع، إلا إذا تناول الخلاف، وليس التناقض، المتحدّر من العدو ومبيِّت التآمر، مسائل ثانوية. وهذه تحلّ بإقامة دعاوى على الفاسدين سنداً إلى قوانين بعضها ينام في مكتب رئاسة المجلس النيابي وبعضها أُقر ولم يُنشر، على ما يدعو ويكرر خبراء المنار وإن بي إن على شاشات التمويل الذاتي.
وعملاً بنفي جواز الخلاف بين جماعات الشعب وبوحدة الجماعات المرصوصة حول برنامجها الخلاصي وقيادة البرنامج و “مقاومته”، اجترحت وأوجبت قيادة “النظام اللبناني- السوري”، على ما سمّيت البنية التي لحمت بين ألوية الاستخبارات السورية وبين مواليها المحليين، ركنين متصلين ومتضايفين نهضت عليهما سياسة اللبنانيين: لا تجوز معارضة في نظام وطني وبالأحرى قومي مقاوم، ولا يجوز أن تمتنع من الشراكة في الحكم الظاهر، وتحت عباءة “الرعاية” القومية وقانون توزيعها المغانم، جماعة من الجماعات الوازنة التي قد تنقلب إلى الشارع وتمثل بعض مقوّماته.
وعلى هذا، تعاقبت إلى اليوم وزارات الثلاثين وزيراً، لا تنقص وقد تزيد، ومجالس نواب الـ 128 نائباً، عوض الـ108، التي “أصلح” بها الصديق المنسّق والمتعاون السوري مؤسسات الدولة الخربة. والوزارات والمجالس النيابية والرئاسات لا تُقحم نفسها في الشؤون السيادية. فالحرب والسلم، والأحلاف والصداقات، وعلاقات الجماعات بعضها ببعض، والسياسات العامة (المالية والتربوية والاستثمارية…) يبتها الوكلاء المحليون بعد استشارة “صاحب” السيادة، وفي ضوء مصالح استراتيجية “المقاومة”.
المعارضة “الممنوعة” وامتثلت سياسة اللبنانيين إلى الركنين اللذين أرساهما السيِّد السوري، وتعهّدهما السيد الذي يخلفه. وحمت “فوّهة البندقية”، على ما ينبغي في الأنظمة الديكتاتورية والمقاومة، وثيقة “العمل الوطني” بالقوة الشرعية، وليس المشروعة فحسب. وتنتهك الحركة المدنية والوطنية (“القطرية”)، وهي تسمي نفسها “ثورة” على سبيل الرطانة الببغائية السائدة، الركنين وموجباتهما. ولا ينجم الانتهاك عن برنامج، والحركة الكثيرة على قدر كثرة أصحابها لا “تملك” برنامجاً على ما هو مشهور، ولا تعلنه قيادة. واستغناء الحركة عن قيادة “عيب” فاضح يعيبه عليها المتربّعون في سدات الحل والعقد المقاومين أو وكلاؤهم المأذونون. فقيامها ودوامها على صورتها العامية و”المهلهلة” (من الزير بو ليلى المهلهل: هلهل الشعر وقرَّبه من أفهام الناس!) ينقض أركان النظام اللبناني- السوري، كما صوره السيد الرئيس، ويمضي على تصويره من يقوم مقامه.
والحق أن هذا هو الإنجاز الكبير الذي يُحسب للحركة المدنية والوطنية، وليس ذاك الذي يزعمه الزعماء، أي حمل الحكم على إجراءات معلقة ومشكّلة. والإصلاح من غير معارضة قوية وعلنية وهمٌ وسراب. وقد ينبغي إرساء الاتجاه على سنن ثابتة وانتظار ثمراته المرجأة على الأرجح. ويُحسن بالحركة المدنية والوطنية دعوة “اصدقائها” في الوزارة إلى الاستقالة، والتخلي عن “الوحدة الوطنية” الكاذبة والمزوّرة التي يقتضيها استبداد الآمر المتخفّي بمقاليد السلطة وتوزيع حصصها وعوائدها. ويترتب على الاستقالة هذه أمران: انفراد أهل الوحدة الصورية والكاذبة بالحكم، وقيامهم جهاراً بالمسؤولية عن قرارات يفرضونها على اللبنانيين عموماً وعلى “شركائهم” الذين يتسترون بهم ويُعمّون على المحاسبة العامة. ومن مزاعمهم الرائجة انه في وسعهم حكم “بلد أكبر من لبنان مئة مرة”، ويقصدون بالحكم التخوين والردع والإكراه والتواطؤ.
والأمر الثاني هو قيام معارضتين: واحدة مدنية ووطنية، ينبغي توسيعها إلى الأجسام الإدارية والقضائية والنقابية، والثانية برلمانية نيابية، تجمع ربما نواب كتلة “القوات اللبنانية”، ونواب الكتلة الديموقراطية الجنبلاطية، إلى نواب المستقبل والكتائب، أو بعضهم، والمنشقين عن كتلهم الأصلية، وأول غيثهم نائبا الكتلة العونية الباسيلية. وتنسيق عمل المعارضتين يتيح مراقبة مزدوجة للحكم، من داخل ومن خارج. وما أقدمت عليه المعارضة السودانية حين فاوضت هيئة عسكرية من قادتها متهمون بجرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية، ينبغي ألا يعصى اللبنانيين المقيدين والموقتين، وترسي أسس وطنيتها العمومية. فيسعها الانخراط في انتخابات تنظم بناء على قانون نسبي ودائرة واحدة. فعند ذاك، يحول تنسيق المعارضة الوطنية دون إعمال “الصوت الشيعي”، التفضيلي أو غير التفضيلي، “الأوتوماتيكي” والمطواع، في تصنيع اقتراع شكلي. ويسلّط التنسيق على “الأصدقاء” البرلمانيين، وعلى كتلهم، رقابة الحركة.
ولا شك في أن مثل هذه الوجهة تعوّل على أناة اللبنانيين، وعلى إدراكهم ثقل المخلفات التي أُورثناها، طبقةً حاكمة ومحكومين (عازفين ومتواطئين ومستفيدين)، اجتماعنا ونظامنا السياسيين منذ عقود. فـ “النظام” الذي استقر في عهدة “السيدين” اللذين خدمتها وتخدمهما حركة عسكرية وأهلية وأمنية خلاصية، تستقوي بمشروعية إجلاء محتل أجنبي عن جزء من الأرض الوطنية، هذا النظام لم يترك شكاً، في محنتين قاسيتين، في إرادته قمع ما يخل بالموازين التي يتصدى لإرسائها منذ أربعين عاماً. والتلويح بالحرب الأهلية، وانقسام الجيش، والتسلّح والاقتتال، وبتهمات التمويل والتآمر والتخابر، في وجه “هايد بارك” اللبناني، قرينة على قوة تقاليد انقلابية عميقة الجذور والدواعي. وربما تستر كلام معسول ومتناقضة ومتقلب على عنف عدة التقاليد المتجدّدة. والخروج من هذه التقاليد، المنسية، مسير سياسي. صعب ومتعرّج.
وضّاح شرارة – المدن