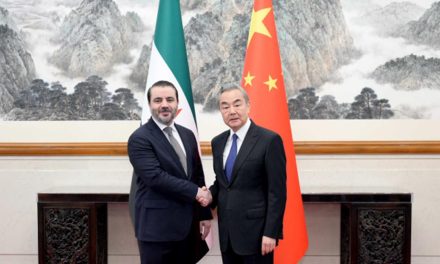كمال جنبلاط شاعر الاستعارات القصوى والفرح المأساوي لم يتسع لكشوفه الروحية والرؤيوية «قميص» السياسة الضيق

كتب شوقي بزيع في الشرق الأوسط
الكتابة عن كمال جنبلاط هي في كثير من وجوهها مجازفة غير مأمونة. ليس فقط لأنه أحد العلامات القليلة الفارقة في تاريخ لبنان الحديث، أو لأن حقل اهتماماته المتعدد يجعله رجالاً كثراً في رجل، أو «مفرداً بصيغة الجمع»، على حد تعبير أدونيس، بل لأنه شخصية مركبة تتدرج في سلوكياتها ومستويات تعبيرها من الظاهر المنكشف الذي تحتل السياسة سطحه المرئي، وصولاً إلى الأغوار العميقة للفلسفة والفكر والشعر والتأمل الوجودي. وقد تكون الفجوة القائمة بين المستويين السياسي والعرفاني، في شخصية السياسي المفكر اللبناني، هي المصدر الأبرز لمكابدات نفسه الممزقة بين براغماتية سياسية يصعب تجنبها في بلد كلبنان، تتحول فيه السياسة إلى معادل طبيعي للشطارة والنفاق وسرقة المال العام، وتوقٍ صوفي للانصهار في العالم والتوحد مع إيقاعه المتناغم.
على أن ذلك الانشطار الحاد بين الواقعي والمتخيل عند جنبلاط الذي ولد في مثل هذه الأيام قبل مائة وثلاثة أعوام كان بمثابة الجرح المؤسس لكل عبقرية فردية، والمصدر الأهم لكل تعبير خلاق. ذلك أن الترابي في الإنسان المبدع يبدو وكأنه يحن إلى سماويته، في حين أن السماوي بالمقابل يتوق إلى التجسد في حقيقة أرضية. ولعل المتنبي هو الترجمة الإبداعية لهذه العلاقة الجدلية بين الأقنومين، حيث إن تربعه على عرش الشعر، بما هو رمز لأنا الإنسان العليا، لم يحل دون سعيه الممض إلى الظفر بسلطة، ولو متواضعة، على رقعة الجغرافيا السياسية. كأنه بذلك كان يريد أن يجمع بين مجد السيف ومجد القلم، أو بين سلطة المجاز وسلطة الواقع. ولم يكن كمال جنبلاط بمنأى عن هذا المأزق الحاد بين السلطتين. ورغم أنه عمل جاهداً على حل التناقض الضدي بينهما، عبر اعتماد البراغماتية السياسية حيناً، والطوباوية المفرطة وشعرنة السياسة حيناً آخر، فإن ما يجمعه بالمتنبي، رغم محدودية الحيز الذي خصصه جنبلاط للشعر، كان ذلك الغضب المحتقن داخل النفس، والتمرد على السائد، وصولاً إلى مصيرهما المأساوي المتشابه.
ولعل أحد مظاهر تلك الثنائية الضدية يتجلى بوضوح من خلال الانشطار الجنبلاطي بين موجبات الاهتمام بالجماعة المحلية الحاضنة، بما تفرضه من تقاليد وسلوكيات شعبية، واعتقاد راسخ بأن السياسة الحقة لا يجب أن تكون رهينة لدى القاعدة العريضة التي غالباً ما تتحكم بها الغرائز والعصبيات والأهواء. وبقدر ما ركز جنبلاط على اضطلاع «الشخصية القائدة المسؤولة» بدورها الأساسي في تسيير دفة السلطتين، الرسمية والحزبية، أكد بالمقابل على مقولة سان سيمون حول دور النخب السياسية والفكرية والاقتصادية في صناعة التاريخ. وهو ما يؤكد عليه قائد الحركة الوطنية اللبنانية في غير موضع ومناسبة. فهو يشير في كتابه «آفاق نورانية» إلى «الأقليات الفاعلة» التي تلعب دوراً شديد الأهمية في عملية التنوير والتقدم الاجتماعي، وفي الحيلولة دون وقوع الدول والمجتمعات الديمقراطية فريسة للجهل والتخلف والفوضى. وهو يرى أن «ما يريده الشعب أو يبتغيه، أو خاصة يشتهيه، قد لا يكون من مصلحته بتاتاً»، وأن النخب المثقفة المتنورة منوطة بتعميق الوعي الجمعي وترشيده وإخراجه من مستنقع التخلف والجهل والإذعان.
وما يصح عنده على السياسة يصح على الفلسفة والفكر والشعر. فهو إذ يأخذ بمبدأ الأقلية الفاعلة الذي نادى به كل من جون ستيوارت مل وآرنولد توينبي، على الصعيدين السياسي والفكري، يلتقي في نظرته إلى الشعر مع الكاتب المكسيكي أوكتافيو باث الذي ينحاز إلى نخبوية الإبداع الشعري، ويرى أن المجددين الكبار، كبودلير ورامبو ومالارميه وفاليري وغيرهم، لم يجدوا في البداية من ينتصر لمغامرتهم التجديدية سوى أقلية محدودة من القراء، ولكنها «الأقلية الهائلة» التي تزداد رقعتها باستمرار، وتؤسس يوماً بعد يوم لكثرتها اللاحقة. وفي مجموعته الشعرية «فرح»، يكشف كمال جنبلاط، من خلال مقالة له بعنوان «أفضل الشعر»، عن معرفة عميقة بهذا الفن. وهو يقسم الشعراء إلى مراتب ثلاث: الأولى سفلية يشغلها أولئك الذين يكتفون بوصف الأغراض والصور الحسية والعواطف التي يقع عليها النور، وهم في الحقيقة ليسوا بشعراء؛ والثانية يشغلها الذين لا يكتفون بوصف المحسوسات والأغراض بحد ذاتها، بل بتفاعلها مع النور المنعكس عليها، دون التفات إلى مصدر هذا النور وينبوعه، وهم الشعراء المتفوقون. أما الثالثة، فيشغلها أولئك الذين غاصوا إلى لجة النور واتحدوا بجوهره، قبل أن يفيقوا من غشيتهم ليرووا ما سبروا غوره، وليكونوا شهوداً عليه. وهؤلاء هم الشعراء العظام الذين يتلمسون الشعر «فيما يتعدى الحرف»، وفيما هو أبعد من الأوزان والقوافي والزخارف الشكلية.
ويبدو الشعر عند كمال جنبلاط، وفي ديوانه «فرح» على وجه الخصوص، أقرب إلى «الشطح» الصوفي منه إلى المشاعر العادية، وإلى الحدس منه إلى الحواس. كما أن قصائده المختزلة تنقسم بشكل شبه متساوٍ بين المقطوعات النثرية ومقطوعات الشعر الخليلي التي يستقيم وزنها حيناً ويختل حيناً آخر. وهو ما يشير إليه ميخائيل نعيمة في مقدمة الديوان، مرجحاً أن المؤلف، شأنه في ذلك شأن سائر الصوفيين، كان يؤثر إبقاء النص على الصورة التي «تنزّل» بها دون تعديل. والأرجح أن «ناسك الشخروب»، محق فيما ذهب إليه لأن معظم النصوص الخليلية كانت سليمة الوزن سلسة الإيقاع، ومن ينظم بهذه السلاسة قادر -لو أراد- على تجنب أي خلل وزني. وهو ما يشير إليه صاحب الديوان دون مواربة. أما التعريض المباشر الذي يرد في المقدمة بالشعراء الذين يستجدون الألم ويتوسلونه طريقة للعب على العواطف وابتزاز الجمهور، فيمكن لدائرته أن تتسع لتطال معظم الشعر العربي المثخن بالتفجع والنبرة الحزينة والنزوع الرثائي. في حين أن شعراء الفرح كانوا قلة نادرة. صحيح أننا نتلمس وجوهاً للفرح في شعر سعيد عقل، ولكنه فرح كرنفالي متأت من التحليق فوق الحياة والانفصال عن الواقع، بقدر ما هو نوع من الانتشاء باللغة، بلاغة وإيقاعاً ومهارات. أما فرح كمال جنبلاط فهو يأتي من الجهة المعاكسة تماماً، حيث الانغماس الكلي بالوجود، والانصهار في أتونه المشتعل. كما أنه ربيب تلك النعمة التي تنسكب على الشاعر المتصوف من «قوارير النور» النافية للعدم، حيث الكائنات في انبثاقها الدائم تُواصل نوعاً من العود الأبدي، أو نكوصاً متجدداً باتجاه المصدر. وسواء تعلق الأمر بالأساطير أو الأديان، فإن فكرة الموت والانبعاث تجد في حبة القمح المدفونة في التراب تجسّدها الأمثل:
الحنطة تنمو وترتفع على القبر
وتجد في ترابه مصدراً وينبوعاً من القوة
هل طُمر الميت في الأديم؟
سيان أكان ذلك أم لم يكن: ها هو يعلو كالسنبلة
وما الشكل إلا خدعة الوهم
وتحت الغلافات المتحركة الهاربة
يدق بضرباته قلب الطاقة الكونية
الذي لا يتبدل ولا يؤول إلى العدم
من جهة أخرى، لا يبدو الفارق واسعاً لدى كمال جنبلاط بين الشعر والفلسفة، بل هو من القلائل الذين لا يربطون الشعر بالغنائية والبلاغة الفائضة والبوح الرومانسي العاطفي، بل بالمعرفة والفكر وإشراقات الداخل. وهو تبعاً لذلك لا يرى فارقاً بين الفلسفة والشعر، سوى ذلك المتعلق باللغة والأسلوب، حيث يخفف الثاني من جفاف الأولى، وحيث يحل الحدس والتوهج القلبي والتخييل التصويري محل برودة العقل وصرامة اللغة والأسلوب. وهو إذ يلتقي مع المعري في إعلاء العقل، والربط بين الشعر والفكر، يلتقي من ناحية أخرى مع الشاعر الألماني نوفاليس الذي يرى أن في داخل كل شاعر قدراً غير قليل من التبصر والاستشراف، ولذلك «فكل شعر حقيقي هو بالضرورة ذو منشأ ديني». كما أن صاحب «الحياة والنور» الذي وافق محيي الدين بن عربي في اعتقاده بوحدة الوجود، رأى في الأديان المختلفة وجوهاً لحقيقة واحدة، تقوم على الحب والأخلاق ونشدان المطلق النوراني الذي يجب على الجميع أن يتحلقوا حول كعبته المقدسة:
طفْ معي، يا أخي، كما تدور الأفلاك،
حول البيت العتيق،
مكة الحق، حجرة الشمس الحقيقية
التي لا تغرب عن وجود الإنسان
واسجدْ وإياي في استشراف سورة النور
عندما يعلو لهب الشعلة في المشكاة
تتحول اللغة هنا إلى معادل رمزي للتجربة، وإلى إشارات غامضة على طريق الكشوف الأخيرة. وقد بذل جنبلاط في بحثه عن الحقيقة كل ما يستطيعه من جهد، جامعاً بين فلسفة هرمس حول تجدد الولادات، وتعاليم البراهما والفيدا الهندية التي تنادي بوحدة المصائر البشرية والكونية التي تدور حول محورها النوراني من جهة، وتعمل على مصالحة الإنسان مع نفسه ومع الوجود من جهة أخرى. وإذ أنصت الرجل طويلاً وعميقاً إلى مرشده الأكبر سري أتمانندا، على ما يروي إيغور تيموفييف في كتابه «الرجل الأسطورة»، أدرك تمام الإدراك أن السعادة الحقيقية لا تتلمس عن طريق التجاور المكاني وحده، وليس بالضرورة أن يسافر إلى «الهند السعيدة» لكي يبلغها، بل يمكنه تلمسها في مكان إقامته الأصلي. وحيث كانت دير القمر تتوسط المسافة الفاصلة بين بيروت والمختارة، بلدته في مرتفعات الشوف، بدت له البلدة في أثناء رحلات الذهاب والإياب أشبه بطريق الشهود السالكين نحو محور الدائرة وعين المرآة، فكتب من وحيها:
دار القمر واستدار
في العمامة البيضاء،
وفي تقدمة الخبز، رمز الوحدة الجوهرية
آه لو كانوا يعرفون، فيما يتعدى الأديان
وفي رقصة الحق وفرح التكوين،
في بهجة الولادة، وفي بيوت الله
أي في قلوب المؤمنين
وكما كان اللفظ عند صاحب «هذه وصيتي» بمثابة جسد المعنى، وثوبه القابل للتبدل، فقد كانت الحياة بالنسبة إليه هي قشرة الوجود الحقيقي وحجابه التي تحول كثافتها دون الانتقال إلى صُلب الكينونة الحقة التي يمثلها الموت. لذلك فهو لم يهرب من مواجهة مصيره، حين عرف بالمكيدة الخسيسة التي تدبر للنيل منه. ولم يكن أمراً بغير دلالة أن يواجه كمال جنبلاط الطلقات التي سددت نحو رأسه وأنحاء جسده على طريق المختارة بعينين مفتوحتين وهدوء نفسي وقلبي قل نظيره، بل بدا في سريرته يشكر قاتليه على فعلتهم لأنهم بانقضاضهم على الجسد المثقل بأحماله ومكابداته وفروا لروحه الأسيرة وسيلة ملائمة للانتقال من مختارة الشكل إلى مختارة المعنى، وسبيلاً للتحليق في عوالم الفرح الأثيري والغبطة المطلقة.