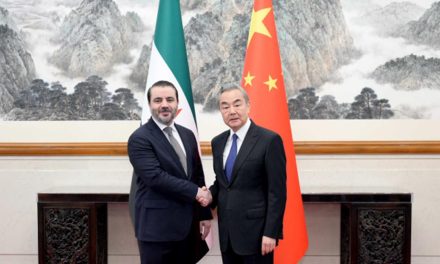الفارق بين تظاهرة بعبدا و”عاميّة” وسط بيروت

التوليفة الإخراجية والتنظيمية لتظاهرة محبي جبران باسيل وطاقمه النيابي والوزاري، ولمحبي جنرال الحربين المدمرتين والمتسيد على سدة الرئاسة برافعة “السلاح”.. كانت تكراراً مملاً لنمط بهت منذ عقد على الأقل. فعلى الرغم من الرونق المدني والسلمي والاحتفائي الذي ظهر في العام 2005، وكان جديداً من نوعه في العالم العربي ومتسقاً مع أساليب التظاهر التي عمت “الثورات المخملية” كالبرتقالية في أوكرانيا والقرنقلية في صربيا، والتي اتسمت بمطلب الحريات والديموقراطية.. إلا أن هذا الأسلوب استنفد قدرته التعبيرية وأصبح عاجزاً عن الاستجابة للمضمون المستجد في التجمعات الاحتجاجية. وفي التجربة اللبنانية، ما عاد هذا النمط من التظاهر “عفوياً” ولا “شعبياً” وتحول إلى أداة حزبية.
لذا، كانت العونية – الباسيلية في تظاهرتها خالية من أي خيال، وباعثة على الضجر التلفزيوني، وخصوصاً أن جمهورها افتقر إلى الابتكار ولو بهتاف واحد. فاستعارتهم البائسة لترنيمة “هيلا هيلا هوو..” كان مفعولها الوحيد التذكير التلقائي بنسختها الأصلية، ما ضاعف من مشاعر الشفقة والتأسف على هذا البهتان السياسي، إلى حد راح واحدنا يقول يا ليتهم يجترحون ولو شتيمة مضحكة.
وجمهور أتى بتعبئة حزبية من أجل تجديد هيامه الحزين واليائس
بـ”المخلّص” وصهره، من قرى وأرياف ما زال اجتماعها يدور على وعي فلكلوري
قديم وفقير، ليس بمقدوره سوى أن يكون هكذا، بائتاً وعنيداً في لغته
وعصبيته.
في ساحات بيروت
على الضد من خدر التظاهرة
“العونية”، تترجم “الانتفاضة” نفسها في وسط بيروت بخليط من أنماط الاحتجاج
والتعبير والتظاهر غير المألوفة في العمل “الجماهيري” السياسي. فما بين
“الباراد” والسوق الشعبي والحفلات الراقصة والفنون التمثيلية والكرنفال
والاعتصام السياسي والمحاضرات الجامعية، وما يشبه الهايد بارك المتكاثر في
الخيم المتوزعة، بل التنزّه والتسكع أو حتى ارتجال مقاهٍ وحضانة أطفال
لقراءة القصص والتسلية، وإنشاء بسطات لكل شيء.. يقوم اجتماع “فوضوي” حر على
ضفاف وفي قلب الساحات التي لا تخلو أيضاً من منصات متباينة الغرض
والاستعمال، خطابية أو غنائية.. ويمتزج هذا في فضاء موسيقي مجنون يجمع
تقليديات الأغاني الثورية مع تراب ميوزيك وتكنو – راب، وهيب هوب، وإيقاعات
الموسيقى العربية الجديدة والشبابية، التي تألقت خصوصاً في ساحات الثورة
المصرية الموؤدة.
والصخب المبهج لا يقتصر على البشر ولا على مكبرات الصوت، فهو أيضاً يضجّ على جدران الأبنية المنتشرة، رسوماً وغرافيتي وعبارات وشعارات فردية وفحش بذيء وشعر وسياسة وأفكار ساذجة وخربشات وما لا يمكن حصره، متعدد اللغات والأهواء.
هناك على جدران عدة توزعت مرايا كتب عليها “أنا قائد الثورة” أو “أنا قائدة الثورة”، فإذ بكل شخص يمر بمحاذاتها رأى نفسه قائداً/ قائدة للثورة لبرهة خاطفة. وهذا “فن الشارع” في لحظة تسديد لكمة سياسية على لغو “من هم قادة الحراك”. لغو يأبى إدراك ما يحدث ويأبى الاعتراف بالحقيقة المباغتة. وعلى مثال المرايا هذه، يحدث ابتكار وسائل فردية أو جماعية كجزء من هذه الفسيفساء الباذخة والمدوخة بفوضويتها.
والحال أن ما تجمعه الساحات في وسط بيروت لا يسعى إلى
“التوحد” صورة ولغة ونمطاً، بل هو يحتفل هكذا بكثرة تبايناته ولا حصرية
صوته. فلا يمنع أن تجد جماعة من المبشرين الأنجليين يحاولون إقامة صلاة
بالقرب من كتلة متحمسة من النسويات وهن في قمة انفعالهن، أو أن ترى تبدل
وظيفة الدرج العريض لمسجد محمد الأمين وقد تحول إلى ما يشبه مدرج الملاعب
الهادرة.
وتستوعب “عامّية” بيروت بزوغ حركات سياسية متجاورة وشديدة
الاختلاف، ما بين قدامى الشيوعيين وقدامى الكتائب مثلاً، وفروع متخاصمة من
الحركات النسوية، وأنتليجنسيا خرجت من خيبات 14 آذار من غير الحزبيين
والمنشقين عن التيار العوني، والبيئيين والليبراليين وأولئك المبتعدين حسرة
عن “تيار المستقبل”.. لكن العصب الفعلي يبقى في الجيل الجديد من طلاب
الجامعات الذي يؤلفون تياراً يسارياً علمانياً منقطعاً عن ذاك اليسار
القديم باهتمامته الاجتماعية كالجندرة والبيئة والتكنولوجيا، ومتصلاً أكثر
بحراكات احتجاجية متعولمة كالسترات الصفر في فرنسا.
وفي كل هذا، نحدس أن ما يجري في ساحات بيروت، وخصوصاً مع انتشار الباعة والبسطات، وكأن المواطنين استردوا وسط المدينة ممن باتوا يوسمون بـ”الحرامية”. أي جعلوه “وسطاً” وقلباً وازدحاماً وسوقاً.
والانتفاضة في صورتها هذه إنما توحي بانقلابات عميقة اجتماعياً وسياسياً. وكإنها انفضاض عنيف من منظومة حياة ما عاد يصح وصفها “حياة”.
يوسف بزي – المدن