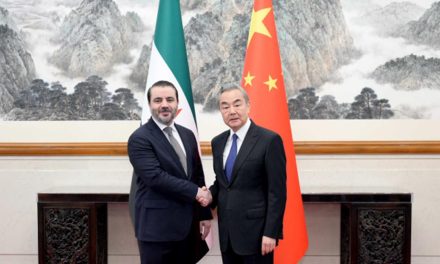اليسار والانتفاضة: إعادة توزيع الثروة.. إعادة توزيع العنف

ابتغى رئيس الجمهورية إحياء مئوية لبنان الكبير من بوابة
الإغارة على السلطنة العثمانية. إلا أن الواقع اللبناني تكفل بفعاليات
إحياء للمئوية الكولونيالية الكيانية على نحو مختلف كلياً، وبمتلازمة
الجلطة والعامية. الجلطة الدماغية والقلبية للنظامين الاقتصادي والسياسي.
والاحتجاجات الشعبية المتخذة سريعاً شكل انتفاضة لامركزية، متفاوتة بين
المناطق، وطاعنة في شرعية كل ما انبثق عن انتخابات أيار 2018 من برلمان
وحكومة.
الوصاية ووريثها
بل هي انتفاضة حبلى
بروح القطيعة مع الجمهورية الثانية ودستوريها، النصي – المعتل من كثرة
فراغاته والتباساته، والتطبيقي المنمّط على تفاسير الوصاية السورية حتى بعد
أربعة عشر عاما على انقضائها. وهذه مدة من الوقت طويلة، تنطّح فيها “حزب
الله” تحديدا لوراثة غير مكتملة لدور الوصي. فقوة الوصي الآفل تجلت في
تفسير الدستور، بالشكل المعدل وفقا للطائف والمحرّف عن متن اتفاق الطائف
نفسه، وفي تشغيل هذا النظام، بإدماج رهط وإقصاء رهط آخر. أما قوة الوريث
غير المكتمل للوصاية فزاوجت بين الغلو في الميثاقية على حساب الدستور،
والجحود بها على حساب العقد الاجتماعي. فمن جهة مسائل منحاة عن الاجماع
الوطني، بدءاً من تفاوت حظ الحزبيات والجماعات الأهلية من القوة النارية،
ومن جهة ثانية إجماع وطني على مستوى التقاسم، حين يستحسن المتغلب ذلك. قوة
الوصي السوري تأمنت بتشغيل “النسق العشوائي” للجمهورية الثانية، وقوة “حزب
الله” تكشفت برعاية تعطيله هذا النسق المتداعي هنا أو هناك، هذا قبل أن
تتمكن قوى تأتي من بعد الحزب منزلة من محاكاته، واكتشاف قدراتها التعطيلية،
وفقا للسياقات، ذلك أن استفحال التصدع في هذا النسق سيتكفل بتيسير تعطيله
من لدن الجميع.. ولو بتفاوت.
بخلاف انتخابات 2009 التي خيضت أساساً، كاستفتاء داخلي على
حزب الله، وعلى خلفية شعار الأخير عشيتها، “إعادة تشكيل السلطة في لبنان”،
فقد خيضت الانتخابات المؤجلة بعد ذلك بتسعة أعوام، ضد طواحين الهواء
بالدرجة الأولى. فالجميع خاضها ضد “الفساد”، والجميع رأى الفساد في عين
الآخر، حليفه أو خصمه أو البين بين. وساد، سواء في حزبيات النظام المتناحرة
والمتوالفة، أو في ظواهر “المجتمع المدني” على ما جرت التسمية، انفصال حاد
بين حرف “مكافحة الفساد” وألفباء إعادة توزيع الثروة في لبنان.
في توزيع العنف
يظهر
اليوم “ما المشكلة” في هذين الاستحقاقين الانتخابين السابقين. على محك
ترنح النظام، نظام حكم القلة من كبار أصحاب الثروات من أرباب المصارف
والميغا – مقاولين ولوردات الحرب المغانمين، أي نظام الأوليغارشية في
الجمهورية الثانية، كما على محك أسلوب تعاطي المتحكم والحاكم، الذي له
مواطئ قدم في هذه الأوليغارشية لكنه ليس من صلبها، وهو عندها، كما كانت
قبله الوصاية السورية، الخصم والحكم، والحارس المرهق لها. المشكلة تكمن في
عدم وجود قوة فعلية، لها قاعدة اجتماعية حيوية، وتطرح على نفسها وعلى مستوى
البلد ككل، خوض الصراع من أجل إعادة توزيع العنف وإعادة توزيع الثروة في
البلد، بشكل متناغم.
مهلاً، إعادة توزيع العنف؟ نعم، لأن العنف في أي مجتمع لا يمكن أن تحتكره مقولة ماكس فيبير حول “احتكار الدولة لمنظومة العنف الشرعي”. لا يسع أي دولة أن تصادر كل العنف من المجتمع. لكن لا يسع أي مجتمع ان يبقى كذلك بعيش التفاوت في مقدرات العنف، الناري وغير الناري، بين تشكيلاته الحزبية وجماعاته الأهلية. إعادة توزيع العنف تجري على قدم وساق في كل مجتمع، بوتائر وأنماط مختلفة. فهي ترتبط بميزان التناسب العنفي بين الجماعات، لكن أيضاً بميزان التناسب بين الأفراد والجماعات، مثلما هي ترتبط بالتناسب بين العنف المجتمعي وبين منظومة العنف الشرعي الدولتية.
توزيع العنف في كل المجتمع ليس له نفس منطق توزيع الثروة. حيث
يتمركز العنف ليس بالضرورة حيث تتمركز الثروة، وعلى الأغلب يختلف مركز
تكدس العنف عن مركز تكدس الثروة في معظم المجتمعات، ويتخذ هذا الاختلاف
أشكالاً مختلفة. الشكل اللبناني الحالي منها له خصائصه المميزة. حزب الله
هو مركز توزع العنف داخل المجتمع، وداخل الدولة، لكن أيضاً بإزاء المجتمع
وبإزاء الدولة، لكن مركز الثروة هي في الجهاز المصرفي للنسق الأوليغارشي.
في الوقت نفسه لا ينفصل المركزان، أو يتطوران على قاعدة التوازي. فلا طرفية
الحزبيات الأقل امتلاكاً للأرصدة العنفية، بإزاء مركز تكثف العنف، تجعلها
“حلفاً للأحرار”، ولا طرفية “حزب الله” بازاء مراكز تكثف الثروة، الصديقة
أو المناوئة له، تجعله على رأس “حلف الفقراء”، كما عوّل من عوّل من الذين
اشتهوا في الحزب “زاباتية” ما، وهناك من لا يزال يعوّل.
القوة المفقودة
القوة
الجامعة، فكراً وانتظاماً وبرنامجاً سياسياً، بين مشروع إعادة توزيع العنف
وبين مشروع إعادة توزيع الثروة، مع تمييز المستويين، وعدم تسبيق أحدهما
على الآخر “وجودياً”، هي القوة المفقودة، إلى حد بعيد في تاريخ الجمهورية
الثانية. هكذا قوة هي وحدها المؤهلة لكي تكون يساراً، إذا ما قصد باليسار
مشروعاً هيمنياً بديلاً في مجتمع ما، وبخاصة في المجتمعات الذي ليس شرطاً
فيها أن يكون هناك يمين كي يكون فيها يسار، أي في المجتمعات الذي لم يؤطر
فيها الصراع على إعادة توزيع كل من العنف والثروة ضمن نسق مدستر كامل، أي
الذي لم يفكك من داخلها بعد مفهوم “العدو” ليستبدل منهجياً بمفهوم “الخصم”.
الانتفاضة الحالية، بمحمول اجتماعي، بل طبقي. فجرته سياسة
الحكومة المخلوعة، تكبيد الطبقات الشعبية فواتير الفشل الاقتصادي والمالي
لملئ الأوليغارشية، مع الانقطاع تماماً عن أدنى درجات إعادة توزيع الثروة،
إسوة بالانقطاع تماماً عن أي بحث جدي في اعادة توزيع العنف على نحو يؤمن
معاني المساواة بين الناس. لكن هذه الانتفاضة الشعبية، ذات الجذر الطبقي،
لا تزال خاضعة إلى حد كبير لهلامية شعارات مكافحة الفساد، التي تجسد بها
خواء انتخابات 2018. أي لمكافحة فساد إما منقطعة عن هدفية وبرنامجية إعادة
توزيع الثروة، وإما تختزل إعادة التوزيع هذه في وعودها.
طيف اليسار
يتحرك
الإمكان النظري والعملي إذاً ضمن هذا التناقض بين الجذر الطبقي للانتفاضة،
أي المفترض به أن ينحو لتقديم شعارات إعادة توزيع الثروة، بدءاً من
المفاصلة مع الجهاز المصرفي نفسه، وبين اللافسادية المهيمنة عليها،
أيديولوجياً ودعائياً، والمنفصلة عن هدفية إعادة توزيع الثروة، وحامية
بالتالي لكل من النمط الحالي من توزع الثروة والنمط الحالي من توزع العنف.
يحمل هذا الإمكان معه طيف يسار لم يكن مفكراً بجدواه، بهذا الزخم، قبل 17 تشرين. إلا أن المسافة بين هذا الطيف وبين اليسار الموجود بالفعل، والطليعي للغاية في صفوف المنتفضين، لا تزال قائمة.. طالما أن صياغة مشتركة لبرنامج إعادة توزيع كل من الثروة والعنف في لبنان لا تزال مؤجلة. لها شروطها؟ بل لها شروطها المريرة. أولها؟ مغادرة تلك النظرة للطائفية كما لو كانت مجرد عارض يزول من عوارض البنية الفوقية ما أن يعي الناس بأن الطائفية تضللهم عن معاركهم الاجتماعية والوطنية الصحيحة. ما زال يسري الاعتقاد ضمن اليساريين بأن هذا الموقف معيار الجذرية، وكلما صعدت فيه أكثر كلما تجذرت أكثر، في حين أنه في جوهره موقف غير جذري بالمرة. هو موقف يتوهم إمكانية أن يتجاوز المجتمع اللبناني الطائفية من دون أن يتجاوز نصيبه من الرأسمالية الكولونيالية، ومن دون أن يتجاوز نصيبه من نموذج الدولة المركزية.
سجن اليسار اللبناني نفسه مطولاً في مفارقة تفسير كل شيء بالطائفية، واختزال الطائفية في الوقت نفسه إلى شيء يمكن تجاوزه من دون تجاوز الرأسمالية الكولونيالية، وأوليغارشيتها القابضة والمتعايشة أو المتصادمة مع الفاشيات المحلية كما العابرة للمحليات. مغادرة هذا السجن تبدأ من إعادة وصل هذا اليسار جدياً مع الأفكار النقيضة للرأسمالية، أي مع الأفكار الاشتراكية، لكن أيضاً مع الأفكار غير الدولتية وغير المركزية. في وقت اليسار اللبناني التاريخي كان دولتياً ومركزياً حتى وهو يختزل الدولة إلى أداة سيطرة طبقية.. فيما الدرس الذي يحتفظ براهنيته من نيكوس بولنتزاس، بعد أربعين عاماً على انتحار الأخير، هو أن الدولة ليست فقط أداة سيطرة طبقية، بل هي فضاء تكثف التناقضات بين مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية.
تلمس جدوى وراهنية الأفكار الاشتراكية، ومحورية العمل، ومن
يبيع قوته، في الصراع مع رأس المال، حتى ولو لم يكن العمل مصدر كل قيمة، هو
شرط أساسي ليتحول طيف اليسار في الانتفاضة إلى قوة تتسع لليساريين،
بالمعنى المتعارف عليه تقليدياً في لبنان، لكن أيضاً أبعد منهم وأوسع.
التخفف من الدولتية والمركزية
هذا
الطرح يناقض مع دأب عليه اليساريون اللبنانيون منذ نصف قرن، من توهم أن
اكتفائهم بمتعلقات الحكم الوطني الديموقراطي المشتهى، والتعامل مع الأفكار
الاشتراكية كما لو كانت مادة تثاقفية او هوياتية داخلية لهم فقط، يمكنه أن
يوسع صفوفهم. هذا التوهم مبني أصلًا على تسليم خاطئ بأن الديموقراطية مرحلة
والأشتراكية مرحلة أخرى، في حين أن الاشتراكية هي هي الديموقراطية عندما
تجد الطبقات الشعبية فيها نفسها، وقدرة أفرادها على التحكم بمصائرهم
الاقتصادية وخياراتهم السياسية وصياغة منازعهم الفرحة.
تزامن تراجع اليسار على الصعيد العالمي، مع انهيار الشيوعية السوفياتية واضمحلال اللون الاجتماعي للاشتراكية الديموقراطية ثم كبوتها السياسية أيضاً، مع أفول اليسار العربي الذي لم تزدهر فيه من الأساس الاشتراكية الديموقراطية وتطور أساساً ضمن ثنائية الأحزاب الشيوعية من ناحية، وفصائل القومية المتمركسة من ناحية ثانية، قبل أن يضاف إليهما، ومن رحميهما، ليبراليو اليسار. بنتيجة هذا التراجع، انقسم اليسار اللبناني نفسه، بين أكثرية التحقت بمنظومة الممانعة بشكل أو بآخر، لكنها حافظت أكثر، على شعارها الطبقي، وبين أقلية، لم تتمكن من الحفاظ على استقلاليتها ضمن منظومة 14 آذار، وتخلت عن الشعار الطبقي سريعاً، لكنها اصطدمت مباشرة بالخزان الاستبدادي لمنظومة الممانعة، وبعلاقات التغلب الفئوي التي تحكم توزيع العنف في النطاق اللبناني.
اليوم، ينخرط معظم هؤلاء وأولئك في الانتفاضة، ما عدا أقلية مندمجة تماماً بحزب الله أو بالنظام السوري وامتداداته. هذا الانخراط لا يكفل لوحده شق السبيل للخط اليساري الواسع والجذري في آن، ضمن الانتفاضة. لأن هذا الخط يرتبط بوصل في العمق بين إعادة توزيع العنف وبين إعادة توزيع الثروة، وبين استعادة الفكرة الاشتراكية وبين تخففها من الدولتية والمركزية، وبين فهم الدولة كأداة سيطرة طبقية، وبين فهمها كمجال لتكثف التناقضات الطبقية. هل ثمة مفتاح لكل هذا؟ ليس ثمة مفتاح سحري أو سري. لكن ثمة مجموعة مداخل، فكرية وتنظيمية وسياسية، متصلة بمقاربة الواقعين اللبناني والإقليمي لكن أيضاً بمقاربة حال العالم اليوم. فمن جهة، إما أن يكون تحرر اللبنانيين من صنع اللبنانيين أنفسهم، ومن صنع طبقاتهم الشعبية في الأساس، وعلى صورتها وتطلعاتها، أو لا يكون. وإما أن يكون تحرر اللبنانيين ضمن حركة الانعتاق الشاملة والراهنة أو لا يكون. ولهذين “الاعتبارين” لزوم تفصيل القول بعد أكثر.
وسام سعادة – المدن