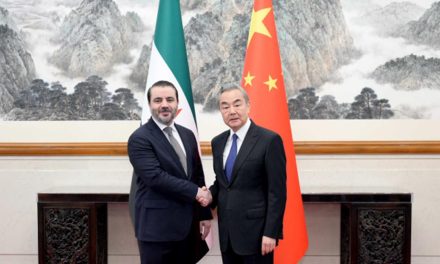قراءة في رواية “غبار 1918 ل فاتن المر”

بقلم البروفيسور علي مهدي زيتون*
بين يديّ المنهج: إذا ارتبطت الجمالية الأدبية بالانفعال الذي تحرّكه في نفوسنا، بالدهشة ممّا كُشِف لنا ، ممّا رأيناه لأوّل مرّة، من ولادته على يد قراءتنا، فإنها ليست سوى تلك الفرادة أو الخصوصية المرتبطة بالبصمة الثقافية التي تخصّ من قال القول دون سواه. ويمثّل هذا الفهم منطلقاً للبحث عنها من خلال الثلاثيّة المتواشجة نعني بها: الرؤية، رؤية الأديب، والعالم المرجعي المتكشف، واللغة.
ويعني ذلك أننا حين نواجه نصاً او خطاباً، فإنه يطل علينا باللغة التي تمثل وشيجة طرفاها رؤية الأديب والعالم الذي تطلعت إليه تلك الرؤية. فهل يدعونا ذلك للبحث عن الجمالية من خلال تلك الوشيجة؟ وهل هذه الوشيجة هي الخصوصية عينها، ام ان سؤالاً أكثر دقة وعمقاً يواجهنا، ومفاده: كيف حضر الطرفان الآخران في هذه الوشيجة؟ وهل هذا الحضور هو الفرادة، الخصوصية، البصمة الجمالية؟ تستدعي هذه الأسئلة بحثاً عن الآليّة التي تمكّننا من الامساك بمثل تلك الجمالية، الجدّة ، العمق المكتشف من العالم المرجعي، كما تستدعي تحديداً للأدوات التي تسمح لك بمثل ذلك الإمساك.
تبدأ الآليّة من منطلق موضوعي متعلق بالعالم المرجعي وبإمكانيّة أن يكون ذلك العالم ذا طابع نفسي، أو تاريخي، أو أجتماعي، إنطلاقاً من الاعتراف بكل الجهود التي بذلتها الحقول المعرفيّة المختلفة في تعالقها مع الأدب؛ لأنّ العالم المرجعي الذي يمثّل مادة الادب، وخصوصا الرواية، لا يمكنه الإنفصال عن تلك الحقول. وإذا أوجب العالم المرجعي علينا الإفادة من مثل هذه الأدوات، الحقول المعرفية، في أثناء البحث عن أدبية النص، خصوصا انها ستفرض حضورها في ذهن القارئ وفي رؤيته إلى العالم سواء شئنا أم أبينا، فإنّ اللغة تقاسم تلك الحقول الحضور إذا لم نقل إنّها هي التي تحدّد ما يحضر من تلك الحقول وما يغيب. وذلك ليس من خلال علم الدلالة “semantique” المرتكز إلى ثلاثية: المستوى المعجمي، والمستوى النحوي، والمستوى الصرفي فقط، ولكن من خلال الأسلوبية الإحصائيّة المستندة إلى السيمائيّة ” semiologie” التي ترى ما احصيناه من ظواهر أسلوبية علامات سيمائيّة دالة. فهل يمثل هذا التقاسم للساحة استيلاء عليها؟ وكيف يمكننا الأمساك بالرؤية، وعمقها الثقافي، بوصفها منتجة الخصوصية الجمالية أولا واخيراً؟
وإذا كانت الثقافة هي السلطة العليا في الرؤية، فإنها هي التي تحدّد العمق المكتشَف من جهة اولى، والأسلوب اللغوي الذي امسكت تلك الرؤية من خلاله بذلك العمق من جهة أخرى. يعني ذلك ان الجمالية الادبية جدل قائم بين الرؤية والعالم المرجعي قائم داخل اللغة. ولكن كان كل ما لدينا من هذه الجدلية ساحتها بداية، نعني بها اللغة، فان اللغة بما ازهرت به من اساليب ، واثمرته تلك الأزهار (الاساليب) من علامات دالة هي التي تقدم الينا مفاتيح تلك الجدلية القائمة، تومئ بطرف من عينها إلى العمق المكتشف، وبطرف اخر إلى الثقافة الفاعلة.
-عتبة الرواية: يبدأ الدخول إلى رواية فاتن المر “غبار 1918” من العنوان الذي هو في أيّة حال من الأحوال (لغة) تضمر ذلك الجدل الذي تحدثنا عنه مكثفاً . وإذا كان الرقم “1918” ليس رقماً حيادياً، وليس مجرد إشارة إلى سنة من السنوات، فإنه محتشِد بما قامت عليه تلك السنه من مفصلية بين مرحلتين من المراحل التي عاشتها منطقتنا: ارتفاع يد ثقيلة عنها كان مشروعها استرقاق الناس بوصفهم مصدر ضريبة يغذّي الخزانة العثمانية، بما يحرم الفلاحين من ثمرات عرقهم وما يبذلونه من جهد، وحلول يد ثقيلة اخرى محلها، ومن نوع مختلف، مشروعها ثنائيّة (نهب ثروات بلادنا / وجعلها سوقا استهلاكية لمنتوجاتها الصناعيّة) . وذلك عبر الحاقها بآليّة مصالحها. وإذا كان كل ما قلناه مسألة معرفية يمسك بها من له ادنى فهم لما جرى ذلك العام، فإن إضافة كلمة (غبار) إلى ذلك الرقم (1918) هي بيت القصيد، وهي التي تقدم لنا جدلية العلاقة بين رؤية فاتن المر، والعالم المرجعي الذي هو موضوع تاريخي (العام 1918) والتي تتجلى بالعمق الخاص الذي امسكت به تلك الرؤية من ذلك العام ذي الابعاد غير المتناهية. أن نقول: العام (1918) يعني اننا نشير إلى سطح ذلك العام الذي يمسك به كل من له ادنى معرفة بما جرى فيه، ولكن حين نقول (غبار 1918) فاننا امام رؤية خاصة لذلك العام، وامام عمق منه لم يره احد غير كاتبنا. هذا العمق هو الجدة المثيرة لدهشة المتلقي، هو الجمالية.
فالغبار، مستقلا عن ذلك العام هو ما يعطل رؤية العينين إلى اشياء العالم ويدميهما من جهة، ويشكل ضيقا في الرئتين يعيق تنفسهما من جهة اخرى. اما والغبيار مرتبط بعام محدد فان الغبار لم يعد غباراً حقيقياً، والعام 1918 قد فقد هيمنة الهوية الزمنية عليه. ويمثل ذلك ايماءة الى ما تخبئه الكلمتان ( الغبار)،و (العام 1918) تحت ردنيهما من اسرار فضّتها رؤية الكاتبة.
إن تغشية العينين بما يحول دون الرؤية السليمة الواضحة من جهة، وتضييق التنفس من جهة أخرى ينسلان العام 1918 من زمانيته ولا يبقيان من تلك الزمانية سوى المفصلية الخانقة التي تضيع بين ظالمين: ظالم أمي هو التركي وظالم متعلم هو الغربيّ. ومهما يكن من امر، فان تلك المفصلية لم تقدم كما قدمت لان الأديبة منتمية الى المجتمع الذي عاش في مرحلة من تاريخه ذلك (الخانوق)، وليس؛ لانها منتمية الى جماعه عقديّة محددة، ولكن بسبب البصمة الثقافية الفريدة التي باتت لفاتن، وذلك بسبب قدرتها على طرح الاسئلة المرة على حال مجتمعها من جهة ،وعلى ثقافة العقديين الذين تنتمي فاتن الى دائرتهما من جهة اخرى. يمثل ذلك اشارة الى ان فاتن قد امتلكت ثقافة عصرها ثم تخطتها.
ولئن لفتنا العنوان الى تاريخ محدد، فكيف تجلت خصوصية ذلك التاريخ من خلال الرواية كاملة؟
إن كلمة (غبار) التي ادت دوراً محورياً في تحديد جمالية العنوان، ادبيته، خصوصيته الرؤيوية، وردت غير مرة، في المتن. وإذا كان من طبيعة اللغة أن تتخذ الكلمة المفردة الواحدة بعداً دلالياً جديداً، في كل مرة نلجأ فيها الى استخدام تلك الكلمة، تشهد نماءاً محدداً ببنية التركيب الذي وردت فيه، فإن ورود كلمة (غبار) في المتن لن يكون حياديا مستقلا عن ورودها في العنوان بقطع النظر عن النماء الذي نالها والذي تحدثنا عنه. تقول الكاتبة على لسان المغترب اللبناني في ” دو ترويت 1972″: “ابدأ من غرفة مكتبه…[مكتب والده المتوفّى]… الغبار استوطن المكان وأنا دخيل عليه… كيف لي لم أر نفسي عائداً إلى البيت بعد غيابهما [الوالد والوالدة]”(ص 8). لقد قامت مفارقة بين الغبارين: غبار العنوان وغبار المتن هنا. فإذا كان غبار العنوان غباراً مثاراً، فإن غبار مكتب الوالد غبار راكد. فهل تقوم المسافة بين الغبارين على فاصل زماني فقط؟ إن ركود غبار المكتب، بغياب الإنسان عنه، يغذّي غبار العنوان بعلاميّة جديدة تمثل ايماءة إلى الموت والغياب، بما يرينا نماء كلمة (غبار) نماء متصلا بمأزقية الإنسان في وجوده حين تسود المجتمع الإنساني شريعة الغاب سواء أكانت شريعة الأمي ام شريعة المتعلم. وهذا ما أعطى العام 1918 بعداً تغييبيّاً للإنسان. تأتي معاهدة سان ريمون التي عقدها المجلس الأعلى للحلفاء والتي نصت على وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ووضع العراق وفلسطين وشرقي الأردن تحت الإنتداب الإنكليزي مع الإلتزام بتنفيذ وعد بلفور(ص140-141). وكانت ردة فعل الناس في هذه البلدان عبر مقولتهم:” رفضنا لأن نكون مجرد غبار على خارطة تمتد إليها اصابع اسياد الحروب” 141. ورفض أن يكون الإنسان المعتدى عليه غباراً، لا يعني خلاصه من الغبارية؛ لأن النتيجة مرتبطة بيد القوي الغربي هنا. وهذا ما ارانا خصوصية الرؤية الفاتنيّة إلى العام 1918. وذلك عبر مد اصبع الإتهام إلى الظالم الذي أراد لهوية الإنسان أن تكون هوية غبارية من خلال اعطاء معاهدة سان ريمو هوية المنفاخ المتحكم بحركة ذلك الغبار (الناس) ومصيرهم. وتمثل هذه الهويّة رؤية فاتن إلى الثقافة الغربية الحداثية المتخلصة من أي عمق اخلاقي او ديني او إنساني. نفذت رؤية فاتن إلى ما خبأه الغربي من هويته عن أعين الاخرين، فكشفت أنّ الغربيّ وحش كاسر يضع العقل العلمي الذي وفد إليه مع الحداثه في خدمة غريزته المتوحشة. وتبدى المشرقي قبالة هذه الغريزية مجرد أداة للإستخدام بعيداً عن أي مشاعر انسانية، عبر تشييئه تشييئاً يضعه في وضعية التفاهة، مجرد غبار. والغبار في الاحوال الثلاثة التي رأيناها مستقطبة حول التاريخ. فتكدس الغبار غياب للانسان ومعه غياب للتاريخ ، وتشييئ الانسان غباراً لا حول له ولا طول على علاقة بالتاريخ الذي يقوده الظالم فوق ساحتنا. واذا كان العام 1918 صراعا بين ظالمين: الاتراك والغرب، فان غباره، سواء اكان مثاراً، ام راكداً، ام تشييئاً للإنسان, هو تقديم لعمق من اعماق التاريخ، الخصوصية الرؤيوية الخاصّة بالأديبة، الجمالية الادبية المثيرة لدهشة المتلقي حيال ما لم يره من قبل، المكتشف الجديد.
ويبقى أن رؤية فاتن المر( ثقافتها) مسدّدة الى التاريخ المشرقي انطلاقا من العام 1918 والغبار الذي اثاره ذلك العام يبقى غباراً وهو وإن حمل اشارة سيئة سلبية كما رأينا وذلك لأن فاتن قد أغمضت عينيها عما يمكن أن يحتمله الغبار من بعد أيجابي خصوصاً أن الغبار هو الأسهل بين الأوساخ التي يمكن ازالتها. واغماض عينيها عن تلك السهولة في المعالجة عائد الى ربطه من قبل فاتن، بالظلامية والظلم اللذين مارسهما هذا المحتل او ذاك. وهذا بعد تدقيقي نفذت إليه رؤية فاتن ( ثقافتها) فقدمت لنا من العالم المرجعي (التاريخ )عمقا لا يتيسّر التقاطه لغير هذه الأديبة من خلال خصوصية ثقافتها.
ولئن حملت رؤية فاتن الى العام 1918 خصوصية ثقافية تتعلق بامتلاكها ثقافة عصرها وصولا إلى قناعات سياسية قومية هي قناعات الكثيرين من الذين انتموا الى الحزب السوري القومي الإجتماعي، الا أن القناعة الحزبية لا تكون قناعة مشتركة الا في خطوطها العريضة دون التفاصيل. والإفتراق في التفاصيل هو الذي يعطي عقيدة ما حيويتها. ولولا ذلك الاختلاف في التفاصيل لتحول الحزبيون إلى ارقام جافة يابسة. وإذا كان الأمر كذلك، كيف تراءت تفاصيل العالم المرجعي عبر خصوصية ثقافة الكاتبة؟.
تستوجب الإجابةُ الوقوف عند مكوّنات أربع من مكوّنات ذلك العالم: هي المجتمع، والوطن، والهوية، وسيرورة الزمن.
1-المجتمع: يقول يوحنا الباقي الوحيد على قيد الحياة من أفراد أسرته: ” كيف نجا العم أنيس من موجة الأنانية التي ضربت الجميع وبقي يحيطنا بعطفه، ويتقاسم معنا ما تيسر له من طعام؟ نجا من الأنانية ولكنه لم ينج من بطش الاتراك الذين اقتادوه الى سجن عاليه ذات ليلة، وانقطعت بعدها اخباره، وانقطع اخر خيط يربطني وامي واخوتي بالاخرين” (ص 19). يكشف تساؤل يوحنا، والتساؤل نمط لغويّ، عن عمق من الأعماق التي قام عليها مجتمع الريف اللبناني، ممثّلا هنا ببلدة الخنشارة، في تلك الأيّام.
وسمة هذا العمق تعاظم غريزة حب البقاء (الأنانية)، حيث يتنازع كل فرد من افراد ذلك المجتمع البقاء في مواجهة الأخرين، جميع الاخرين. يعني أن المجتمع قد أشرف على ان يتحول الى مجتمع متوحّش،وسط تعطيل كامل لسلطتين تحكمان الإنسان عادة: سلطة العقل، وسلطة القيم الأخلاقية. والاستفهام القائم على التعجب اشارة إلى امرين: الاول معني بالقاعدة الغريزية التي باتت تحكم قيم الخنشارة، تمثيلاً للمجتمع اللبناني، والثاني هو مقاومة تلك الغريزة. واذا كانت المعركة بين الطرفين غير متكافئة فان تعالي الطرف الفاعل في نقل المجتمع اللبناني من مجتمع انساني الى غاب وحوش على الطرف المقاوم، سيجعل ممن تبقى من الأسرة: ام يوحنا ويوحنا واخته فريسة سائغة للأنانية المتفشّية، والتي عمل على تفشيها العثماني الذي تسبب بانقطاع ” اخر خيط يربط يوحنا وامه واخوته بالأخرين”( ص 19). باتوا فريسة الفقر والجوع وبالتالي المرض. فغبار العام 1918 لم يبق غباراً تسهل إزالته، بات (فيروساً ) لن ينجو منه الا القليلون جداً. فقد نجا يوحنا من الأسرة كلها. ولا بد من الإشارة، هنا، الى دور الاب في إعالة الأسرة، أسرة يوحنا، انموذجاً. تحول الى مجرد غبار يمثل اقالة ذلك الاب من دوره، والقاءه خارج حسابات المجتمع. هاجر وانقطع عن أسرته فانقطع عنها أيّ نفع محتمل منه اتجاهها ، أيّ نفع مهما تضاءل. وتقع مسؤولية هجرته في الاصل على العثمانين الذين قطعوا شجر التوت وما يعنيه ذلك القطع من الغاء لمواسم الحرير، وصادروا ( وسرقوا) البقرة والدجاجات. فاذا بذلك الاب يواجه القدر مجردا من اية امكانات للتغلب عليه. انهزم ناجيا بنفسه على حساب أسرته، رهن البيت بمئتي ليرة تكفلت بهجرته الى اميركا. ما رأته الأديبة ممّا صار اليه واقع ذلك المجتمع، اسرة يوحنا انموذجاً، عمق فريد منتمٍ الى رؤيتها، ثقافتها القومية الاجتماعية الخاصة بها.
فاللغة التي التقطت ذلك العمق من المجتمع اللبناني، ممثلا بمجتمع الخنشارة، ما كان لها ان تمسك بذلك العمق لو لم تكن استجابة الية مؤسسة على رئاسة ثقافة الكاتبة داخل رؤيتها. وذلك العمق ما كان لنا أن نمسك به في هذه الرواية لولا رئاسة ثقافة الكاتبة داخل رؤيتها ولولا قدرة رؤيتها على تطويع اللغة للكشفعن العمق الذي تطاله الرؤية. وهذا كله سر الأدبية الجمالية التي اثارت انفعالنا ، لذتنا في تذوق النص التي تحدث عنها بارت.
2- الوطن (البيت): يقول يوحنّا :”رأيت أمّي تكتم خوفها وتبتسم ابتسامة ضعيفة. لم يبقَ لي إلا البيت ،سأذهب منذ الغد إلى خليل بك لأرهنه”(ص 20_21 ) ويستأنف كلامه قائلًا :”أذكر جيّدًا كم حاول عمّي أنيس ثنيها عن عزمها،مصوّرًا نتائج أصابتني بالهلع مثل التّشرّد على الطرقات من دون مأوى.هل كان يعلم ؟ ولكنّ أمّي أشارت إلى وردة الّتي كانت قد أصبحت هزيلة جدًّا وقالت : … نرهن البيت وغدًا يحلّها حلّال .هؤلاء الأولاد بحاجة للطّعام اليوم .ولكنّها في اليوم التّالي … ردًا على أسئلة العم أنيس القلقة . ابو يوحنّا رهن المنزل لديه قبل أن يرحل . أخذ منه مئتي ليرة “(ص 31) . ويعلّق يوحنّا على ذلك قائلًا :” يومها ، لم يعد المنزل يبدو لي صلبا . صار كبيت من الورق”(ص21).لقد وضع غبار العام 1918 الوطن في مواجهة لقمة الفرد . غاب الوطن الذي لم يعد وطنًا تمامًا ، تقلّص إلى دائرة بيت عائلة فقيرة .رَهْنُ البيت معادل للتّشرّد في الطّرقات .والتّشرّد يعني غيابًا تامًّا للوطن ولوظيفة الوطن . وإذا كان بيت العائلة، (وطنهم) ، قد رهنه الأب لخليل بك لقاء مئتي ليرة تكفيه للهجرة إلى أميركا ، غاب الوطن بمفهومه المعروف بوصفه مأوى مكينا لجميع أبنائه ، ليصبح مصير هذه العائلة التّشرّد الذي لم ينج من الموت معه سوى يوحنّا . وإذا عاش الفرد ، في المجتمع اللبناني ، صراع البقاء بناءعلى غرائزيّة متوحّشة، بات الوطن أشبه ما يكون بالصّحراء أو الغاب محكومًا بشريعتهما الّتي تقول إنّ الحياة للأقوى فقط . ويبقى أنّ العمق الذي نفذت إليه رؤية الآديبة في مراقبتها الوطن عالمًا مرجعيًّا ، هو عمق ذو خصوصيّة لا تمسك بها أيّة رؤية أخرى، بما يعني أنّ لغة هذه الرواية قد أرتنا جديدًا يثير دهشتنا بفرادته.ذلك أنّ الإشارة اللّغويّة الزّمانيّة ” الأولاد بحاجة للطّعام اليوم ” نفي للضّمان الّذي كان يجب أن يؤمّنه الوطن ممثلًا بالبيت هنا ؛لأنّه لم تبق من فكرة الوطن والمواطنة في ذهن أم يوحنّا سوى (البيت) الذي وُضِع معادلًا لطعام العائلة لليوم الرّاهن ، وسط غياب لأيّ همّ يتعلّق بالغد . وأن يتقطر الوطن على شكل بيت ، في مهبّ الرّيح ، والزّمان على شكل لحظة راهنة ، يعني أنّنا أمام لغة تتّصف بفرادة غير عاديّة . التقطت من أعماق مفهوم الوطن ، ما لا يمكن أن نتنبّأ بحقيقته قبل أن رأته لنا هذه الأديبة . وهذا سر جماليّة لغتها .
3- الهويّة : إذا ما وجد العثمانيّون أنفسهم ،في مواجهة الحرب العالميّة الأولى، بحاجة إلى استنهاض المجتمع الّذي يحكمونه، وإذا كانت غالبيّة أبناء ذلك المجتمع تنتمي مذهبيًّا إلى مذهب محدّد بشكل أساسيّ ، أصدروا في شهر آب من العام 1918 القانون ” الذي نصّ على ذكر الدين والمذهب في السجل وورق الهوية”(ص 30). وتمثل هذه الإشارة قراءة عمق من أعماق الصراع الخفيّ الدائر حول الهوية والانتماء . يريد العثماني للهوية أن تكون في خدمة حضوره في المنطقة ، وخدمة مصالحه . وتكمن في ذلك إيماءة إلى رفض الأديبة لأن تكون الهويّة مؤسّسة على المذهبيّة . ولقد استطاع هذا الرّفض الثّقافي لأن يصل إلى العمق المجافي لما هو إنساني في الثّقافة التّركيّة العثمانيّة. فالصّراع قائم على مواجهة بين هويّة مذهبيّة وهويّة إنسانيّة سوف يحدّد مصير المجتمع . ويختلف الأمر عند حضور الغرب ممثّلًا بفرنسا وبريطانيا في مجتمعنا بعد الحرب العالميّة الأولى. وتلخّص الاجتماعات التي كانت تُعقد في مقرّ المجلة التي تديرها ماري الناشطة ثقافيًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا في دمشق ” الأفكار المتضاربة والمشاعر المتناقضة بين ما يّسمى بالبراغماتيّة السّياسيّة وهي الإقرار بالضّعف وبعدم القدرة على مواجهة فرنسا وبريطانيا . والقوميّة التي هي ثقة القوم بأنفسهم وبحقّهم في بناء دولة مستقلّة ضمن حدود وطنهم الطّبيعيّة”(ص137). والممعن في هذا الكلام لا يجد انقسامًا بالهويّة بين فريقين .الانقسام في الرواية في الموقف من العدو . وهو انقسام قائم بين أبناء الهويّة الواحدة ، بين أصحاب النّفس الواهن الّذين وصفتهم الرواية بالبراغماتيين، وبين أصحاب النّفس المقاوم أولي الثّقة بأنفسهم ومجتمعهم في بناء دولة ضمن حدود وطنهم الطّبيعيّة . ولئن أومأت صفة تلك الحدود التي ساقتها الرواية (الطّبيعيّة) إلى ما هو أدقّ من الثّقافة ، إلى عقيدة محدّدة ، فإنّ ما قرأته لغة الأديبة من عمق خاص بالهويّة، في تلك المرحلة ، إنّما يمثل فرادة ما رأته من ذلك العمق . هو عدم التماسك وحضور الوهن إلى داخل تلك الهويّة نفسها ، وهذا ما يميّز أدبيّة هذه الرواية ويجعلنا نتلذّذ لغتها ،فتسري ، وفق ما رآه بارت، قشعريرة في أجسادنا، هي الجماليّة الأدبيّة عينها .
يعني كلّ ذلك أنّ غبار العام 1918 قد أصاب تلك الهويّة . وإذا كان فاعل النوع الأول من الغبار (المجاعة) هو التركي الذي توخّى الإطاحة بالهويّة الحقيقيّة عبر التتريك في آخر المطاف ، فإنّ فاعل النوع الثّاني هو الغربي الذي أراد لغباره أن يمزّق جسد الوطن الطبيعي عبر ضرب الصّفح على حدوده الطبيعيّة ، واصطناع حدود داخليّة تمزيقية بديلة عنها . وإذا أراد الأوّل تغييب الهويّة الحقيقيّة ، فإنّ الفاعل الثاني لم يستطع مثل ذلك التغييب بسبب انكشاف مآربه ووضوحها ، خصوصًا أنّ فريقًا من أبناء ذلك الوطن ما زال واثقًا بانتمائه فاعلًا في سبيل إحيائه وتحويله إلى طاقة تواجه الهجوم على الهويّة الوطنيّة . وما كان لنا بوصفنا متلقين أن نمسك بهذا العمق الذي وصلت إليه رؤية الأديبة لولا فرادة لغتها القادرة على إثارة لذّتنا على كلّ حال .
4_ الزمن = التاريخ : ولا يقتصر العالم المرجعيّ الذي عاينته فاتن في روايتها “غبار 1918″ على المجتمع والوطن والهويّة فقط خصوصًا أنّ هذه المكونات قد نالها النصيب الأوفر ، في أثناء تشكّلها ،من مرور الزمن وتحوّله إلى تاريخ. فالزمن عند شخصية الرواية الأساسيّة يوحنا ” لا يكتفي بالعبور بل يحمل معه أمكنة وأشخاصًا ويجرفها كالسيل تاركًا على الضفاف البقايا المبعثرة”( ص15) . غيّبت الرؤية إلى الزّمن هنا البعد النمائي الذي يصاحب مرور الزّمن عادة ، والنماء الذي يطال جميع الكائنات الحيّة ، وحتّى الأشياء والأمكنة ، وغياب مثل هذا البعد الإيحائيّ قد أفصحت عنه الرؤية إلى كلّ من المجتمع والوطن والهويّة . وتشبيه الزّمن بالسيل يرينا منه الآلية المتوحّشة التي لا تضرب صفحًا على البعد النمائي الممكن للزمان فحسب ، ولكنّها قدّمت الأمكنة والأشخاص وقد حملها السيل معه وحوّلها إلى بقايا ، إلى غثاء أيضا. يعني أنّ الزمن قد ألغى معالمها الأساسيّة التي تُعرف بها. فالبقايا غالبًا ما تكون عديمة النّفع غير مفيدة ، كيف لا ، وقد فقدت تماسكها الذي كان لها ، وهويّتها التي كانت تُعرف بها ، وصارت نتفًا موزعة هنا وهناك . إنّ لغة الرواية المتمحورة حول مفردتي : (السيل) و(البقايا) قد كشفت لنا عمقًا من أعماق الزمن فريدًا لا يمكن للغة خارج حضور الكلمتين الآنفتين أن تكشف عنه . ويعني ذلك أنه لا يمكن لرؤية أي إنسان آخر غير رؤية فاتن أن تقدّمه إلينا قشيبًا يتسم بفرادة تثير انفعالنا ، تثيره بما شُحنت به لغتها من جوّ قائم بين ثقافة الكاتبة والعالم المرجعي( الزمن هنا ) . وما كان لزمن فاتن أن ييدو كما أظهرته لنا لغتها لولا فاعلان أساسيّان تحكّمًا بمفاصله . نعني بهما : الحضور التركي الثقيل في بلادنا في مرحلة أولى ، والحضور الغربيّ المقلق في مرحلة ثانية .
1.4_ الحضور التركي : تبدأ صورة التركي بالظهور من خلال الجوع الذي نشره في المجتمع الخاضع لسلطانه: “كان الجوع الّذي بدأ ينتشر قد أخذ يغلق الأبواب كلّها في وجه الأهل والأصدقاء، وكانت غريزة البقاء تتجلّى في أنانيّة شرسة لا تأبه بتاريخ العلاقات بين أبناء العائلة الواحدة ، والحيّ الواحد” (ص 17) . لعلّ أوّل ما تثيره كناية إغلاق الأبواب في وجه الاهل والأصدقاء، هو غياب ما كان يعتزّ به الجبليّ من كرم الضّيافة. وذلك بفعل غريزة البقاء الّتي اجتاحت القيم الاجتماعيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة، ودمّرتها . فالأنانيّة الشّرسة، كما وصفتها الرواية قد اكتسبت شراستها بفعل الجوع الّذي حضر بفعل الحضور التّركي . هذا الحضور الّذي قسّم العالم في ذهن يوحنا: ” إلى أتراك أشرار وأناس مظلومين” (ص 85). وانقسام العالم هذه القسمة لم يمركز الشّرّ كلّه في التّركي فحسب، ولكنّه قدّمه فاعلا محوريّا أساسيّا في تحويل الإنسان من إنسان أخلاقيّ اجتماعيّ إلى كائن متوحّش عبر أنانيّة شرسة تتملّكها غريزة حبّ البقاء أيضا. وتوحّش الإنسان المظلوم لا يقدّم الظالم وحشا كاسرا محكوما بغريزيّة غير مسبوقة فقط، ولكنّه يتيح لنا أن ندرك فاعليّته المرّة في حركة التّاريخ كما كشفته لنا لغة هذه الرواية .
2.4- الحضور الغربي: ولتتبدّى فاعليّة التّركي في حركة الزّمان بجلاء أوضح ، لا بدّ من أن نحاول استقراء لغة الرواية في تقديم الفاعل التّالي للتّركي في توجيه حركة التّاريخ، نعني به الغربيّ.
ما تراءى لنا ثورة عربيّة ضدّ الأتراك، بقيادة الشّريف حسين، يوم 29 أيلول 1918، لم يكن في الواقع ثورة. كيف لا وقد عجز يوحنّأ وغيره من الحالمين بالتّخلّص من “أربعة قرون من الاحتلال العثماني ” (ص121). عن رؤية لورانس الدّاخل برفقة الشّريف حسين، لورانس الّذي سيقتلع بعد أيّأم قليلة الإكليل الذّهبي..عن قبر صلاح الدّين الأيّوبي.ولقدعجزهؤلاء الحالمون،كذلك،
” عن رؤية البريطانيّين وهم يدخلون دمشق في اليوم نفسه، من الجهة الغربيّة، بقيادة الجنرال اللّمبي الّذي نزل في فندق فيكتوريا” (ص 121). وإذا تساءل يوحنّا قائلًا: ” كيف استطاعوا أن يخدعونا؟…كيف فرحنا وهلّلنا، ولم نرَ أيّا من ألاعيبهم ” (ص 121). إنّ مفردة (عجز) الّـتي لجأت إليها لغة فاتن قد ميّزت بين احتلالين عرفهما مجتمعنا: الاوّل هو الاحتلال التّركي الّذي تصرّف مع مجتمعنا بتسلّطيّة غبيّة، والثّاني هو الاحتلال الغربي الفرنسي والبريطاني الّذي تعامل معنا بذكاء أعمى بصيرتنا عن رؤية الحقيقة، فجنّدنا لخدمة مآربه،ولو من خلال أحلامنا، فعجزنا عن إدراك خدعه وألاعيبه. ومهما يكن من أمر، فإنّ التّركي المهزوم بما تبقّى لديه من معالم القوّة، استطاع أن يساوم الغربي لتحصيل بعض المغانم الّتي سيدفعها الغربي من صندوق غيره. فالمعلومات أنّ “مفاوضات تجري بين أتاتورك والفرنسيّين وتهدف إلى تنازل الفرنسيّين عن الأقاليم السّوريّة الشّماليّة وتسليمها إلى السّلطة التّركيّة الوليدة” (ص141). تذكّرنا هذه المفاوضات بعنوان الرّواية “غبار 1918 “، فترينا العمق الّذي كشفته رؤية الأديبة من الفاعلين في تاريخ مجتمعنا، نعني بها الأتراك والغربيّين، ومن المفعول بهم، نعني بهم مجتمعاتنا الّتي أبرزتها لغة فاتن لا حول لها ولا طول. هي غبار تستقرّ حيث تدفعها الرّيح السّوداء . لواء اسكندرون وكيليكيا وأنطاكية، وبنفخة واحدة ينتقل من ضفّة دولة سوريا ليستقرّ عند ضفّة دولة أخرى هي تركيا متجاوزا الحدود الطّبيعيّة الّتي تحدّثت عنها الرواية. إنّها اللغة الخاصّة الّتي ترسم الجدليّة القائمة بين رؤية الكاتبة والعالم المرجعي، وتحرّك في نفوسنا الانفعال حيال الكشف الجديد. وتصبح غباريّة مجتمعنا أكثر وضوحا في أثناء تنفيذ بريطانيا وعد بلفور بعد أن وضعت يدها على فلسطين (ص 138). تعدّت مسألة زرع الكيان الإسرائيلي في فلسطين انتقال انتماء مجتمع (الاسكندرون) من دولة إلى دولة، ومن أمّة إلى أخرى لتصل إلى اقتلاع مجتمع، المجتمع الفلسطيني من أرضه وزرع مجتمع آخر (الصّهيوني) مكانه. وممّا يجدر ذكره هنا، أنّه ما كان لواقعنا أن يُكشَف، كما كُشِف، من دون الغباريّة الّتي اتّكأت عليها لغة أديبتنا.
كلمة أخيرة:
ويبقى أنّه ما كان لنا أن نعيش الجدل الّذي قام بين رؤية فاتن (ثقافتها)، والعالم المرجعي (مجتمعنا) بمكوّناته الأساسيّة، والّذين اعتدوا عليه محاولين جرّه إلى دوائر مصالحهم، لولا لغة الرّواية الّتي مثّلت فرادة لافتة ما كان لها أن تتّصف بها لولا ذلك الجدل. فالأسلوب، من خلال الإسناد، والوصف، والإضافة هو المدخل. لماذا أسندت الأديبة ما أسندته إلى هذا الفعل، أوذاك: حقيقة أو مجازا؟ وكيف نجح ذلك في العمليّة الكشفيّة التي تعدّت إلى العالم المرجعي؟ ولماذا استخدمت هذه الصّفة لتقديم ذلك الموصوف؟ وما مدى مساهمتها في العمليّة الكشفيّة؟ وكذلك بالنّسبة غلى الإضافة؟. تكمن الحساسيّة الجماليّة الأدبيّة في نجاح هذه الفواعل الثّلاثة في وظيفتها الكشفيّة، فهي الّتي مكّنتنا من الإمساك بما أمسكت به رؤية المبدع (ثقافته)، ولا يمكن للجماليّة أن تقع خارج ذلك.
*مواليد حوش الرافقة – قضاء بعلبك 1947. حاصل على إجازة في اللغة العربية وأدابها – جامعة دمشق 1973، ماجستير في اللغة العربية وأدابها – جامعة القديس يوسف 1981. دكتوراه اختصاص في اللغة العربية وأدابها – جامعة القديس يوسف – بيروت 1984. دكتوراه دولة (فئة أولى) في اللغة العربية وأدابها – جامعة القديس يوسف – بيروت 1988. أُنتخب رئيساً لقسم اللغة العربية في كلية الآداب – الفرع الرابع لمدة عشر سنوات. باحث وناقد أدبي كتب عشرات الكتب والمؤلفات النقدية والدراسات الأدبية وأشراف على عدد كبير من الأطاريح والرسائل الجامعية.