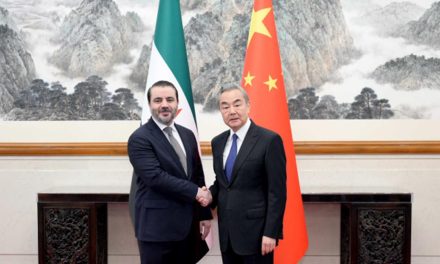بنك أهداف “الحزب” وإيران: لماذا الآن؟!


كتب جان عزيز في أساس ميديا
هل جمعت إسرائيل كلّ تلك المعطيات المخابراتية التي سمحت لها بضرب “الحزب”، قيادة واتصالاتٍ وكوادرَ ومخازن… وصولاً إلى أمينٍ عامّ تاريخي مثل السيّد حسن نصرالله، في الفترة الأخيرة فقط؟ وكيف حقّقت ذلك؟ أم كانت منذ فترة طويلة تملك تلك المعطيات كاملة، ولم تكن “تستثمرها”، بالمعنى الاستخباري للكلمة، ولماذا؟
وهل الجواب هو حصراً في طهران؟
يجزم الخبراء الغربيون الذين يتناولون موضوع الحزب بأنّ إسرائيل كانت تملك بنك الأهداف المرتبط به، كاملاً منذ أعوام. بدأت بعد تموز 2006 مباشرة، أو تحديداً منذ إنجاز تقرير “لجنة فينوغراد” عن تلك الحرب بعد عامين. 600 صفحة بخلاصات كاملة دقيقة.
كما بات معروفاً كيف طوّرت بنك أهدافها هذا، استناداً إلى عوامل عدّة مساعدة: التكنولوجيا المتقدّمة لديها. بين هلالين، ما من شركة تكنولوجيا أو معلوماتية أو ذكاء اصطناعي أو اتصالات إلكترونية أو كومبيوتر أو أمن سيبراني في العالم، بلا أيّ استثناء… إلّا وتقيم مركز أبحاثها وتطويرها في إسرائيل. في مقابل النجاح اللبناني بنسبة 90% في مهزلة بكالوريا الركام في دولة لبنان، وبتقدير ممتاز لكلّ الراسبين!!
المهمّ أنّ بنك أهداف الحزب كان يُستكملُ تباعاً. جاءت حرب سوريا، فانكشف أكثر أمام الروس والميليشيات من كلّ نوع.
تضخّم جسمُه وانتفخت ثقته بنفسه، فصار عرضةً أكثر للخرق، وعرضة أقلّ للاستدراك والاستماع.
في المحصّلة، يعتقد الخبراء الغربيون بأنّه منذ أعوام باتت إسرائيل تعرف كلّ شيء عن الحزب، عن كلّ عنصر ومسؤول وقيادي. ولبثت تراقب وتنتظر.
ذلك أنّها قرّرت بشكل واع مدروس وعميق أن تتعايش مع الحزب على حدودها الشمالية، محقّقة بهذا “التعايش” أعلى وتيرة من الهدوء النسبي والاستقرار الحدودي منذ 1966، يوم سقطت حصرية سلاح الجيش اللبناني في الجنوب.

صعود إسرائيل… وانهيار لبنان
حتى إنّ الكيان انطلق متّكلاً على هذا الاستقرار لتطبيق خطط استراتيجية شاملة، أولاها بناء اقتصاد هائل. نما من أقلّ من نحو 180 مليار دولار سنة 2006، إلى ما يلامس 600 مليار دولار سنة 2023. فيما كان لبنان ينهار في الفترة نفسها مثلاً، من أكثر من 50 ملياراً إلى أقلّ من 20. فصارت سنة الناتج الإسرائيلي المهزوم، تساوي أكثر من 30 سنة من الناتج اللبناني المنتصر!
ثمّ ذهبت إسرائيل إلى الخليج وإلى آسيا وإفريقيا. فيما قطعنا نحن علاقاتنا مع معظم كوكب الأرض، باستثناء الدعم الإيراني غير المشروط لجزء من لبنان.
باختصار ارتاحت إسرائيل إلى معادلة ما بعد تموز 2006. فيما غرقنا نحن في حصاد انتصاراتنا: من 7 أيار إلى حروب سوريا، ومن 17 تشرين إلى 4 آب. وفي تلك المآسي كلّها، كنّا نخدّر عقولنا بأنّنا منتصرون. وكانت إسرائيل تضحك وتضحك وتضحك كثيراً.
الأهمّ ههنا أنّ ارتياح اسرائيل حيال هذا الوضع تزامن وترافق مع ارتياح أميركي مماثل.
أوباما: “لا أريد سماع اسم سوريا”
تقرير فينوغراد، مثلاً، صودف إعلانه بعد 10 أيام على دخول أوباما البيت الأبيض رئيساً فارسيّ الهوى، سنّيّ الفوبيا، حتى اعتلاله سيكولوجياً من اسم والده، حسين، الذي هجره ووالدته، وهو في الثانية من عمره.
جاء أوباما ليكمل تلك “الوضعية التعايشية” (Modus Vivendi) بين تل أبيب وطهران، بتفاهم مماثل بين الأخيرة وواشنطن.
أنجز اتفاقه النووي الشهير معها في تموز 2015. فجمع أركان إدارته في البيت الأبيض صباح اليوم التالي، وأبلغهم عبارة واحدة: “بعد اليوم لا أريد سماع اسم سوريا هنا”!
وهكذا كان. فبعد 75 يوماً فقط دخل فلاديمير بوتين إلى دمشق بنصيحة من قاسم سليماني. فيما قبل أشهر قليلة، وخلال التفاوض النووي، كان إيرانيّو صنعاء يتغوّلون على كلّ محيطهم.
السّنوار… وانهيار النّفق الإقليميّ
فجأة انهار ذلك كلّه، ذات فجر من تشرين الأول 2023، حين قرّر رجل مقيم في نفق في غزة أن يحفر أكثر عمقاً في التاريخ والقبور وذاكرة المعتقلات وبؤس الفلسطينيين وبربرية الاحتلال، فبدأ يتداعى البنيان الإسرائيلي – الحزبللاهي – الأميركي – الإيراني فوق النفق.
تردّد الجميع بداية. نتنياهو أصيب بصدمة لأنّه أوّل من دعم “حماس” ووفّر تمويلها وغطّاه ونقله بحماية أجهزته، على وهم أن يضرب بها سلطة أوسلو وخيار دولة فلسطين، فقرّر التعمية على فشل رهاناته بالجنون.
السيّد نصرالله أبلغ الجميع يوم 7 أكتوبر أنّ هذه الحرب ليست حربه، قبل أن يبدّل رأيه ليلاً. قيل إنّ السبب أخلاقي مبدئي إيمانيّ، عنوانه، كما نُقل عنه، ألّا يكتب التاريخ أنّ أحفاد عليّ خذلوا السُّنّة في فلسطين بالذات.
حاولت إيران اللعب على هوامش المسرح، بين تشدّد وتراجع، بين تفاوض مع الأميركيين وتناغم مع العرب، وبين الحدّ الأدنى من مساندة الفلسطينيين.
في لحظة مفصليّة، بدا أنّ الملالي لم يلتزموا أو لم يسلّموا (Did not Deliver) أو أنّهم تأخّروا في حسم مواقفهم.
أين أخطأ الملالي؟
شيء مماثل للحظة وقوف بشار الأسد مع صدّام حسين سنة 2003، يوم صدر قرار واشنطن بسحب التلزيم الأميركي له من بيروت، ومن دمشق نفسها، لولا غياب البديل.
قد يمرّ وقت قبل أن يُكتب صراحة أين “أخطأ” الملالي. ولماذا تحوّلت وضعيّات التعايش معهم ومع وكلائهم، إلى عبارة “تأخّرتم” وسياسة “كفى يعني كفى”!
قد يكون الصاعق في مجرّد احتمال تكرار 7 أكتوبر مرّة ثانية، وعلى جبهة أخرى، أو على أكثر من جبهة.
وقد يكون في اللعب على خطوط أوكرانيا، أو في النووي، أو في نيّة إحباط الكوريدور الهندو – أوروبي، أو في عرقلة الاتفاق الاستراتيجي الأميركي السعودي، أو في غزة فعلاً، أو جنوب لبنان حقّاً… أو هو تراكم ذلك كلّه.
لكنّ الأكيد أنّ قراراً كبيراً قد صدر في مكان ما في واشنطن. قد لا يكون حتى اللحظة موضع إجماع، ولا اتّخذ مسار التنفيذ النهائي بعد. لكنّ الكلام بدأ في “مجامع التفكير” وفي الإعلام البحثي عن “تغيير شيء في طهران”. وعادت المعادلات، كما مع الأسد سنة 2004، بين “تغيير النظام” أو “تغيير سلوك النظام”.
نفض الغبار عن نجل الشّاه الإيرانيّ
الواضح أنّ الخطوات التمهيدية بدأت تظهر. ضرب الوكلاء جذرياً. محاصرة المركز فعليّاً. البحث عن بدائل ولو خياليّاً. حتى إنّ نجل الشاه أُعيد نفض الغبار عنه وصار ضيفاً إعلامياً تواصليّاً.
النمط الانقلابي نفسه، كما في أفلام هوليوود، وكما مع محمد مصدّق في طهران نفسها سنة 1953. فمع كلّ التطوّر، يبدو أنّ ثمّة “مدوّنات سلوك” لم تتغيّر في لانغلي، مقرّ المخابرات المركزية، منذ 80 سنة.
وحده فيليب غوردون، العقل الوحيد في السياسة الخارجية لكامالا هاريس، ذكّر الجميع بكتابه الصادر قبل 4 أعوام، بعنوان “الوعود المضلّلة بتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط”، وبالتالي بنكسات واشنطن في أوهامها الإسلامية.
هو مشهدٌ ثنائي لا يبشّر بالخير للمرحلة المقبلة. فإذا دخلت هاريس البيت الأبيض، فقد ينخدع الملالي بارتياحٍ سيزيد نتنياهو توحّشاً حتى انتخاباته في أيلول 2025 على الأقلّ.
وإذا عاد جاريد كوشنر على حصان حَميه الكاوبوي ترامب، فقد يذهب الجميع إلى حفلة جنون، الملالي ونتنياهو والبيت الأبيض معاً.
وسط ذلك كلّه، تبدو نافذة الوقت ضيّقة أمام لبنان. لكنّها متاحة لإنقاذ نفسه. شرطها الوحيد حساباتٌ على قياس وطن، لا أكبر منه، على قياس أوهام إمبراطوريات وأمم وأمميّات، ولا أصغر منه، على قياس صغائر وصغار.